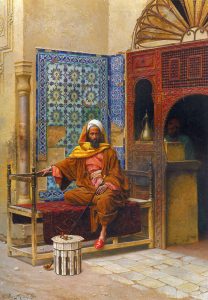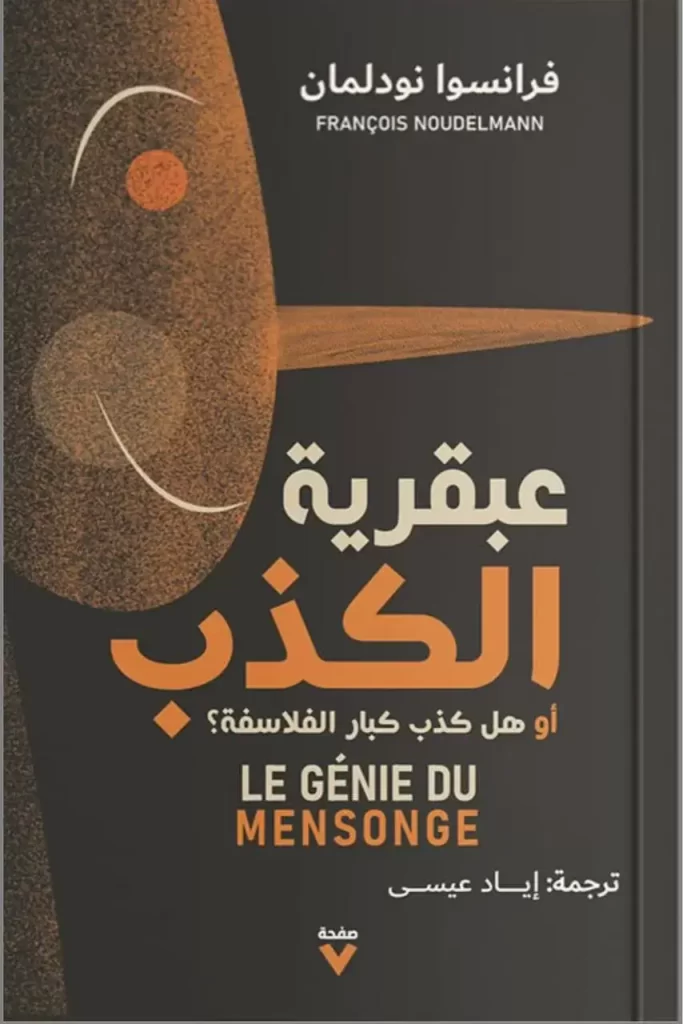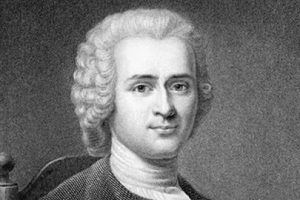فلسفة الجنون
من الكتب التي ترجمتُها مؤخراً، كتابٌ بعنوان “”فلسفة الجنون: تجربة التفكير الذهاني”. يقع في أكثر من ثمانمئة صفحة، وصدرت ترجمته عام 2022 عن دار ملهمون في الإمارات. مؤلِّفه هو ووتر كوستر، كاتب ومؤلف هولندي، خاض نوبات ذهانية عديدة كان أشدها عندما شُخص بالذهان عام 1987 وعام 2007، وهو في الأصل عالم لغويات وفيلسوف.
في كتابه فلسفة الجنون، يوضح الكاتب طبيعة التجربة الذهانية التي يخوضها المرء، ويقف على العناصر الكثيرة المشتركة بينها وبين التفلسف والتصوف، لذلك فإنه يقتبس من الذهانيين ومن المتصوفين والفلاسفة، ويتحدث عن تجاربهم المتشابهة والملامح التي يختبرونها فيها. غير أنه يريد الإثبات أن التجربة الذهانية تعني القدرة على الوصول إلى ما يسعى الفيلسوف والمتصوف للوصول إليه، أي سر الوجود، المبدأ الأصل، جوهر الحياة، أو أياً كانت تسميته، الفارق الوحيد هو أن الذهاني يعيش ما يسعى إليه المتصوف والفيلسوف، ويقصد بذلك التجربة الذهانية التي تُمكن المرء من إدراك ذلك المبدأ الأصل، وليست التي تهبط به في أمراض جنون العظمة، والهلوسات، والتيه الوجودي والارتياب. وبعبارة أخرى، فإن الكاتب يريد إرشاد هذه الفئات الثلاث في المسارات التي يتبعونها من أجل الوقوف على المبدأ الأول والأصل للوجود.
جديرٌ بالقول أن قراءتي للكتاب ومراجعتي له وحديثي عنه مرهون بنظرتي إليه، فكل قراءة للنص مختلفة من حيث الفقرات التي يتم التركيز عليها والطريقة التي يُفهم عبرها، لذلك أقدم هنا قراءتي حسب منظوري الخاص للكتاب، والذي جذبني في المقام الأول وأمتعني في ترجمته وقراءته.
يُقارب الكاتب بين الفلسفة والجنون بصورة تدمج بينهما وتبحث في العديد من أوجه التشابه، وذلك عبر أربعة أجزاء طويلة جعلها تُمثل العناصر الأربعة التي اعتُقد قديماً أن العالم مُتشكل بوساطتها (التراب والمياه والهواء والنيران). تتخلل هذه الفصول فقرات طويلة ومتوزعة على طول الكتاب، معنونة بالملاحق والفواصل، تحدث فيها الكاتب عن تجربته الذهانية، ما اختبر فيها وما شعره وأحسَّ به، وكيف تمَّ التعامل معه في المصحات، وعن رؤيته المختلفة ومنظوره لفهم العالم ضمن سيناريو مُحكم ودقيق، ويمكن للقارئ الذي يجد صعوبة في فهم موضوع الكتاب قراءة هذه الملاحق والفواصل، وقراءة العديد من تجارب الذهانيين والفلاسفة والمتصوفة والمتوزعة في صفحات الكتاب، لاستكناه الطبيعة اللافتة للتجارب التي حاول الكتاب الربط بينها والإشارة إلى مواضع التشابه العديدة.
في الجزء الأول، والمعنون “التمعن“، يتحدث الكاتب عن الكيفية التي يختبر بها البشر العالم من حولهم عبر حواسهم وإدراكهم الحسي، وعن ابتعادهم عنه عن الفلسفة أو العلم أو الفن أو الجنون، حيث تعني واقعية الشيء وجوده المُستقل عنا، وكلما انخفضت واقعية التجربة التي عشناها فإننا نختبر زيادة في تصوراتنا الذاتية، غير أن المجنون لا يرى العالم باعتبار واقعيته بشكل طبيعي، بل يراه تارة بواقعية مُفرطة وتارة أخرى بواقعية معدومة، وهو يتنقل بين هذين المنظورين بصورة مُستمرة، فالواقعية المُفرطة أن يرى الذهاني عالمه مجموعة من المسلمات والبديهيات والأحداث الحتمية التي ترتبط ببعضها البعض ضمن علاقة سببية تشير إلى وجود خطة عامة لهذا العالم، أو مؤامرة متقنة تجمع العناصر سوية، ويكون البشر عندئذٍ مؤدين لأدوارهم الحتمية وكأنهم دمى في عالم كُتب السيناريو له مسبقاً، بينما تكون الواقعية المعدومة منطوية على شكوكٍ عديدة متعلقة برؤية المجنون إلى محيطه وعالمه، حيث لا يكون على يقينٍ من أي شيء وتراوده الأسئلة حول حقيقة ما يعيشه وواقعية تجاربه والأحداث من حوله، ولا يكون أكيداً حول أية قوانين طبيعية أو حتمية تحكم عالمه، أما اللغة فلا تعني فيها الكلمات ما تعنيه إلا مصادفة، بل إن العالم واللغة يبحثان عن بعضهما البعض من دون أن يلتقيا.
كما تختلط رؤية الذهاني إلى عالمه فتارة يفيض خارجه على داخله وتارة يفيض داخله إلى خارجه، فنجده معتقداً بأن العالم نتاج تصوره عنه، وأن كل ما يحيط به نتاج فكره وتصوراته وأفكاره، أو نجد كل ما يحيطه يتمحور حوله بطريقة أو أخرى، حيث يكون العالم الخارجي متوجهاً إليه ومختلطاً بذهنه وتصوراته، كأن تكون ابتسامة المذيعة في إحدى نشرات الأخبار رسالة مشفرة تحاول فيها أن تنبِّهه إلى أمر ما، ويمكن أن يعيش في عالمٍ يعتقد فيه أن كل أفكاره ألهِمت إليه من مصدر خارجي ما ينتظر أن يكشف عنه.
ويضطرب مفهوم الذهاني للزمان من حوله، يبدأ الكاتب حديثه عن ذلك بمقولة لأوغسطين: “ما الزمان إذن؟ إنني أعرفه طالما أن أحداً لم يسألني، ولكن عندما أهمُّ بالشرح عنه لمن يسأل، أجد نفسي عاجزاً عن ذلك”. ورغم أن هذه مشكلة نظرية للفيلسوف، فإنها تُمثل مشكلة حقيقية في حياة المجنون، وتتسبب له بإرباك شديد. يملك البشر العاديون زماناً داخلياً أو إيقاعاً في أذهانهم لمضي الأيام والأشهر والسنوات، ويختبرون الزمان الخارجي عنهم على أنه مجموعة من الأرقام والفترات المختلفة، ويعيشون بتصورٍ زماني يجمع بين إيقاعهم الداخلي ونظيره الخارجي، غير أن الذهاني يفتقر إلى هذا التزامن أو التوافق بين الإيقاعين، فهو لا يرى الزمان خطياً مثلاً وبمفاهيم الماضي والحاضر والمستقبل بل يختبره كحاضر أبدي لا ينتهي، يجمع عناصر الماضي وتصورات المستقبل والتجربة المعيشة سوية في إطار لا ينتهي ويظل مستمراً وأبدياً. لذلك تكون متعته بالوجود مكثفة للغاية، ولكن كذلك حزنه عندما يصيبه يكون مكثفاً وشديداً ويمكنه اختباره في أي وقت، ما يجعله في حالة مزاجية شديدة التقلب.
أما المكان فيختبره العاديون ضمن صورتين، الخلفية والمقدمة، فعندما ندخل مكاناً أو ننظر لما حولنا فإننا نكون منتبهين بالضرورة إلى شيء بعينه بينما تظل بقية عناصر المكان حاضرة أمامنا وضمن منظورنا، ولكننا لا ننظر إليها بصورة مباشرة إلا إن اختبرنا فيها تغيراً، فتظل في الخلفية، ولكن الذهاني لا خلفية لديه بل يتمثل المكان بعناصره جميعاً في نظره، فينشغل بكل عناصره وتفاصيله وكل ما يتبدى له، ولا يتمكن من إلقاء أي شيء إلى خلفية ما تفترض بديهية وجود هذا الشيء، كما أنه يرى العالم من حوله مجزأ بصورة كبيرة، حيث يملك كل عنصر وشيء تميزه في ذاته من دون الحاجة إلى سياقه، فلا ترتبط الموجودات في عينه، بل يمكن أن ينظر إلى العصفور وزقزقته وكأنهما شيئين منفصلين. وقد يختبر الصور التي تعد ثنائية الأبعاد على أنها ثلاثية الأبعاد، ويختبر عالمنا ثلاثي الأبعاد على أنه ثنائي الأبعاد، بما ينطوي عليه ذلك من تعميق أو تسطيح للرؤية. وعندما يشاهد التلفاز فإنه لا يضع اعتباراً للمسافات المكانية ويشعر بأن عالم التلفاز حاضر هنا والآن في مكانه، ولإدراكه الشديد بتميز المكان فإن تنقله بين مكانين مختلفين، كأن يخرج من منزله إلى المقهى، يعني انتقاله بين عالمين لكل منهما قوانينه وعناصره المميزة وإمكاناته المختلفة، وفيما نرى نحن العالم بالضوء الطبيعي أي الشمس، فإن المتصوف يراه بالضوء الأبيض الذي يُعلي الوحدة بين العناصر على مميزاتها، والذهاني يراه بالضوء الأسود الذي تتميز فيه العناصر كلُّ بما يفرقها عن غيرها.

وفي الجزء الثاني، المعنون: “التصوف الذهاني“، يبحث الكاتب في العديد من التجارب الصوفية التي يشترك بها المتصوف مع المجنون أو الذهاني في الاعتماد على المجاز للشرح والتفسير والتحدث، ويتحدث عن اختلاف التجربة الصوفية عن الذهانية للمنظور الذي يمكن للمرء النظر عبره إليهما، فإن كان المرء متديناً سيعدها تجربة صوفية للعناصر الدينية فيها، وإن لم يكن كذلك فسيعدها تجربة ذهانية تشير إليه بوجود مختلف عنه. ويتحدث الكاتب عن أربعة طرق يمكن للمرء عبرها فهم هذه التجربة المشتركة بينهما:
- الانفصال عن الواقع: أي أن يفصل المرء نفسه عن كل ما يتعلق بالواقع المحيط به من قوانين وقواعد وبديهيات ومسلمات، وتخلصه من المخاوف الدنيوية والتوقعات والعلاقات التي تربطه بعالمه، فاستقباله الحقيقة الخفية يحتاج روحاً خفيفة غير مثقلة بما يتعلق بالعالم الدنيوي، مثل تجارب النسبية الشديدة.
- التحرر الخيالي: أي أن يتحرر الذهاني أو المتصوف من الهلوسات والتصورات والرؤى المتعلقة بعالمه، وهو الشعور بالواحد والاقتراب منه بعيداً عن أية هلوسات تخص العالم المادي، فالواحد غير موصوف ولا يتجسد ولا يرى، وعلى الذهاني أن يقاوم هذه الهلوسات وأن يدعها تمر عبره ولا تؤثر عليه.
- التحرر اللغوي: أي انفصال الذهاني عن اللغة كذلك والقوانين التي تحكمها والسياقية التي تسمها، وأن يفصل بينها وبين دلالتها، ولأن اللغة وجدت للتعبير عن الواقع فإن الذهاني والمتصوف يعجزان عن التعبير عن تجاربهما عبرها إلا باعتبار المجاز الذي يقترب من وصف ما مرا به ولكنه لا يصفه بالتمام، فتكون لغتهما عفوية وتلقائية وتعكس اللحظة الحاضرة وخالية من المعاني المحتمة عليها، حيث يشعر السامع أنه وسط عاصفة لغوية وانفجار في الكلمات والمعاني، فتتوسع دلالات الكلمات وتعود اللغة إلى نقطة الصفر حيث لا تحتكم لأية قواعد زمانية ولا مكانية ولا سياقية، بل تحتكم إلى المصدر الخالي من الزمان والمشير أبداً إلى الأبدية.
- التحرر الفكري: أي التحرر من التفكير المفاهيمي أو الاستطرادي أو المنطقي، وأن يندمج المرء مع الفكرة التي يفكر بها ويصبحان جوهراً واحداً بدلاً من الفصل بينهما، وأن يحقق المرء وجوداً له خارج منظومة المعارف والمفاهيم المتعارف عليها، وأن يرتفع عن عالمه الفكري ليصل إلى وحدة وجودية مع المحيط يجعل العالم من حوله يبدو متجدداً في كل مرة.
وفي الجزء الثالث بعنوان “ضباب خفيف“، يتحدث الكاتب عن أربع حالات مشتركة بين التصوف والجنون:
- التوهم بالواحد: الذي تحدث فيه عن الجنون الصوفي في توهم أفلوطين حول الواحد، والذي عدَّه جوهر كل شيء والأصل الذي انبثق منه وجود الأشياء جميعاً، ويتحدث عن الواحد في انفصاله عن الزمان والمكان وعن وجوده الخالد والتجريدي الذي لا يمكن وصفه.
- التوهم بالكينونة: حيث يرى المتصوف والمجنون العالم بموجوداته التي تحتفظ بما يميزها، فيبدو العالم مجموعة من الأشياء التي يُشع وجودها من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى علاقات تربطها بغيرها، ويعيش الذهاني عندئذٍ كينونة مكثفة تظهر فيها تجاربه وخبراته متعاظمة الأهمية، وتكون لغته جامعة لتفاصيل عديدة دون التركيز على موضوع واحد، وقد نختبر ذلك نحن على أنه انعدام التركيز على موضوع بعينه في حين أنه تركيز مكثف على كل شيء.
- التوهم باللانهاية: حيث يختبر المتصوف والمجنون اللانهاية كتجربة معيشة في الزمان والمكان والوجود والفكر، فتمتد في نظرهما العناصر جميعاً ويصبح الحاضر زماناً غير منتهٍ، فتندمج الأضداد ويختبرون اللانهاية في أدق المشاعر كالخوف والمتعة والحب.
- التوهم باللاوجود: أي أن يختبر الذهاني اللاوجود أصلاً بدلاً من الوجود، فلا يعود أكيداً من حقيقة وجوده أو وجود العالم من حوله، بل يكتنف الغموض كل ما يحيط به، ويشير الكاتب إلى فلسفة هيدجر في ضرورة الالتفات إلى اللاوجود بين الحين والآخر لزعزعة مسلماتنا حول الوجود وحتميته المفترضة.
وفي الجزء الرابع “حمى بلورية“، يتحدث الكاتب عن التجربة الجنونية في التناقض والقداسة والخطة التي يتبعها العالم، ففي نقاط الالتقاء بين الفلسفة والجنون، تحدث عن المفارقات التي يراها شيلينج بين التفكير والوجود، وتجربة إلياد الصوفية واقترابه من الفلسفة الهندية في اليوغا، ومذكرات الفيلسوف دانيال شريبر في المصحة العقلية، والتي بينت امتزاج فلسفته بالجنون وتجاربه الذهانية، ومحاولته حل التناقض العالمي بين الأضداد المختلفة، كالوجود واللاوجود.
تحدث الكاتب عن مفهوم المقدس لدى البشر، والذي يجعلهم يخلعون المعاني والقيم على الأشياء، ووافق تشارلز تايلور في أن الإنسان الحديث نزع هذه القداسة عن العالم وأضفاها على نفسه بحيث أصبح هو المعيار الأصل، واتسمت أفكاره بالأهمية ومكانته بالقدسية، غير أن الإنسان إذ نزع عن عالمه القداسة وأرساها على نفسه فقد ارتكب خطأ جعله يقع في حيرة تجاه هذا العالم، كيف يفهمه ويدركه ويتصوره ويقيِّمه، لذلك نجد تايلور ينادي بإعادة دور المقدس في العلاج النفسي لتمكين المريض من فهم العالم بالصورة التي هو عليه، وينتقد الكاتب الصورة الحديثة للجنون في أنه مرض يتطلب علاجاً بدلاً من حالة وجودية فريدة تحتاج الإرشاد للوصول إلى المبدأ الأصل في الوجود.
ويتحدث الكاتب عن مفهوم الخطة الجنونية التي يملكها الذهاني في نفسه، فيرى العالم أشبه بالفيلم السينمائي أو المؤامرة، كل شيء فيه حتمي ومخطط له وظهر لسببٍ ما، وهناك سردية تحكم كل تفصيلة يعيشها، يكون الزمان أفقياً والمكان ذا عوالم متعددة لا تعني فيه المسافات شيئاً، ويبدو العالم في نظره خطة محكمة لخداعه وإخفاء حقيقة مُهمة ما، فالأحداث تلعب دوراً في الحبكة الرئيسية والشخصيات مجرد دمى ناطقة ذات وجود حتمي في القصة، كأفلام “Truman Show” و”Shutter Island” و”Inland Impire” و”The Matrix”. لهذا يشعر الذهاني أن أفعاله وكلماته تؤثر على محيطه بصورة مباشرة ومتعاظمة.
وفي النهاية، يستعين الكاتب بمجاز العناصر الأربعة التي تُشكل الكون، حيث يرتفع المرء عن الأرض ويخوض في دوامة هوائية تسمو به عالياً ودوامة مائية تجعله يغوص في أعماق البحار نحو وجود جديد، لينتهي إلى النيران التي تسوي كل شيء وتجعله متشابهاً ومكرراً، وتبقي على التكرار الوحيد المتمثل على شكل دورانٍ يخلق التناقض المفضي إلى الوحدة التي تستهلكه ثم ينفيه في آن ويخلقه من جديد. هو موقد الحياة المتجدد باستمرار.
يُعد الكتاب مرناً وسهلاً رغم مادته الطويلة والجادة، ويظل طرحه في الإطار الفينومينولوجي للوصف والتحقق، ورغم ذلك فإنَّ قراءة واحدة قد لا تكفيه، فهناك العديد من المفاهيم والتصورات التي حاول الكاتب تقديمها بصورة جيدة، غير أن على ذهن القارئ أن يكون مستعداً لاستقبالها، ولعلَّ ذلك يتحقق في قراءة بعض الكتب الخاصة بالذهان والتجارب الصوفية، والوقوف على حياة وفلسفة أهم الفلاسفة الذين شخصوا بالذهان فيما بعد.

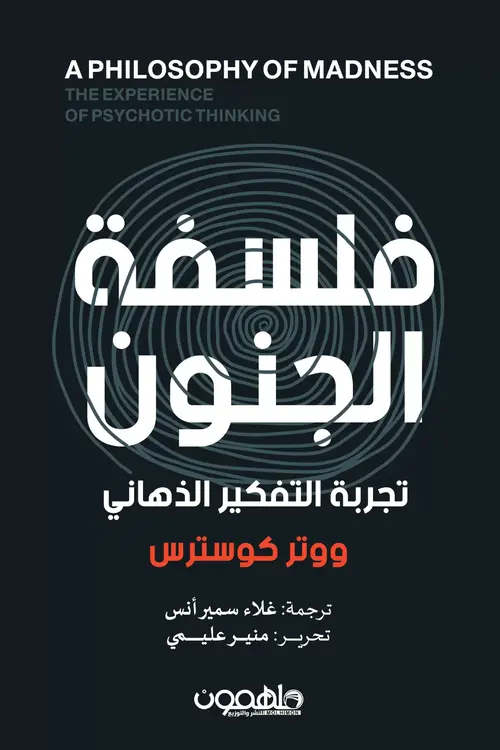
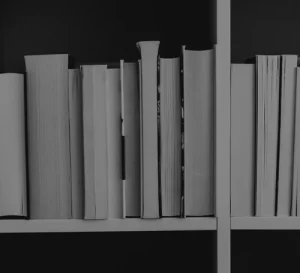

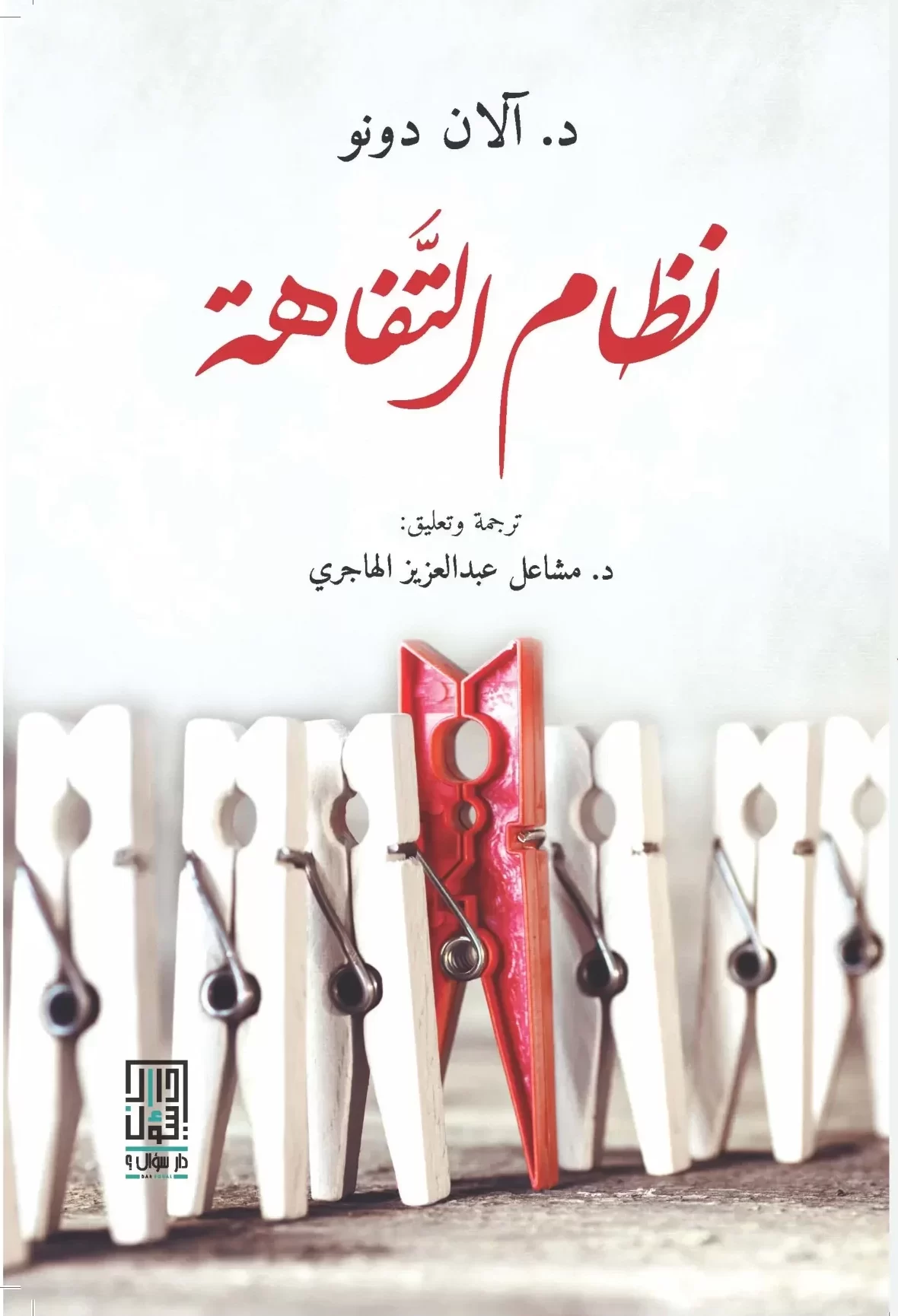
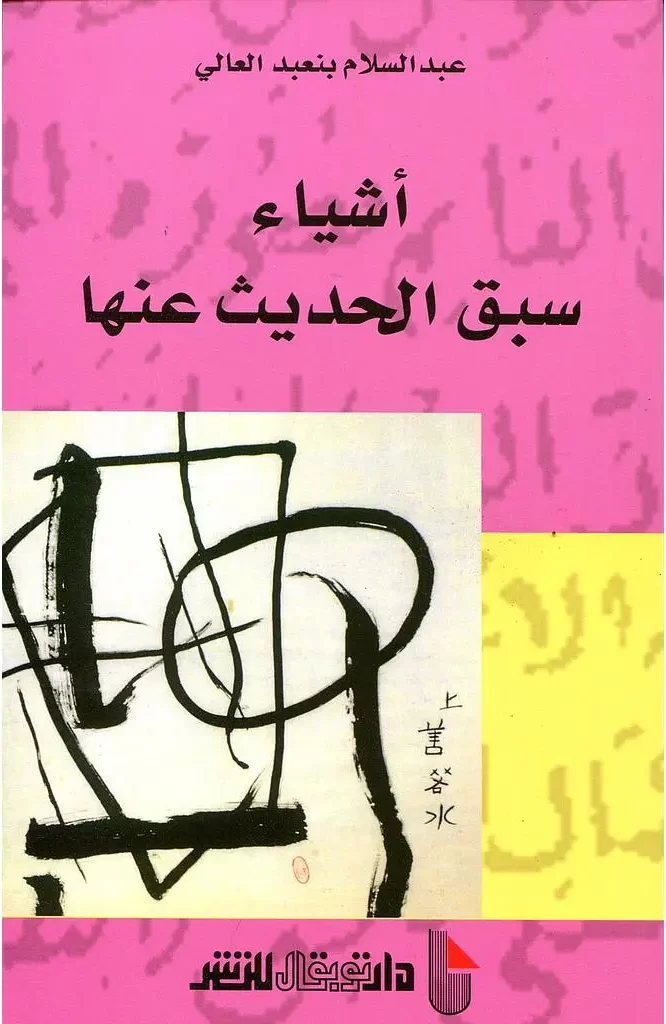
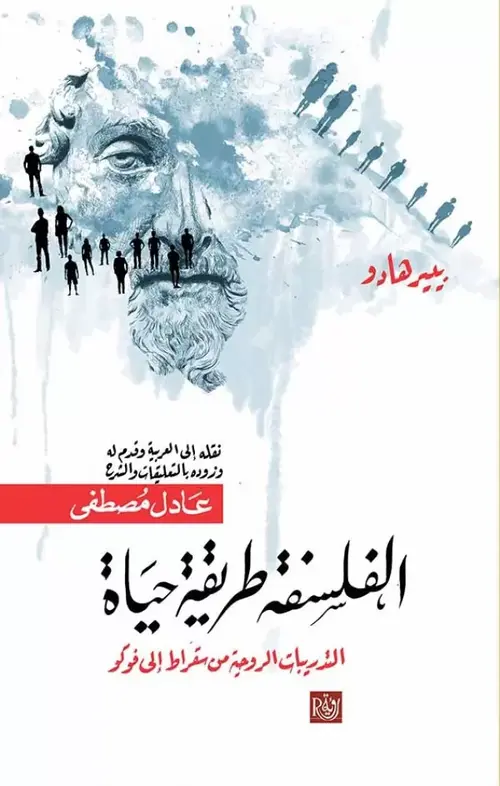

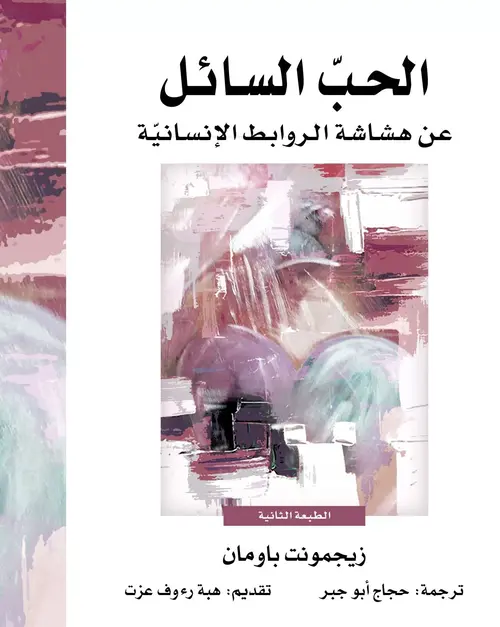

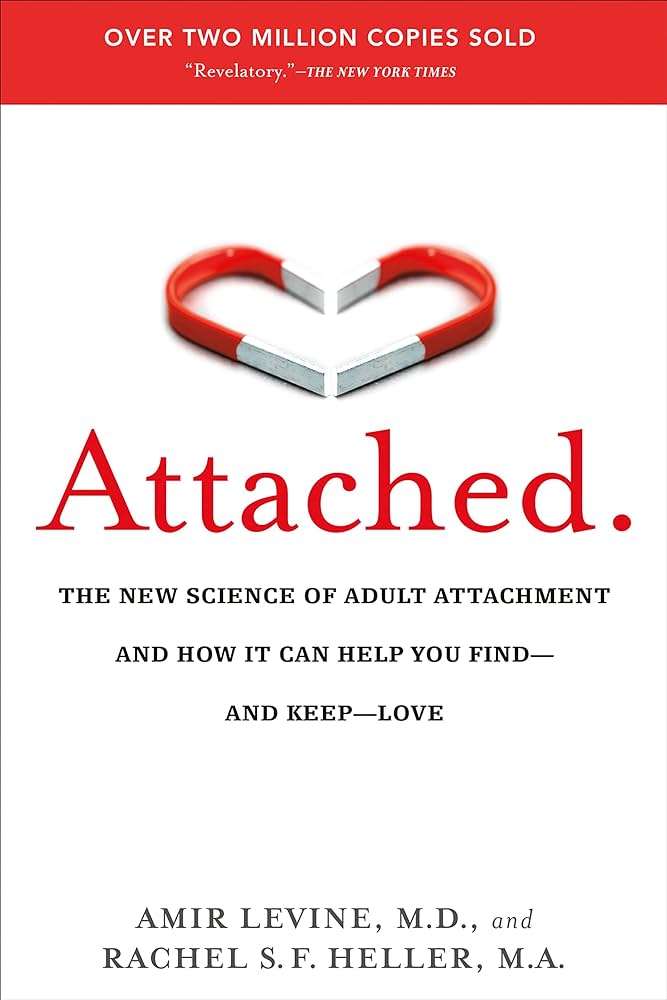
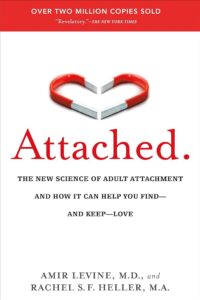
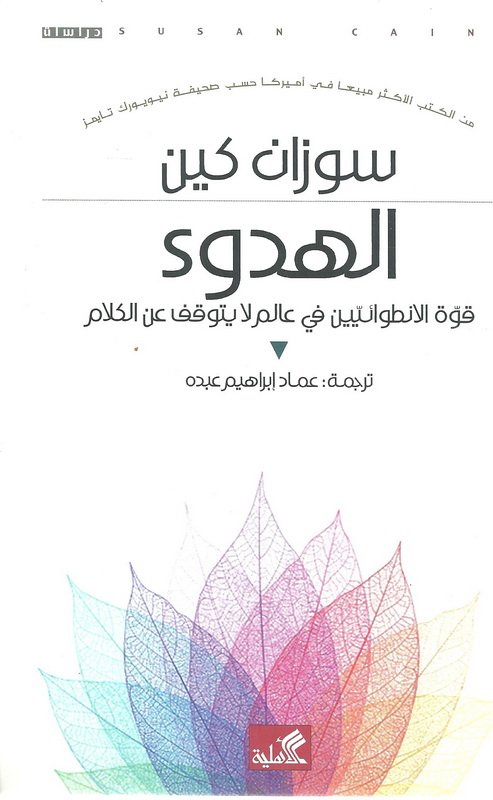

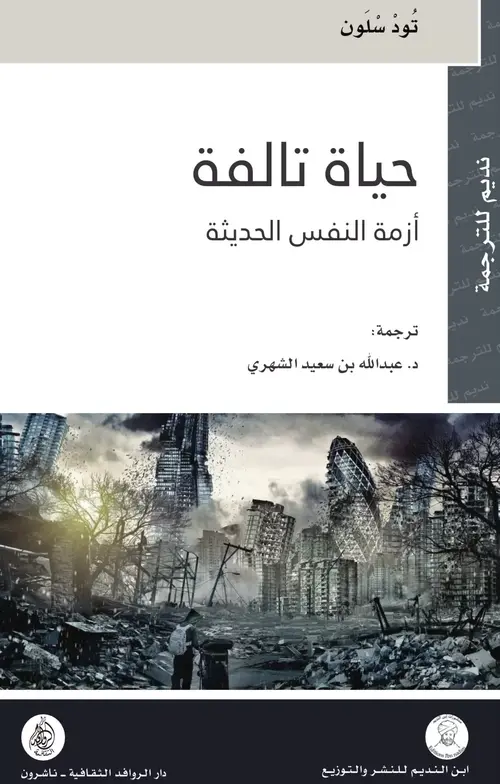
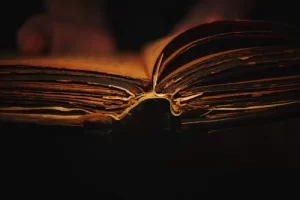
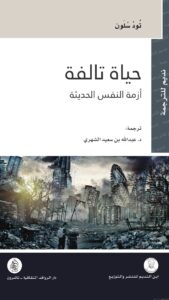

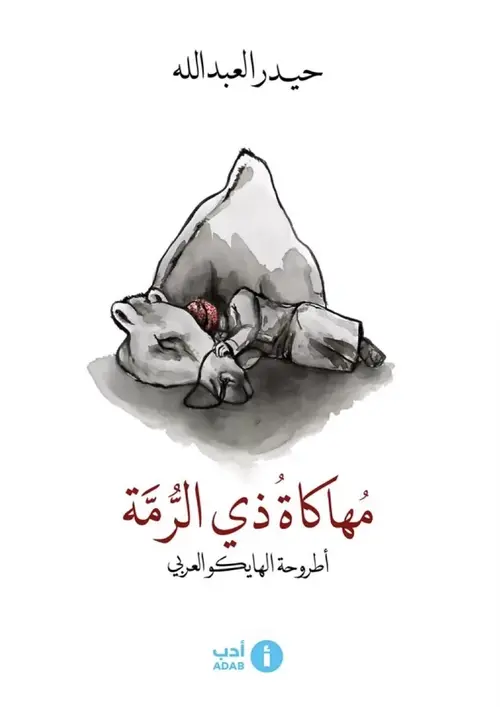

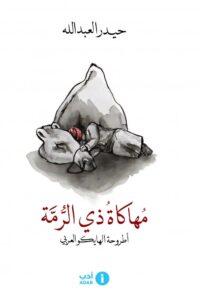

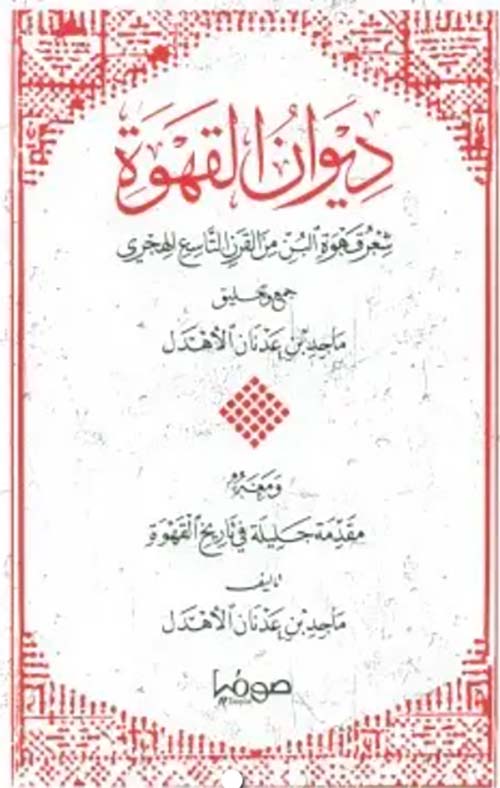




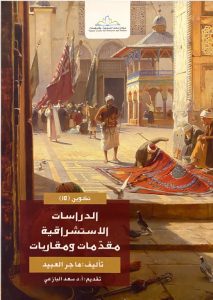 كتاب الدراسات الاستشراقية
كتاب الدراسات الاستشراقية