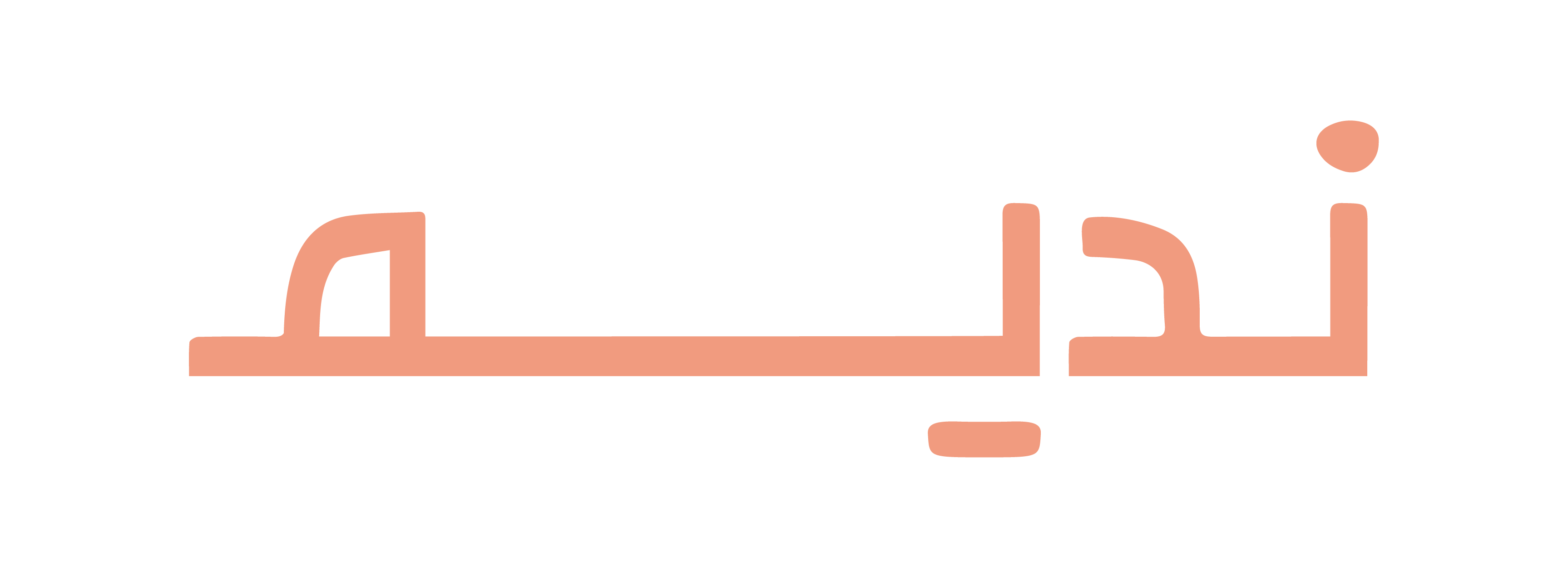مُترجمة كُتب
“نحن نولد مرة واحدة، ولن نولد بعد ذلك إلى الأبد، وبرغم ذلك فما تزال أنت، يا من لا حكم لك على الغد، تسوِّف بهجتك؟ غير أن الحياة تُهدر سدى في هذه التسويفات، ويموت الواحد منا ولم يعرف قط طعم السلام”
الفلسفة طريقة حياة – بيير هادو، ترجمة عادل مصطفى
كتابٌ بسيط ونافع للمُبتدئين في قراءة الفلسفة، يقف على بعض المواضيع والمُقدمات الفلسفية التي تناولت الجانب المعيشي من الفلسفة، ويقدِّم لبعض الشخصيات البارزة في هذا الجانب.
تحدث المؤلف عن الهمِّ الفلسفي الفردي، وضرورته في انتشال المرء من واقعه المرير إلى آفاق المعاني المتنوعة والنظريات البهيجة، لا سيَّما أن الظروف التي تصنع الفيلسوف عادة ما تكون بشعة وأليمة، ومن هنا، فإن الفلسفات الأولى كانت طرقاً للحياة اعتمدها البعض هرباً من تعقيد حياتهم وزيادة الجنون فيها، فظهر ما يسمى بالتدريبات الروحية التي ظهرت على شكل وصايا نفسية، يُلزم بها الإنسان نفسه لينأى بها عن الألم والخسارة، وعن التصور المَرَضي للموت الذي ينغص على الفرد حياته.
وتناول الكتاب امتزاج التدريبات الروحية بالتعاليم المسيحية، قبل أن يتناول، كمثالٍ على الحياة الفلسفية الجديرة، التهكم السقراطي الناجم عن توترٍ يُصيب العلاقة بين الجهل بالمفهوم اللغوي لدى الشخص، وبين الخبرة المباشرة التي تضعه في قلب هذا المفهوم فيعيشه واقعاً. وتحدث عن صورة سقراط في الفلسفة القديمة، فهو المتشكك المتسائل الذي لا يعرف شيئاً ولا يصبو إلى تثبيت رأي أو موقف، بل إلى طرح الأسئلة، متهكماً أثناء ذلك باللغة وحدودها المتواضعة أمام الفكر البشري، فكان موته بذلك انتصاراً للفلسفة ولتعاليمها. لذلك كانت غاية المحاورات السقراطية الوصول إلى نوعٍ من الوجود لا يمكن الوصول إليه من دون الآخر.
ثم تحدث بيير عن ضجر ماركوس أوريولوس من الحياة والملل الذي كان يعتريه للتكرار الذي بدت في نظره، فظل يؤكد مراراً على رتابة الوجود الإنساني ومسرحية الحياة التي ما تفتأ تُعيد نفسها، فيضع فلسفة جديرة للخروج من هذه الألاعيب عبر اليقظة والانتباه والتيقن من أن الموت لن يحرمنا شيئاً جوهرياً إذ يسلب منا الحياة الرتيبة، ويلفت نظر قارئه إلى التمسك باللحظة الحاضرة ونفي الحكم القيمي عن الأشياء، لرؤية العالم على ما هو عليه دون أحكام مسبقة.
كما تناول هادو في كتابه القيمة العلاجية للكتابة وكونها لا تكتفي بالتعبير عن الكاتب، بل إنها تُشكِّله من جديد في نظر غيره حتى أثناء عملية الكتابة، فهي تُلقي بصاحبها إلى الكُل المجتمعي ليُحقق من خلاله وجوداً خارجياً ضرورياً لأداء واجباته الإنسانية، ومن هنا فإنه يعدُّ الكتابة تدريباً روحياً، وفعل تطوري يحمل نفس الكاتب عبر المراحل ويسمو بها عالياً، فنفس الكاتب تتشكل بالكتابة وتتطور لتخدم الروح المجتمعية:
“فالكتابة، شأنها شأن غيرها من التدريبات الروحي، تغيِّر مستوى النفس، وتُضفي عليها الكلية. ومعجزة هذا التدريب، الذي يمارس في الوحدة، هي أنه يُتيح لممارسه أن ينفذ إلى كُلية العقل داخل حدود المكان والزمان”

ثم يركز المؤلف حديثه حول لذة الوجود لدى الرواقية وغيرها من الفلسفات، ورؤيتها للحظة الحاضرة على أنها منطوية على اللذة الوجودية العظمى التي لا يمكن للمرء أن يدركها في ماضيه أو حاضره، بل إنه يتمتع بها في اللحظة الآنية التي تُعبر عنه وتنطوي على أفعاله وأفكاره وأحاسيسه ومشاعره. لذلك فإن “فنَّ العيش” كامنٌ في قدرة المرء على التقاط اللحظة الحاضرة الحُبلى بالمعاني وتذوق لذتها في نفسه: “دَع الروح السعيدة بالحاضر تتعلم أن تبغض الانشغال بما يكمُن في البَعد”.
ثم ينتقل بيير إلى الحديث عن الاتجاه الذي نحته جميع الفلسفات في الارتفاع بالفرد عالياً عن محيطه وموقعه ومكانته، للتخلص من النظرة الجزئية له عن العالم واستبدال النظرة الكُلية بها، أي أن يملك الفرد ملاذاً لنفسه يلجأ إليه ليسمو ويعلو ويراقب من منظوره سير الحياة، وفي هذا الصدد فإنه يتناول آراء بعض الفلاسفة في أن الوجود ليس سوى فقاقيع مائية لا تلبث أن توجد حتى تنفجر فلا يعود لها أثر:
“ليس أبهج من أن يكون لديك ملاذات وطيدة آمنة، شيدتها تعاليم الحكماء، بوسعك أن تلقي منها نظرة من عِلٍ على الآخرين وتشهدهم جميعاً تائهين هائمين على وجوههم يلتمسون سبل الحياة”.
ويتناول كذلك “أنسنة” الأفراد للطبيعة من حولهم، ليرونها مُلبية لحاجاتهم ورغباتهم التي لا تنضب، الأمر الذي يحول بينهم وبين فهمهم لها ولقوانينها الذاتية وجودها المُستقل عنهم واللغة التي تُحدثهم بها، ويجعلهم أكثر اندفاعاً في حياتهم وتعاركاً وأكثر ميلاً إلى تقديس الطقوس الاجتماعية والنظم الموضوعية على الحقائق الواقعية التي تقدمها لهم الطبيعة. ومن هنا فإنه ينتقد الرؤى الفردية للعالم الخالية من “الدهشة الفلسفية” أو “اللمسة الفنية” التي ترى العالم كما هو مُستقل بجماله وكينونته.
وينتقد أخيراً الدراسات الفلسفية الحديثة التي حولت الفلسفة إلى دراسة تاريخية جامدة، أو مساقات أكاديمية جافة تخضع للقوانين والأنظمة واللوائح أكثر ما تخضع للإبداع الفردي والابتكار اللفظي، الأمر الذي كان نتيجة طبيعية لسيطرة رأس المال على مؤسسات علمية وأكاديمية، يُطلب منها في المقام الأول توفير البيئة الملائمة لبناء الإنسان الحديث، لقد كانت الفلسفة القديمة مُعبرة بالدرجة الأولى عن فنٍّ للعيش، بل كانت نتيجة هذا الفن، غير أن الفلسفة الحديثة تحولت إلى “رطانة تكتيكية مقصورة على المتخصصين”. أما الحكمة الفلسفية فيُثبت الكاتب وجودها في قدرة المرء على تحرير نفسه من رغباته وأهوائه وتحقيق وجودٍ جدير له في الحياة مع الآخرين، يحفظ له خصوصيته الفكرية ويجعله منخرطاً في الوقت نفسه في واجبات الحياة العامة.
وبهذا تكون الفلسفة تهذيب للنفس وتأديبها وعلوٌ بها إلى المراتب العليا من الوعي والفكر والعقلانية المجردة، وهي طريقة في العيش تنأى بالفرد عن سفاسف الأمور والأحكام العاطفية التي تعميه عن إدراك الجمال الكوني، بعيداً عن التلقين الجامعي لها الذي يهدف إلى حشو أدمغة الطلبة بمذاهبها وطرقها: “صعبة هي ممارسة الفلسفة ولكن الأشياء الممتازة هي دائماً صعبة بقدر ما هي نادرة”.
إنه كتاب جميلٌ ونافع بلا شك، ولعله يُقرأ مراراً.