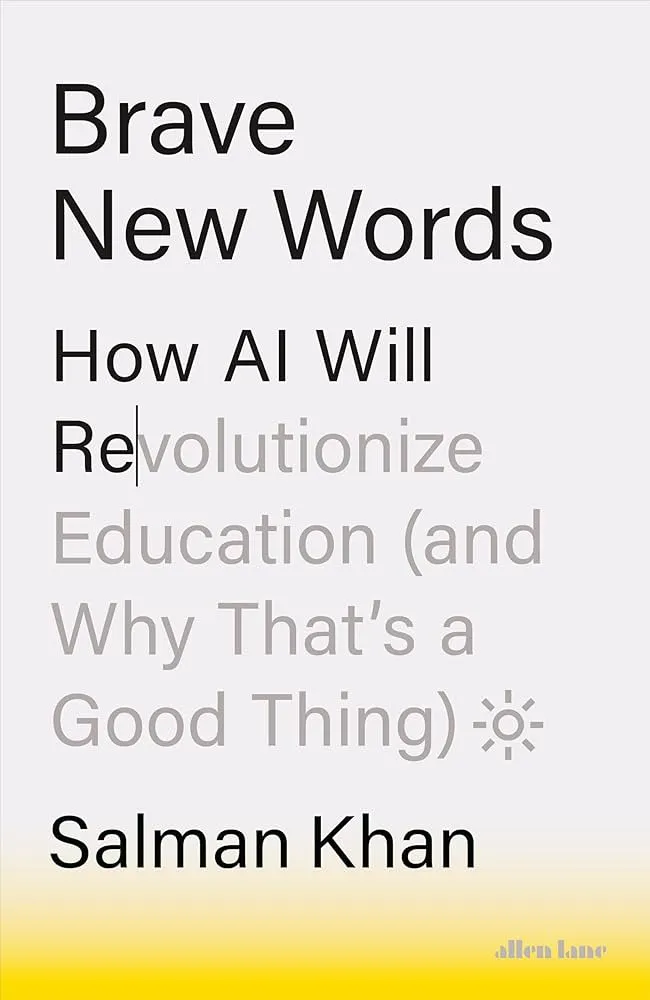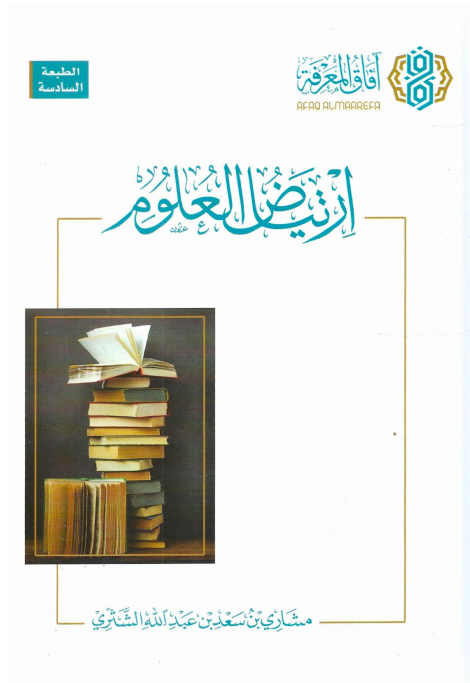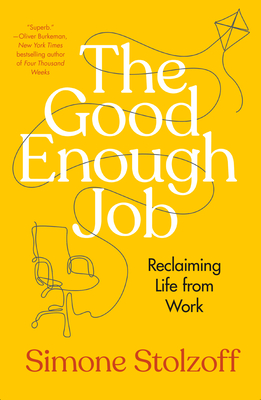يعدُّ كتاب “ارتياض العلوم” من المؤلفات التي تعين المرء على تذليل الصعاب وتيسيرها للوصول إلى المطلوب المرغوب. مهما بلغ الإنسان من مراتب العلم والإيمان فقد تعتريه فترات ضعف وفتورٍ، وإن لم يدركها بالدواء المناسب غدت النفس عليلة هزيلة. لذا من الجدير أن نسلط الضوء على الكتب المميزة التي تبعث بالنفس البشرية الخير وتحثها على النهوض بذاتها ومجتمعها. وطالب العلم في أشد الحاجة إلى مثل هذه الكتب. إذ تعينه على ضبط معارفه وتوجيهها واستثمارها على النحو الأمثل. هنا وجدت أسرار العلم ودقائقه ورقائقه وثمرته ونتاجه، فهو أعذب ما يكون وأرق ما يوصف! غاص المؤلف في أعماق ولب العلم والمعرفة واستخرج لآلئها ودررها.

الكتاب في جوهره هو نتاج تأمل المؤلف، وحصيلة مطالعته الواسعة، وكثرة مباحثته العميقة وطول مدارسته المستمرة، كتبها بأسلوب أدبيُّ بليغ، وسرد فريد، وسياق رصين، مع يسرٍ في العرض وسهولة في التلقي. ولخص المؤلف مضمون الكتاب بقوله:
“متعلقات التحصيل العلمي من النظر في وسائل العلم، وغاياته، وأجناسه، ومدارج تحصيله، بما يمثل مجموعة مقدمة في الوعي.. رجاءَ الظفر بما يحصل به للنفس ارتياح، وللعقل ارتياض”.
ضمَّ هذا السِّفرُ جُلَّ الأسئلة التي يحتاجها طالب العلم منذ بداياته وحتى وصوله إلى مراتب الصناعات العلمية الرصينة والمكينة. وكان للمؤلف باعٌ واسع في الاقتباس من المصادر الأدبية،الذي يعكس سعة اطلاع المؤلف وقدرته على الربط بين العلوم، مثل “الإمتاع والمؤانسة”، “الموازنة”، “دلائل الإعجاز” وغيرهم الكثير، مما أضفى على الكتاب عمقاً وإثراءً بالغ الحسن والفائدة. وأجمل ما استُهلّت به ديباجته هي الاستشهاد بالترحيب النبوي لطالب العلم عندما قال له النبي ﷺ “مرحباً بطالب العلم”.
- باب حب العلم:
خصصه المؤلف لجمع المقولات التي تحثُّ طالب العلم على محبّة المعرفة وتُبيّن دواعي ذلك. كما أشار إلى أهمية ترويض النفس على حبّ العلم وأهله ومجالسه. فكلِّ شيءٍ متعلَّم ومُكتَّسب، وهذه قاعدةٌ ينبغي أن يستنَّ بها طالب العلم. فإذا أحببت شيئاً قادك الشغف إلى الاستزادة منه والبحث عنه في كل موضع. وكما قال المؤلف: “كل حركة في العالم فإنما يبعثها الحب..”.
والشيء بالشيء يذكر، فقال ابن القيم رحمه الله: “إن المحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه”، أي ما دام القلب مشحوناً بالمحبّة، هانت في سبيلها الصعاب، وخفّت المشقّة، إذ تتحول العواطف الإنسانية إلى طاقة دافعة، فهي أصل كل مبدوء. وختم بأهم الأمور التي تُعين على حبّ العلم ومنها اختيار البيئة الصالحة والمجالس النافعة والمشاركة الفاعلة. إذ يقول:
“اجعل طلبك للعلم روحاً ساريةً في محيطك، مجالسك، أقرانِك، كن بالعلم منه وإليه”.
- باب سراب العلم:
كلمة “سَرَاب” تحمل دلالتين؛ الأولى تشير إلى الظاهرة الطبيعية التي ترى كمسطحاتٍ مائية من بعيد، والثانية تعني المسلك الخفيّ، كما ورد في قولة ﷻ ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ [الكهف: 61] أي مسلكا خفيّاً. ويقدم هذا الباب في طيّاته دافعاً وحافزا كبيراً للاستزادة من العلم وأخذه بقوة.
- باب شعاب العلم:
عنوانٌ يشير إلى الجذور الراسخة للعلوم وكثرة تفرّعاتها. كان العلم قديما وشائج مترابطة دون التقسيم، وكان مدلوله يتّسع ليشمل الفقه في الدين بشتى موضوعاته. أما اليوم انولدت الفروع المصدرية واستقلت حتى تسهم في استقلالها، وإلا فنشوءُها مرتبط بالمصدر الأم وما هي إلا تمثلات لجوانب منه. وهذا الأمر يساعد في اتساع رقعة التخصصات المختلفة حيث كان لابن عباس-رضي الله عنه- مدرسة تفسيرية مكية، وكان لعليّ -رضي الله عنه- مدرسة فقهية كوفية، ومع تعاقب الأزمنة نشأت ثغرات معرفية استدعت استحداث علوم متخصصة وبيّن المؤلف ذلك فقال:
“مع مرور الأزمنة = ظهرت على السطح ثغرات علمية استدعت سدّها بإحالة العلوم التي كانت في العهد الأول مَلَكاتٍ لتكون صناعاتٍ؛ ففساد اللسان أفضى إلى تصنيع علوم اللغة، واختلال الاستدلال أفضى إلى تصنيع علوم أصول الفقه، بدء فشوِّ الكذب كان تمهيدًا لتصنيع علوم الحديث”.
كما تناول المؤلف مسألة “ثنائية التخصُّص والتوسُّع” مستعرضا آراء العلماء، موضحًا أمرين:
الأمر الأول: يرى العلماء أن العلم بحرٌ لا يُؤخذ دفعةً واحدة، بل يُرتشف شيئا فشيئا، وأن ليس لأحد بمفرده التشعب بشتى مسائل الفقه والدراية، وأن التوسع في العلم يؤدي إلى العجلة لتطويقه وتحصيله، والعلم لا يأتي بالمسارعة وإلا ذهب لبه وجوهره، وذكر قول يونس بن يزيد عندما قال له الإمام مالك رحمهم الله جميعًا:
“يا يونس لا تكابر هذا العلم، فإنما هو أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خُذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع اللَّيالي والأيام”.
ومنهم من قدر أن اتساع العلم ربما أغرق الطالب في لججه فأوصى بأن يتجه اهتمامه إلى أنفعه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه:
“العلم أكثر من أن يُحصى، فخذوا من كل شيء أحسنَه”.
ومنهم من أوصى بدقائق العلوم خشيه ضياعها، ومنهم من قدر أن مع اتساع العلم يأخذ الطالب بعجلة فيمر عليه العلم دون تحقيقٍ لمسائله. وفى هذا قال الخليل بن أحمد رحمه الله:
“إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفنٍّ من العلم، وإن أردت أن تكون أديبًا فخذ من كل شيء أحسنه”.
الأمر الثاني: يؤكد أن في كل علمٍ مساحاتٍ يمكن الإحاطة بها مع قصور النظر في غيرها، كما هناك مساحات لا تُستوعب إلا بتجاوز حدود التخصص والتعمق فيها، وقد ضرب المؤلف ثلاثة نماذج على ذلك، أحدها حمّادُ بن أبي سليمان شيخ فقيه الدنيا أبي حنيفة، الذي مع إمامته في الفقه واتساع دائرته فيه، لم يكن ذا باعٍ في الحديث وهذا لم يكن قادحًا في إمامته الفقهية، لكنة أثر سلبًا في جوانب فقهه لاشتراك أرضية الرأي والأثر فيها.
وفي الختام، لخَّّص ابن حزم-رحمه الله- هذه المسألة بقوله: “من اقتصر على علمٍ واحد لم يطالع غيره أوشك أن يكون ضُحكَةً، وكان ما خفِي عليه من علمه الذي اقتصر عليه أكثر مما أدرك منه، لتعلُّقِ العلوم بعضها ببعض، وأنها درجٌ بعضها إلى بعض. ومن طلب الاحتواء على كل علمٍ أوشك أن ينقطِعَ وينحسِرَ، ولا يحصل على شيء، وكان كالمحضر إلى غير غاية، إذ العمرُ يقصُرُ عن ذلك”.
ونبَّه أن جهل العلم بالعربية يؤدي إلى فساد الرأي والنظر، كما قال الجاحظ -رحمه الله- “للعرب أمثال واشتقاقات وأبنية، وموضع كلام يدل عندهم على معانيهم وإدارتهم، ولتلك الألفاظ مواضع أخر، ولها حينئذٍ دلالات أُخر، فمن لم يعرفها جَهِلَ تأويل الكتاب والسنة، والشاهد والمثل، فإذا نظر في الكلام وفي ضروب من العلم وليس هو من هذا الشأن هلك وأهلك”.
- باب تحقيق العلم:
وقد فصل فيه بين الضبط والتحقيق. فالضبط يُعنى بمقدمات ونتائج العلوم، أما التحقيق فيتعلق بتحرير مسائلها، والتوغّل في أغوارها، والوقوف على مقاصدها. وقد عقد المؤلف مقارنة بين هذين الأصلين المرجعيين، مبيناً الفارق بينهما:
- من حيث الوظيفة، فإن الضبط يُراد منه جمع مسائل العلم في سياقٍ يسهل على الطالب الإحاطة بمسائله وضبطها. أمّا التحقيق فيُراد منه تحقيق مسائل العلم وتنقيحها وتحرير دلائله.
- ومن حيث المضمون، ينبغي أن يشتمل على خلاصاتٍ مركزةٍ لنتاج علماء ذلك الفن، بينما التحقيق يستلزم مادةً عاليةً محققةً تمرن القارئ على تحقيق المسائل وتحرير الدلائل.
- أما من حيث الحجم، فإن الأصل في الضبط أن يكون الكتاب موجزاً أو متوسطًا، ليسهل على الطالب استيعابه، في حين أن التحقيق يقتضي توسعاً واستطراداً لذا يجدر به أن يكون متوسطا أو مبسوطا، ليكون بمنزلة ورشة تدريبية على مهارات التمحيص والتحقيق.
- ومن حيث التأثير، فلا يُشترط في الضبط أن يكون ذا وقعٍ عميقٍ أو محل عناية العلماء، بخلاف التحقيق الذي لا بد أن يُثمر أثراً ملموسا لعلمٍ، أو أصلاً لاتجاه، أو محل درس العلماء وتدارسهم.
- ومن حيث التعدُد، فإن الأصل في كل علم أن يُتّخذ فيه مرجعٌ للضبط، أما أصل التحقيق فيرتبط بعامل الزمن، إذ إن العمر لا يتسع لا تخاذه منهجاً في كل فن، نظراً لما يتطلبه من عمقٍ في البحث، ونفاذٍ في التأمل، وحفرٍ في جذور المسائل العلمية.
وبعد استيفاء المؤلف لهذا التحليل العميق، أورد نماذج لأعلامٍ راعوا هذه الحثيثات، فكان منهم من تميّز بالضبط، ومنهم من بلغ في التحقيق غايته، ومنهم من جمع بينهما في توازنٍ دقيق.
- باب فرحة العلم:
يحُثّ المؤلف في هذا الباب على التأمل في جوهر العلم ومكنونه، يرى أنه رأس الأعمال العلمية. والسرّ الكامن وراء استثمار المعلومات وتخير هيئتها وحسن التصرف فيها لا مجرد العلم بها، بل التأمل في جوهر المعلومة، وتخيراً لأوجه الاستفادة منها. وقلما ينسى المرء مسألةً تأملها، وبقدر تأمله لها يزداد ثباتها ورسوخها.
وقد أشار المؤلف إلى أن فاعلية التأمل مقترنةٌ بعملية التحصيل ذاتها، فكلما فاقت قدرة الطالب على الجمع، كان تأثير تأمله في المسائل العلمية أكبر وأنفع. يقول في هذا السياق: “التحقيق العلمي يتعاظم بقدر استكمال الطالب لقوتي الجمع والتأمل”. وضرب مثلا بابن تيمية -رحمه الله- الذي كان عنواناً في التأمل، وأبوابه مفتوحةً على كل مسألةٍ تستحق النظر، فكانت كتبه ورسائله تجسيداً لسعة التأمل وعمق الاستنباط.
وقد شدّد المؤلف على أن فاعلية التأمل مرتبطةٌ بعملية التحصيل وجمع المعلومات، فلا يتحرك الطالب في فضاءٍ خاوٍ من المضمون، فقال:
“التأمل مشروع فكرةٍ، والاطلاع المجرد مشروع معلومةٍ، وإنما يحصل التمايز بين الطلبة بقدر استحواذهم على الأفكار لا المعلومات”.
وبرهن على ذلك بقول العقاد رحمه الله: “اقرأ كتابا جيدًا ثلاث مرات، أنفع لك من أن تقرأ ثلاث كتب جديدة”، أي أن الإكثار من التأمل في الكتاب الواحد، وحسن الاطلاع عليه والتأمل فيه، هو السبيل إلى استنتاج المعرفة الخالصة دون شوائب. وسُمي هذا الباب “فرحة العلم” استناداً إلى قول الجاحظ -رحمه الله- “للعلم سَورةٌ، ولانفتاحه بعد استغلاقه فرحةٌ، لا يضبطها بشريٌّ وإن اشتدَّت حُنكته، وقَوِيَت مُنَّتُه، وفَضَلت قُوَّتُه” والسَورة -بفتح السين- تعني شدته، وحدته، وأثره العميق في النفس.
- باب إثارة العلم:
يتناول المؤلف قضية ملكة الصناعة البحثية. مميزا بين الكتابة البحثية التي هي وسيلةٌ ناقلة، والصناعة البحثية التي هي وسيلة منتجة.
يقول “ربما كان مُحصَّلُ الصناعة البحثية سطراً واحداً، لكن الباحث احتاج للوصول إلى هذا السطر أن يقرأ عشرات وربما مئات الصفحات، كما احتاج إلى أن يستثمر مختلف حواسه المعرفية”. ثم أورد خمس صناعات بحثية:
- التمييزات المعرفية الذهبية، المقصود بها ملاحظة أنواع المعارف وأجناسها وفرزها، مع استصحاب الذهنية البحثية أثناء القراءة والمعالجة، وتمر هذه العملية بمرحلتين: قبليّة وبعديّة.
- احتفاء العقل بالسؤالات، وغايتها الوصول إلى النتائج، إذ التمييزات بحثٌ في المقدمات يؤدي إلى النتائج، بينما السؤالات بحثٌ في النتائج يُفضي إلى الكشف عن المقدمات، وكثيرٌ من السؤالات الكبرى كانت إجاباتها أطروحاتٍ علمية متكاملة.
- تحديد موقع المادة، أي تحديد موقعها في عمود البحث، من خلال استبانة الطريق واستقامة تصوُّر موقع المادَّة، ملاحظًا موضعَها مما قبلها وتأثيرَها فيما بعد.
- توسيل المعلومة، وغايتها أن تكون للمعلومة علائق تربطها بغيرها من مباحث العلم، ولها في ذلك صورٌ متعددة.
- استجلاب الأفق المعرفي، موجزه أن “لكل علم أوائل تفضي إلى أواخره، ولكل موضوع مداخل تقود إلى حقائقه، ولكل بحث صناعاتٌ تمكّن الباحث من حصد جواهره، وفَرقُ ما بين باحثٍ وآخر جودةُ مداخله، وإحكامُ صناعاته، ومدى قدرته على الوصول إلى منابع العلم وخزائنه”.
- باب حياة العلم:
يتناول هذا الباب أهمية التلقي عن العلماء الكبار، وضرورة المذاكرة العلمية بين الأصحاب، حيث إن الإنسان اجتماعي بطبعه، فالأولى أن يكون اختلاطه بأهل العلم قائما على تبادل المسائل وإثارة الأسئلة التي تستفز الفكر للبحث عن أجوبتها والتغلغل في مدلولها.
- باب تعليم العلم:
يُعدُّ التعليم إحدى طرق المذاكرة العلمية. فالمعلِّم غالبا يكون في المادَّة التي يقدَّمها أعلى رتبة من المتلقِّي، وهذا يمنحه ولاية عرض المعرفة وإدارة تقديمها. مع إشراك الطلاب في تداولها. فبطرح الأسئلة تنكشف ثغرات المادَّة العلمية، وبذلك يستوفى أركان المادَّة، وتعرض بصورة متكاملة. وهنّا يزهر جمال مهنة التعليم، إذ لا يقتصر نفعه على المتعلِّم فحسب، بل يمتد إلى المعلِّم. فيزيده إحكامًا لمادته العلمية، كما قال المؤلف: “التعليم يقدِّم للمعلم تصوُّرًا أنضجَ حول مادَّته العلمية بتجويد مكوِّناتها وملءِ فراغاتها”، ولعلّ سرّ تفوّق المذهب الحنفي يرجع إلى طبيعة التفاعل بين التلاميذ وأستاذهم، فقد نشأ عن احتكاك فكري عميق، صقله النقاش وبلورته المدارسة. فهم عدد من التلامذة النجباء يوجِّههم أستاذٌ عبقريٌ.
- فصل دمع العلم:
ويحمل هذا الباب استفتاحيه لافتة لأبو بكر القفال -رحمه الله- قال: “ما أغفلنا عمّا يراد بنا”، فما أشد الغفلة عن الغاية التي من أجلها يُطلب العلم. ويحذر هذا الباب من أن يكون التحصيل مجرد تكديس للمعلومات دون أن يثمر صلاحًا في القلب والعمل. كما يلخص معناه قول أبو الدرداء رضي الله عنه: “ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرَّةً، وويلٌ لمن يعلم ولا يعمل سبعَ مرَّات“، فيدعو فيه المؤلف طالب العلم إلى أن يكون همه صلاح القلب، إذ به يُعرف صدق قصده واستقامة مسيرته. فالعبرة ليست في كثرة ما يُحصِّله المرء، بل في نفعه وأثره في تهذيب النفس وتقويم السلوك، فالعلم الذي لا يُورث عملاً، يوشك أن يكون حجةً على صاحبه. لذا يقتضي أن يكون همّ طالب العلم صلاح قلبه واستقامة قصده.
- باب نجاز الارتياض:
يستشهد المؤلف بقول أحد السلف: “لا ينبغي لأحدٍ عنده شيءٌ من العلم أن يضيع نفسه”، ومختصر القول إن طالب العلم إذا عرف حقيقة ما يطلبه ومكانته ومقامه عند الله ﷻ أيقن أن أخذه ولو بالقليل الذي يقربه من الله ﷻ خير من كثير يبعده عنه ويثبطه:
“فلتكن وارث الأنبياء، معتمداً في تحصيله العلمي على الله وحدَه، متخلِصاً من حَولِه وطَولِه وقُوَّتِه، إذ لا حول ولا طول ولا قوة إلا بالله”