
الحمدُ لله الذي أنزل على عبدهِ الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والصّلاة والسّلام على من أُوتي جوامع الكلّم، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلّم، وبعد:
فإنّ لغةً يتنزَّلُ بها كلام الله سبحانه وتعالى، لهي لغة مصطفاة منتقاة تهيأت لاستيعاب أكرم المعاني وأسناها؛ وهذا وحده دليلُ شرِفها وبرهان فخرِها؛ إذ من المعلوم ضرورةً عند علماء الأمة سلفِها وخلفِها أن البيان الذي قَهر القُوى، وأعْجزَ القُدَر، وألجم أساطنة الخطاب إلجامًا، وأفحم شقاشق الشُّعراء إفحامًا، ما كانت معانيه لتتزَّل من عليائِها إلا في أشرق دِيباجة وأنصعها وأحلاها وأوفاها، وذلك لأن معاني القرآن الكريم هي كلام الله سبحانه وتعالى، وفضلُ كلام الله على كلام النّاس كفضلِ الله على النّاس.
جلال اللّغة العربيّة وجمالها:
الجلال والجمال المطلقان من صفات الله -سبحانه وتعالى- فَهُما إذنْ من صفات كلامه، ومن ثمَّ كان لزامًا أن تتوافرَ هاتان الصّفتان في الألفاظ والتراكيب اللازِمة لتلقي معاني هذا الكلام الإلهي، واستيعابها، والوفاء بدقائقها، دون تقصير أو تفريط، وهذا ما تشهد به دقائق اللّغة العربيّة، ولطائفها؛ إذ لكلِّ تركيب فيها معنى محددًا ودلالةً خاصّة، فقولك: محمّد مستقيم، يختلف عن قولك: محمّد المستقيم، وقولك: المستقيم محمّد، وعن قولك: محمّد ذو استقامة، وهكذا… فكلُّ اختلافٍ في التركيب يتبعه اختلاف في المعنى، كما أن لكلِّ لفظٍ في اللّغة العربيّة دلالة تُميزه عن غيره، فلفظ (الخبر) يختلف عن لفظ (النبأ)، من حيث أن الأول أعمُّ من الثاني؛ فالخبر يكون لكلِّ أمرٍ صغير أو كبير، عظيم أو حقير، أمّا النبأ فلا يُستعمل إلا فيما هو أهمّ وأعظم، وفي القرآن الكريم: «وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ» (النمل: 22).
بل إن للحروف والحركات والهيئات اعتبارات خاصّة في الدلالة على المقصود، ولا تكاد تجد لذلك نظيرًا في لغة أخرى، وهو ما أشار إليه ابن خلدون في مقدّمته، إذ يقول: “وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد؛ لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعاني، مثل الحركات التي تُعَيِّن الفاعلَ من المفعولِ من المجرورِ أعني المضاف، ومثل الحروف التي تُفضِي بالأفعال أي الحركات إلى الذوات من غير تكلف ألفاظ أخرى، و ليس يوجد ذلك إلا في لغة العرب، و أما غيرها من اللّغات فكلّ معنى أو حال لابدَّ له من ألفاظ تخصه بالدلالة؛ و لذلك نجد كلام العجم من مخاطباتهم أطول مما نقدره بكلام العرب، وهذا هو معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم: “أوتيت جوامع الكلّم واختصر لي الكلام اختصارًا”، فصار للحروف في لغتهم والحركات والهيآت، أي الأوضاع، اعتبار في الدلالة على المقصود غير متكلفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منها، إنّما هي ملكة في ألسنتهم يأخذها الآخر عن الأول كما تأخذ صبياننا لهذا العهد لغاتنا”، فاصطفاء الله -سبحانه وتعالى- للّغة العربيّة لتكون وعاءً لمعانيه التي فيها صلاح أمر الخلق دُنيا ودِينا، معاشًا ومعادًا، إنما هو دليل ظاهر وأمارة بيِّنة على جلال هذه اللّغة وجمالها في الوقتِ ذاته.
نزول القرآن وأوضاع اللّغة:
كان لتوقيت نزول القرآن الكريم خصوصيّة مع أوضاع اللّغة العربيّة، ذلك أن العرب في ذلك الوقت على جهة الخصوص كانوا قد بلغوا الذروة في الاستعمال اللّغوي، والتعرُّف على دقائقِ اللّغة، وفهم مغازيها، وأحسُّوا برهف سليقتهم أنهم بلغوا من التحضر البياني ما لم يبلغه أحدٌ من الناس، فصاروا يتبارون في فنون القول، ويتنافسون في ضروب الكلام نثرًا وشعرًا، ويتعاطون المعاني ويميزون غثَّها من سمينها، وأصبحوا خبراء في هذا الشأن، علماء بدقائقه، وقد حفظت لنا المدونة النقديّة ما يؤيد هذا التحضر اللّغوي، حيث أُقيمت المجالِس في الأسواق لتحكيم الشّعر، وتفضيل الكلام، فها هو النّابغة الذِّبيّاني كانت تضرب له قبّة حمراء من أدم بسوق عكاظ، وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها، فيفصل بينهم، ويضع كلّ شعر في طبقته، مُبيّنًا أوجه الإجادة والقصور في الكلام… نعم لقد بلغ العرب في هذه الحِقبة من الزّمن مالم يبلغه غيرهم من النّاس في الإبانة عن المعاني جلّها ودقِّها، ظاهرها وخفيها، وأحدثوا تَقدمًا لغويًا قلما تجده في لغة أخرى، فاستبعدوا غريب الألفاظ ووحشيها، وأبقوا على مستعملها ولطيفها، واستنطقوا دلالات الحروف ومعانيها، وصرفوا القول تصريفًا، وعلموا مواضع التأنق في الكلام؛ ابتداءً وانتهاءً، كما علموا كيفية التنقل بين الأغراض، وميزوا بين الشعر المتماسك والكلام المتناسق، والشعر الذي يشبه بعر الكبش، والكلام الذي ليس له (عِناج) أي رابط وصلة! فقالوا فلان يقول البيت وأخيه، وفلان يقول البيت وابن عمه، يقولُ الجاحظ: “فحين حملوا حدّهم ووجّهوا قواهم لقول الشّعر وبلاغة المنطق، وتشقيق اللّغة وتصاريف الكلام، بعد قيافة الأثر وحفظ النّسب، والاهتداء بالنجوم، والاستدلال بالآفاق، وتعرّف الأنواء، والبصر بالخيل والسّلاح وآلة الحرب، والحفظ لكلّ مسموع والاعتبار بكلّ محسوس، وإحكام شأن المثالب والمناقب، بلغوا في ذلك الغاية، وحازوا كلّ أمنيّة”، هنا وفي تلك الحِقْبة المتفرِّدة على متنِ الدّهر في تاريخ اللّغات، نزل القرآن الكريم بلسانٍ عربيّ مُبين، فلما سمعه عقلاء القومِ منهم علموا علم اليقين أنْ لا سبيل إلى معارضته أو مباراته أو النَسج على مِنواله، وعجزت آلة تحضرهم (اللّسان) عن ذلك، فانقسم القوم آنذاك إلى فِرقتين، فِرقة أيدت هذا الحقُّ المُبِين، وآمنتُ بصفوةِ المُرسَلين، وسلَّمت لكلام ربِّ العالمين، بعدما أذعنوا لشاهد الفطرة التي فطر الله النّاس عليها.
وفِرقة تمادت في العناد، واستمرت في اللّداد، وعمدت إلى إنكار ما بَدَا من الحقّ في أسماعهم كبرًا ولجاجًا، وأعلنوا المعاداة، وشرعوا في تقلُّد آلة أخرى بديلاً عن اللّسان، فطاردوا بكلّ ما أُوتوا من قوّة هذا البيان الذي فَضح عجزهم، وأبان عن تقصيرهم، وحدّد سقف طُموحهم، وأنّه يعلو ولا يُعلَى عليه بشهاداتهم، والحقّ ما نطق به الأعداء.
أما غير العقلاء منهم فذهبوا إلى مُعارضتهِ بكلام سفههُ العامَّة منهم قبل الخاصّة، كما في أخبار سجاح ومسيلمة الكذاب، وغيرهما، وقد نقل الباقلاّني شيئًا من هذا الكلام ثمّ قال: “فأما كلام مسيلمة الكذاب، وما زعم أنه قرآن، فهو أخسُّ من أن نشتغل به، وأسخف من أن نفكر فيه، وإنّما نقلنا منه طرفًا ليَتعجّب القارئ، وليتبصر الناظر، فإنه على سخافته قد أضلَّ، وعلى ركاكته قد أزلَّ، وميدان الجهل واسع!“.

القرآن وصيانة اللّغة العربيّة:
كان للقرآنِ الكريم بالغ الأثر في الحفاظ على اللّغة العربيّة من الضياع والانهيار الذي طال كثيرًا من اللّغات، فأضعفها من بَعدِ قوّة، وأدى إلى اندثار معالمها، ومحو آثارها، وذلك لأن هذه اللّغات لم يتهيأ لها من العوامل ما تهيأ للّغة العربيّة بنزول القرآن الكريم بها، ومن أهم هذه العوامل:
أولاً: حفظ اللّغة من اللّحن:
بعد أن استقرت دولة المسلمين، واتسعت رقعتها، واختلط العرب بغيرهم، ودخل الأعاجم في دين الله أفواجًا، واتّصل العرب بالأمم المجاورة، فشا اللّحن وانتشر وأحسَّ العربُ بهذا الخطر الداهم، إذ كان كلامهم فصيحًا خاليًا من اللّحن والخطأ، مستقيمًا في أساليبه منسجمًا في تراكيبه، وبدأ اللحن خفيفًا على ألسنة العامَّة خصوصًا الموالي، ثم سرعان ما شاع وانتشر حتى جرى على ألسنة الخاصّة، ثم بدأ يتسرّب إلى قراءة القرآن الكريم، فكانت الحاجة إلى تقويم اللّسان، ومقاومة اللّحن الذي أصاب اللّغة، فانتفض البلغاء والفصحاء الباقين على العهد الأوّل بلغتهم، وأخذوا يُقوِّمون ما استطاعوا حتى أُلِّفتْ المؤلفات التي تناولت هذه القضية نحو: كتاب: ما تلحن فيه العامّة للكسائي، وكتاب: ما يلحن فيه العامّة لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وكتاب التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة بن الحسن الأصفهاني، وكتاب: تمام فصيح الكلام لأحمد بن فارس، وكتاب: تثقيف اللّسان وتلقيح الجنان لابن مكي الصقلي، وغيرها.
ثانيًا: اكتساب اللّغة العربيّة مهارات جديدة:
أفاد القرآن الكريم اللّغة العربيّة مهاراتٍ جديدة لم تكن معروفة قبل نزوله، فعلم التجويد والوقف والابتداء من العلوم التي نشأت خدمة لسلامة نطقِ ألفاظ القرآن، وتصحيح مخارج الحروف، والتدقيق في الابتداء بالمعاني والوقف عليها، وانعكس ذلك على اللّغة تجويدًا وإتقانًا لمخارج حروفها، وسلامة منطقها، بل امتدت هذه المهارات إلى الشّعر، فعرف أهل العِلم بالمعاني الوقف والابتداء في الشّعر!
كما أن القرآن الكريم أفاد اللّغة العربيّة تهذيبًا في الألفاظ، وعلوا في التراكيب، فازدادت مهارات الكُتَّاب بما استثمروه من محاكاة هذا الأسلوب العليّ، والاقتباس من ألفاظه، ومعانيه، كما كان سببًا في استحداث أغراض جديدة في فنون القول، فنشأ المديح الإلهي والمديح النبوي، وتحدّث الشُّعراء عن حتمية الموت والحياة بفلسفة جديدة مستمدة من روح القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، كما ظهر فنّ الزّهد، وتأسست معالم شعريته، وازدان الكلام بالحكم والمواعظ الربانية، كما أمدهم القرآن بأحسنِ الأمثال وأروع التشبيهات والاستعارات والكنايات، ولازال عطاؤه مستمًرا حتى تجفّ الأقلام وتُرفع الصّحف.
ثالثًا: كان القرآن سببًا في تأليف كثير من العلوم الشرعيّة والعربيّة كالنحو والصرف، والمعاني والبيان والبديع، وإعجاز القرآن وبلاغته، وكتب تفسير الغريب، وتأويل مشكل لفظه، والأشباه والنظائر، وتأثرت العلوم الأدبية بتلك العلوم المتعلقة بالقرآن، فألفوا في الأشباه والنظائر في الشعر، وفي غريب الشعر ومستعمله، وفي المعاني المختارة منه، كما نشأت العلوم التي تستمد من لغة القرآن مادّتها ومنهجها نحو أصول الفقه والتفسير، والقراءات وغيرها.

رابعًا: حافظ القرآن على التّواصل المعرفي بين الأجيال:
فهذا وعد الله سبحانه الذي لا يتبدّل ولا يتحوّل: «إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ»[سورة الحجر: 9]، فكان حفظُ القرآن لازمًا لحفظ اللّغة التي نزل بها، وكان من أثر هذا الحفظ استمرار الاتصال المعرفي بين الأجيال اللاحقة والأجيال السابقة، في فهم ألفاظ اللّغة وتراكيبها، وفنونها، فسهَّل عملية التعرّف على لغة القدماء، بحيث إذا قرأ الجيل الحالي معاني الشّعر القديم لم يُعْيه فهم هذه المعاني إلا في بعضِ الألفاظ الغريبة، وقد سهلت المعاجم -التي استمدت كثيرًا من معين القرآن الكريم مادتها- هذا الأمر.
خامسًا: أسهم القرآن في انتشار اللّغة في البلدان غير العربيّة، إذ لابدّ للمسلّم عربيًا كان أو أعجميًا أن يتلوَ القرآن باللّغة العربيّة في صلاته، وتلاوته حفظًا وتعبدًا، “ذاك لأنَّا لم نتعبد بتلاوته وحفظه، والقيام بأداء لفظه على النحو الذي أنزل عليه، وحراسته من أن يغير ويبدل، إلا لتكون الحجة به قائمة على وجه الدهر، تُعرف في كلّ زمان، ويُتوصل إليها في كلّ أَوان، ويكون سبيلها سبيل سائر العلوم التي يرويها الخلف عن السلف، ويأثرها الثاني عن الأول، فمَنْ حالَ بيننا وبين ما له كان حفظُنا إياه، واجتهادُنا في أنْ نؤدِّيَه ونرعاه، كان كمن رام أن يُنسِينَاه جملةً ويُذْهبَه من قلوبنا دفعةً”، الأمر الذي دعا كثيرًا من البلدان إلى ابتعاث أبنائها إلى الدول العربية لتعلُّمِ علومها، ثم العودة لتدريس هذه العلوم في مدارسهم وجامعاتهم، مما أدى إلى التبادل المعرفي والثقافي بين الدول، وزاد من انتشار اللّغة العربيّة، وازداد عدد الناطقين بها من غير العرب، تفهمًا لمقاصد الشّريعة، إذ لابدّ من تعلم العربيّة لفهم هذه المقاصد فهمًا صحيحًا يستقيم مع مؤداها.
سادسًا: التصدّي لعوامل انهيار اللّغة الفصحى:
ظهرت كثير من الدعوات تنادي بإحلال اللّهجات العاميّة واللّغات المحلّيَّة محلَّ اللّغة الفصحى، بحججٍ واهية، وبَراهين مُتهالكة، من نحو الدعوة إلى تقريب المفاهيم والمصطلحات التراثية من الأجيال الحديثة، والعناية بنقل أكبر قدر من العلوم والمعارف إلى الجيل الحالي، ولا يخفى ما وراء هذه النداءات من حملات ممنهجة تهدف إلى النيل من اللّغة العربيّة، وتستهدف إضعافها، ولكنها سرعان ما تبوء بالفشل والخيبة والخسران، وذلك لأنّ القرآن الكريم وقف حصنًا منيعًا ضد تمييع اللّغة بأي وجه من الوجوه، لأنّ هذه الدعوات تتناقض مع منهجه القويم المتمثل في قوله تعالى:« وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ» [سورة القمر: 17]، ويقول الشيخ حمود شاكر عن هذه الحملات الشعواء محذِّرًا الأمة الإسلامية من التفريط أو التهاون في شأنها: “والصراع الدائر اليوم بين الثقافة العربية الإسلامية التي نحن ورثتها وبين الثقافة الغربية المسيحية قد جمع أكبر همته في ميدان اللّغة لأنّه يعرف هذه الحقيقة التي بينتها، فبدأ دعوة هذه الأمم العربيّة المتفرقة إلى اتخاذ العاميّة الإقليمية لغة سائدة في كل إقليم عربيّ لكي يحطم هذا الأصل الحامل لثقافتنا وديننا، وليزيد في تمزيق حياتنا وتدميرها، وبلغ دعاته بعض مأربهم”.
كانت هذه أهمُ العوامل التي ضَمِنت للّغة العربيّة البقاء والخلود والتصدّي لعوادي الزّمن، ومواجهة الهجمات الشرسة التي تعرّضت وتَتَعرّض لها، فضلاً عن الأحداث التي أدّت إلى تشتيت الدولة الإسلاميّة، بعد امتدادها واتِّساع رُقعتها وقوّة سلطانها، والتي لو تهيأت لأيِّ لغة من اللّغات لكانت أقوَى أسباب ضعفها واندِثارها، ولكن اللّغة العربيّة مرعيَّةٌ بوعد الله وبكلامه الباقِي، فلهُ الحمدُ والمِنّةُ على جليل هذه النّعمةُ، والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السّبيل.
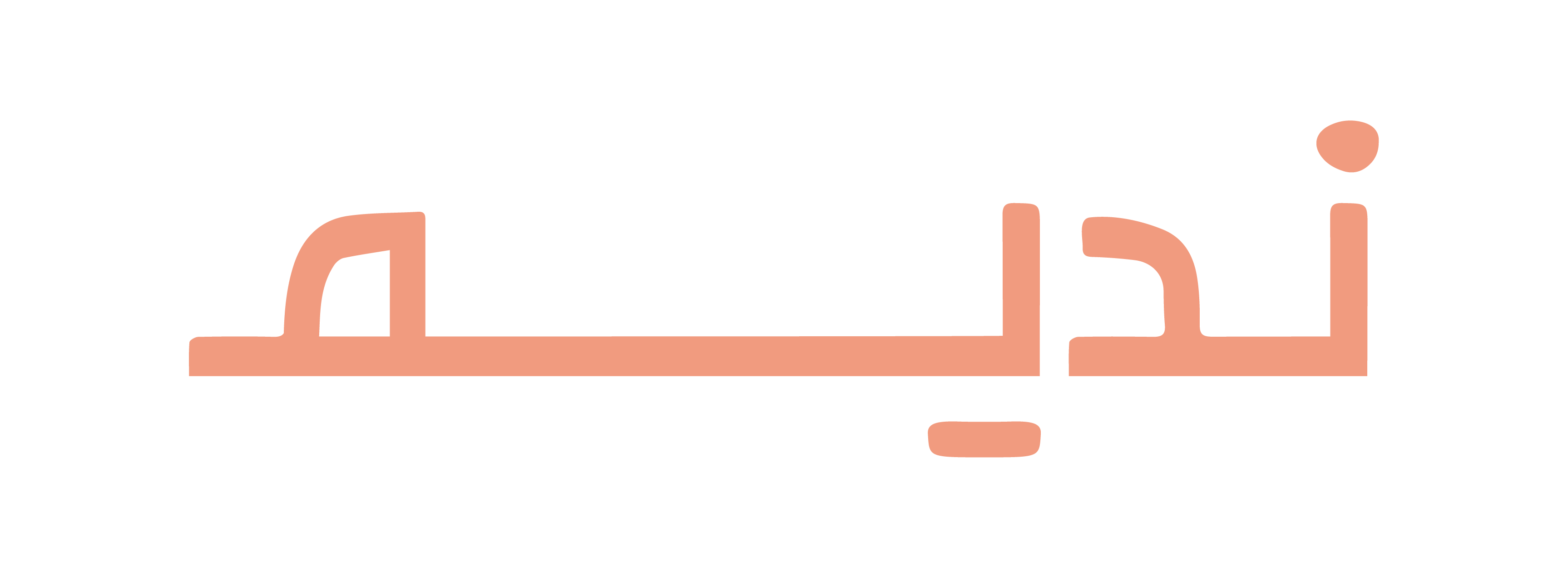

عبارات رائعة وإلىًمزيد من العطاء، الكاتبة واعدة وفي انتظار إبداعات عديدة.
شاكرة لكم اطّلاعكم وثقتكم.
شكرا جزيلا وجزاك الله خير على هذ المقال الأكثر من رائع