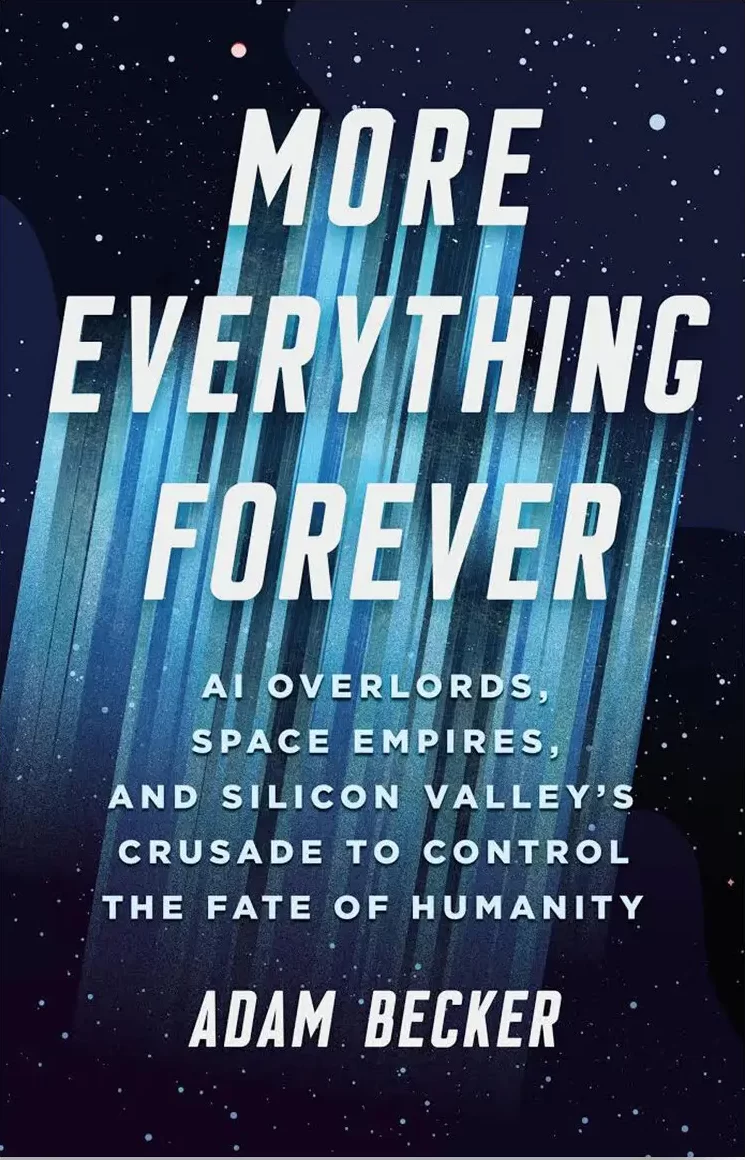يُعد كتاب إنقاذ الروح الحريثة لإيفا إلوز وترجمة بثينة الإبراهيم من الكتب الناقدة والمُهمة اليوم، والتي يجب أن يُفكر بها الإنسان الحديث ملياً، لا سيما العربي الذي يواجه مدَّ الأفكار الجديدة والحديثة على حياته ومؤسسات دولته، وذلك للإطار البحثي الذي انطلقت منه الكاتبة لنقد ما تريد نقده على صورة تساؤلات تشير إلى المشكلة، من دون أن تقدم حلولاً، ولعلَّ ذلك أفضل بكثير، لأن مهمة النقد في استكناه الخطب.
تتحدث الكاتبة في البداية عن الحقائق البارزة التي أفاد منها علم النفس الحديث في أمريكا، والتي استمدَّها من فرويد ونظرياته التي لاقت ترحيباً في المجتمع الأمريكي، لجمعها بين الجانب الأسطوري والطبِّي في تحليل الذات، ولتقديمها إطاراً نظرياً علمياً لفهم الذات الأمريكية وضبط العلاقة بين الجنسين والعلاقة بين الفرد ومؤسسات الدولة. لقد تحدث فرويد ومُفسروه اللاحقون عن الكيفية التي تؤثر بها أحداث الحياة اليومية على شخصية المرء وميوله ونمط عاطفته اللاحق، فكان فرويد، مثلما تصفه الكاتبة، “الصنو الثقافي المثالي لماركس”، ففي حين تناول ماركس قيمة الفرد في عالم العمل، تناولها فرويد في عالم العائلة والحياة اليومية، وبيَّن الحدود الهشة بين مفاهيم المرض النفسي والسواء، ذلك أن العديد من السمات والنزعات يمكن أن تكون دلالة على أعراض مَرَضية خفية، تحتاج العلاج النفسي لإخراجها إلى حيز العلن والحديث عنها، ما جعل من الحياة مشروعاً تأويلياً في التحليل النفسي.
وإثر هذه النظرة المرنة للشخصية الإنسانية التي تتعدد فيها احتمالات المرض النفسي وتختلف أشكاله، تم الربط بين بحث الإنسان عن ذاته الضائعة وبحثه عن النجاح الاجتماعي، فصارت الصحة العاطفية رديفة النجاح مجتمعياً، وانعدام النضج العاطفي رديف الفشل في تحقيق مكانة اجتماعية معتبرة أو التقدم في المجال المهني، ما بدأ سلسلة من النظريات والأدبيات النفسية-الاجتماعية، والتي ربطت بين التقدم في الصحة العاطفية وما يُترجم إليه من التقدم الاجتماعي والمهني، فظهرت ثقافة العلاج النفسي في العديد من وسائل الإعلام، تزعم فهم الذات وعلاقتها بالآخر وتقدم “النصيحة” للأفراد حول الطرق المثلى للتعامل مع أنفسهم والآخرين.
وهكذا، تداخلت مفاهيم علم النفس مع مفاهيم علم الاقتصاد وصار للعقلانية والكفاءة في العمل أبعاد نفسية عاطفية وشخصية، فصار اعتماد رأس المال على الفهم النفسي-العاطفي للذات أمرًا شائعًا فيما صار يُدعى بـ “الرأسمالية العاطفية”. ولأن النظام الرأسمالي غايته الربح والإنتاج فقد دعم الخصائص النفسية المفضية إليهما، أهمها الضبط العاطفي وامتلاك مهارات التواصل الفعال، أو ما يدعى بالمهارات في مجال العلاقات العامة، فظهرت أخلاقيات العمل الجديدة المتداخلة مع أخلاقيات الحياة الخاصة لدى المرء، وصار مُهماً أن يتجاوز الفرد اختبارات الشخصية النفسية قبل قبوله في العمل، والتي تهتم بقدرته على ضبط نفسه وفهم الآخر وفصل نفسه شعورياً عما يحدث حوله والاهتمام بمصلحته الخاصة بصرف النظر عن العوامل الخارجية التي تحاول ثنيه عن ذلك:
“تتضمن القوة النفسية ’الحقيقية‘ قدرة المرء على ضمان مصالحه دون الدفاع عن نفسه عبر رد الفعل أو الهجوم المضاد. بهذه الصورة، ينشأ ضمان المصلحة الذاتية والقوة في التفاعل عبر إظهار الثقة بالذات التي تتساوى بالافتقار إلى الدفاعية أو العدائية الصارخة، فتنفصل القوة هكذا عن الإظهار الخارجي للعدائية وعن دفاع المرء عن شرفه، وهي استجابات كانت جوهرية في تعريف الذكورة التقليدي”
ما يعني أن العقلانية المؤسساتية صارت تُفهم من حيث تحكم المرء بعاطفته والتركيز عليها في آن، أي استكناه مهارات التواصل والعمل بها ولكن من دون أن ينخرط بكامل نفسه فيها، وأن يحافظ دائماً على هدوئه ولغته التواصلية المتقنة التي تحفظ مصلحته ولا تثير انزعاج الآخرين ولا تستثير حفائظهم، وتشير الكاتبة إلى أن ذلك خلق جواً من اللامبالاة النفسية، والناتج عن تحييد المرء لنفسه عن المشكلة وأن يحافظ على مكانته في النظام التواصلي من دون أن يتأثر بالآخرين، أي أن “يلعب اللعبة دون التأثر بها”، أو كما تقول الكاتبة، إن “الشرط المسبق ’للتواصل‘ أو ’التعاون‘ هو، على سبيل المفارقة، تعطيل المرء إدخال انفعالاته في علاقة اجتماعية”، ما يجعلنا أمام سؤال مُهم: إلى أي مدى يمكن للسلوك العلاجي النفسي أن يبدِّل في الإنسان وينزع منه المسؤولي والتعاطف ليجعله منخرطاً في المجتمع والمهنة من دون أن يبالي بهما في الآن ذاته؟

ثم تتحدث الكاتبة عن التآلف بين النسوية والتحليل النفسي من حيث تركيزهما على القضايا ذاتها، وذلك إثر التحولات الاجتماعية التي جعلت مواضيعهما متشابهة، مثل العلاقة بين الجنسين وقضايا الأسرة والمرأة والمعاناة، فبعد موجة العلوم النفسية والتحليل النفسي صارت معايير إنجاح الزواج مختلفة عما سبق، وصار الفشل أو النجاح في العلاقة مسؤولية الفرد وحده ومسؤولية نمط شخصيته التي هو عليها، لذلك تناولت الأبحاث النفسية أنماط الشخصية وطبيعة التواصل القائم بين طرفي العلاقة، وصار عبء إنجاح الزواج أو العلاقات عموماً قائماً على براعة التواصل اللغوي والتعبير العاطفي لدى الفردين، واتفقت النسوية والتحليل النفسي على أن للحميمية دور مُهم في العلاقات الزوجية، وأنها يجب أن تكون الغاية النهائية الواجب تحقيقها بقدرٍ من البراعة والمعرفة وطلب المساعدة، ويقصد بها عادة القدرة الرفيعة على التواصل العاطفي والجسدي في آن، وتحقيق فهمٍ متبادل بين الطرفين يضمن نجاح العلاقة مهما كانت المشاكل التي تواجههما.
بمعنى آخر، لقد عقلنت النظريات الاجتماعية الحديثة المشاعر لدى كلا الجنسين،وطالبت الإنسان الحديث بالتحكم بعواطفه وامتلاك القدرة الرفيعة في التعبير عنها في آن، كون ذلك السبب الحقيقي والأصيل لحل مشاكله مع نفسه والآخر، فصارت مهارات التحكم بالنفس والعاطفة هي المطلوبة والعنصر الثمين الذي يبحث عنه الإنسان الحديث للتخلص مما يُتعبه.
وهكذا، صار للعلاج النفسي سرديته العامة والشهيرة على مستوى الأفراد والمؤسسات، وبالتخلص من الربط الذي أقامه فرويد بين إرادة التغيير على المستوى العاطفي وبين مكانة المرء في طبقات المجتمع، شاعت مفاهيم التحليل النفسي في الأدبيات وسط أجواء من التفاؤل وإمكانية التغيير وتحقيق العديد من الإنجازات عبر ربط التحرر النفسي بالتحرر المادي والنضج العاطفي بتحقيق الإنجازات المادية، وظهرت اتجاهات نفسية تكرِّس سردية الضحية والمرض والصدمة النفسية، ليصير فضاء العلاج النفسي فضاءً تجارياً يستفيد منه قطاع الأطباء النفسيين وشركات الأدوية التي تبيع أدوية نفسية، غير أن المشكلة لا تكمن فقط في تسليع الحالة الذاتية غير المفهومة بعد، بل كذلك في ترسيخ سردية تعرِّف الذات من حيث المرض الذي يصيبها ورحلة العلاج الذي تسير عليه.
ما يعني أنَّ البنية الرمزية السردية صارت متوافقة مع الصناعة الثقافية لتبدُّل مبررات السرد وصوره وتأويلاته بصورٍ استهلاكية تخدم الجهات المستفيدة، وصارت السردية النفسية العلاجية هي القصة التي يحكيها الإنسان الحديث عن نفسه اليوم، فقد عنى السرد الذاتي للمعاناة تحرُّر المرء من هذه الذاكرة عبر مشاركتها مع الآخرين، ولأن الثقافة تحتاج إلى ممارسة اجتماعية كي تنتشر وتترسخ، فقد تمثلت ثقافة العلاج النفسي بمجموعات الدعم المختلفة، والتي تطورت لتصبح استثمارات رأسمالية ضخمة، في عالمٍ بات يحتفي بالضحايا والناجين، ويسبغ عليهم مكانة أخلاقية مُميزة.
لقد تحدث فرويد في نظرياته عن أنَّ الحالة العاطفية للمرء تتبع طبقته الاجتماعية (أي الطريقة التي نشأ فيها والإمكانات المتاحة له)، ولكنه تحدث كذلك عن أن الحالة العاطفية تُنتج هذه الطبقة وتخلق هذه الإمكانات، فالاختيارات الشخصية اللاحقة هي التي تموضع المرء في العالم المهمش أو العالم الرفيع، وفي ذلك كان يشير إلى مهارة ندعوها اليوم بالذكاء العاطفي، أي قدرة المرء على إدارة عواطفه ومشاعره لكي ينال مراده من الحياة أو الآخرين، أي عقلنة العواطف والقدرة على التعبير عنها بالطريقة الملائمة. وللأهمية التي نُسبت للذكاء العاطفي اليوم فقد صار من المُهم امتلاك كلا الجنسين مهارات ذكورية تخص تأكيد الذات ومهارات أنثوية تخص التعبير عن العواطف ليجدا لنفسيهما مكان مُعتبر في سوق العمل، وكانت هذه غاية فرويد في المقام الأول: “كانت أبرز إسهامات فرويد في الثقافة الأمريكية صياغة لغة وتقديم أطر للمعنى تضع الحياة اليومية، والصحة النفسية والسواء في مركز هوية الرجال والنساء الحديثين”، ولكن دمقرطة الحياة العملية والخاصة خلقت فوضى وتناقضات للذات الحديثة، وجعل مسؤوليتها وحدها إيجاد حل لمشكلات اجتماعية في الأصل، وجعل إطار فهم النفس خاص بالنفس فقط من دون المحيط والعوامل الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية العاملة فيها. غير أن اعتراضات الكاتبة الرئيسية على ثقافة العلاج الذاتي اليوم تمحورت حول نقطتين رئيسيتين:
- لا يُمكنك التعبير لغوياً عن كلِّ ما تريد وتفعل وتشعر به، فما يُدعى اليوم بأيديولوجيا اللغة يفترض بأن معرفة النفس ممكنة عبر الاستبطان الداخلي الذي يساعدنا على تقبل محيطنا، ويمكِّننا من التعبير العاطفي عما نريده، غير أن الكاتبة ترى بأن نتيجة ذلك يكمن في “التعمية اللفظية” التي “يعمى” الإنسان عن جوانبه النفسية الخفية عبر اللغة التي يعتقد بأنه يعبِّر بها عنها، فتكون اللغة خافية للجانب لا مُظهرة له، وذلك نتيجة لأن النفس تنطوي على جوانب لا يمكن الحديث عنها باللغة، كالحدس أو البصيرة أو الجوانب الخفية التي تكمن خلف قراراتنا ورغباتنا وأفعالنا من دون الحاجة إلى لغة للتعبير عنها، وهذا يدعم توجهاً اجتماعياً لفهم النفس والذات لا تبعاً للماضي والطفولة فحسب، بل كذلك تبعاً لتشكلها مع الآخرين وعبر الآخرين، حيث “تتشكل أفعال الناس وردود أفعالهم وفق ضغط الموقف، لا وفق خصائص داخلية ثابتة للذات (التي تحتاج إلى كشفها)”، نجد ذلك في الأطروحة النفسية-الاجتماعية-الفلسفية التي تقدمت بها الفيلسوفة جوديث بتلر في كتابها “الذات تصف نفسها”.
- لا يقتصر تعريف الذات على معاناتها، فالتوجه الحديث للحديث عن المعاناة واستنباطها من الماضي ومشاركتها يرسِّخ وجودها كجزء فاعل بل ومُهيمن على الذات وسلوكها وفكرها وتصوراتها، وترى الكاتبة أن استرجاع المعاناة تجديدٌ لدورها في حياة المرء وتعظيمٌ له، إلى درجة تصير هي السردية التي تحكي قصة المرء بعيداً عن بقية الجوانب الأخرى التي نتشكل بها وعبرها، لذلك يعمِّق العلاج النفسي من المعاناة ولا يُحرر المرء منها، بل يقولبه في قالب الضحية أو الناجي ويحتفي به إثر ذلك ويجعله يعرِّف نفسه بذلك الحدث الأليم الذي حدث له، وذلك بأن ينزع سبب المعاناة من الإطار السياسي-الاجتماعي-الاقتصادي ويلقيها فقط في الإطار النفسي، فتصير “المعاناة أثراً للعواطف غير المنضبطة أو النفس المضطربة أو مرحلة يتعذر تجنبها من التطور العاطفي للمرء”. وفي ذلك إلقاء للمشاكل الاجتماعية على كاهل الفرد ليتحمل مسؤولة انزعاجه منها وتعاسته على إثرها، الأمر الذي تحدث عنها مطولاً زيجمونت باومان في كتابه “الأضرار الجانبية”.
ومن هنا، أجد الكتاب ثرياً بالأسئلة التي يطرحها والاعتراضات التي يقف عندها، لقد جعلت الكاتبة من كتابها مقدمة تحليلية وجيزة حول ما تريد الاعتراض عنه في النهاية، والقارئ يشعر بأنها تتحدث عن جوانب نفسية مُهمة نشعر بها اليوم وندرك افتقار التوجه النفسي الجديد إليها، لذلك من المُهم الاطلاع على هذا النوع من الكتب الناقدة لنتمكن من الحفاظ على ما يجعلنا دائماً ذواتاً واعية تُسائل الفكر وتحسِّنه قبل أن تقبل به.