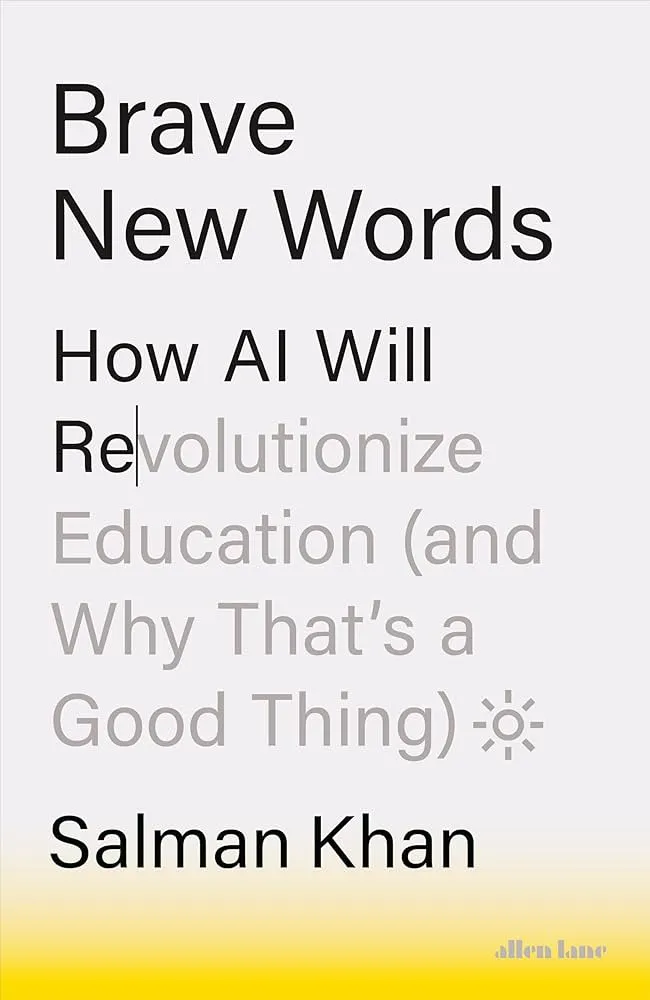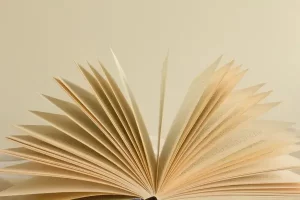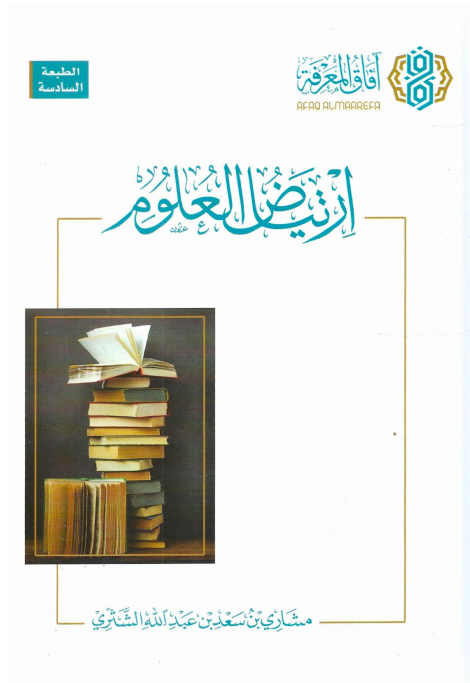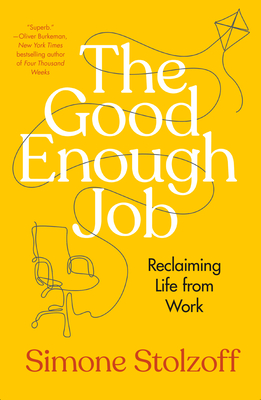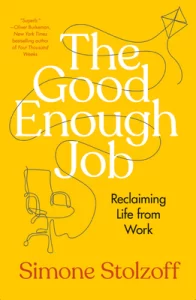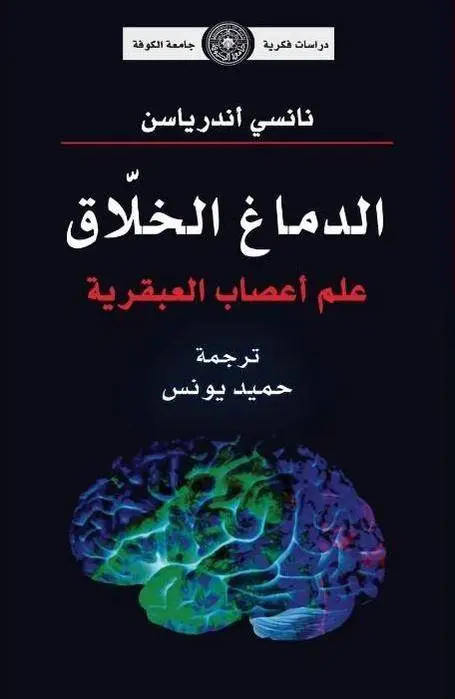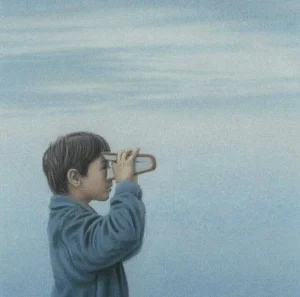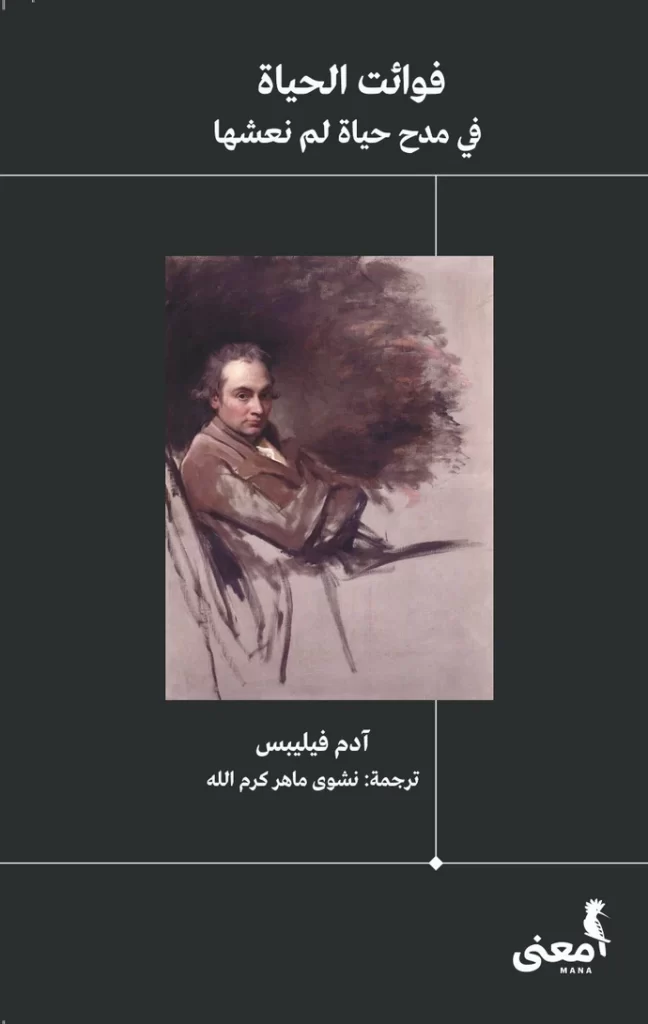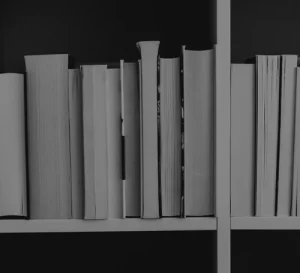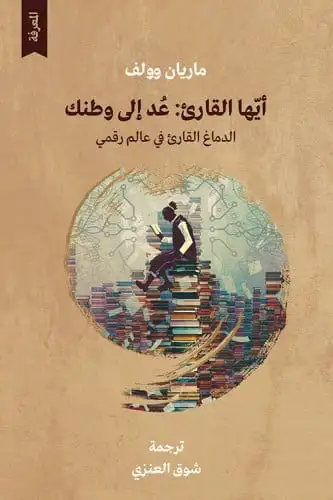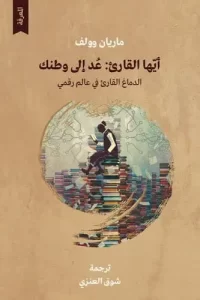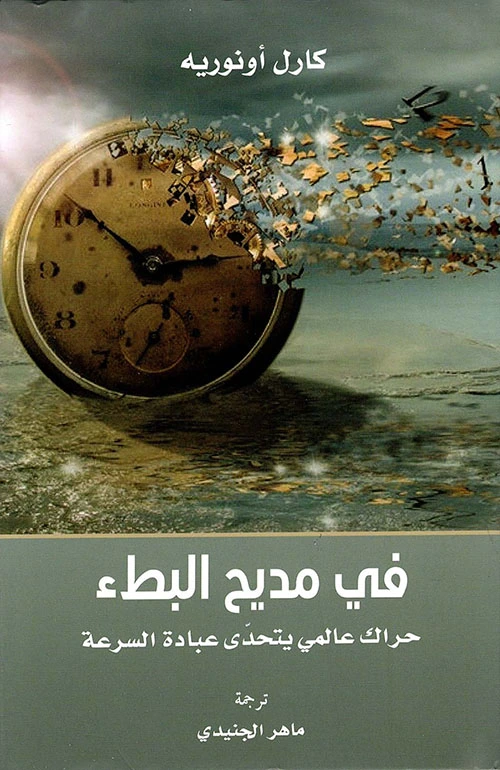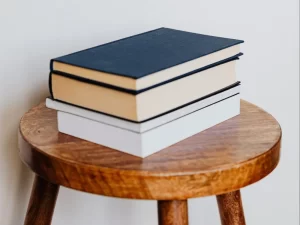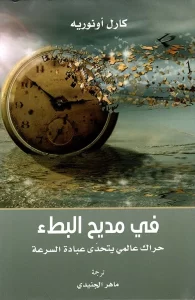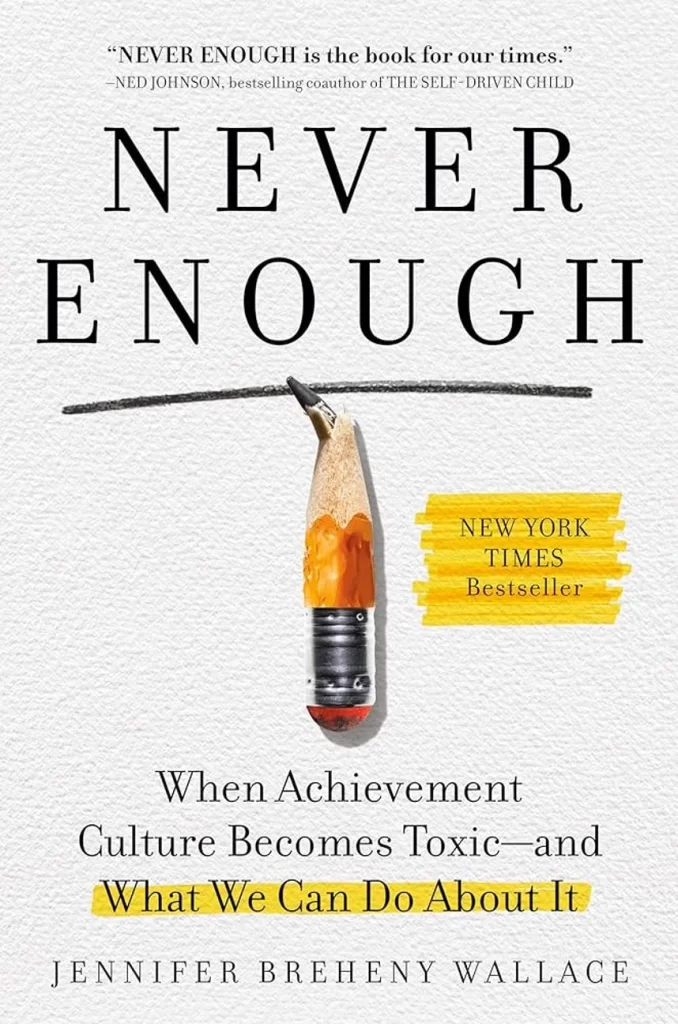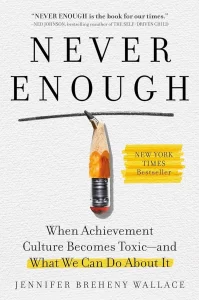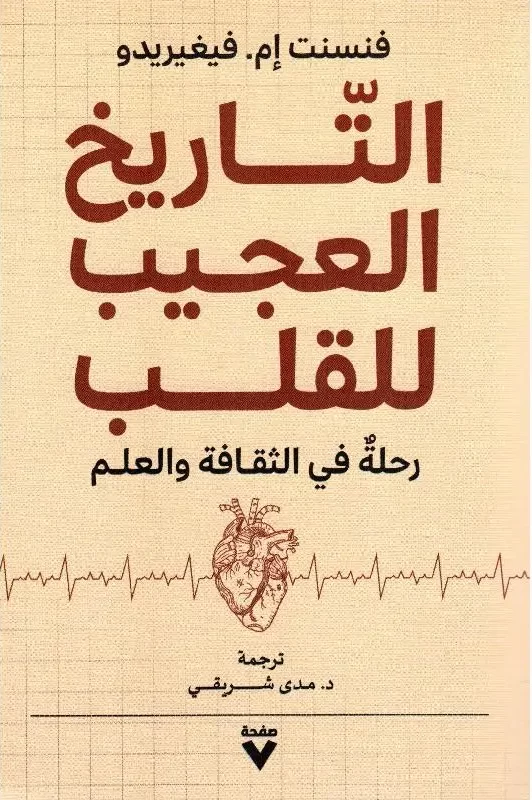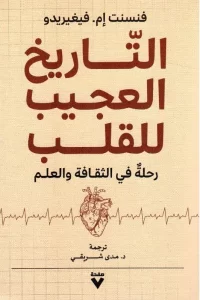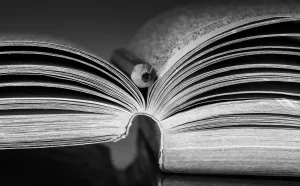التعليم والذكاء الاصطناعي: مراجعة لكتاب كلمات جديدة شجاعة لسلمان خان.
سلمان خان المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية خان، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى لتوفير تعليم رفيع المستوى لأي شخص في أي مكان، أحدثت دروسه على اليوتيوب ثورة في التعليم، حيث حققت مليارات المشاهدات على مستوى العالم. يُعد سلمان خان واحدًا من أكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم وفقًا لمجلة Time، كما أنه مؤسس منصة schoolhouse.worldومدرستَيKhan Lab و Khan World ، ومؤلف كتاب “مدرسة العالم الواحد”.

يقدم سلمان خان خمس أفكار رئيسية من كتابه الجديد “كلمات جديدة شجاعة: كيف سيُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في التعليم، ولماذا هو أمر حسن”:
- المعلّمون ذوو أهمية
إن كان عليّ أن أختار بين معلّم بارع دون تكنولوجيا وتكنولوجيا مذهلة دون معلم، لاخترت المعلم دائمًا، لا سيما في عالم الذكاء الاصطناعي. سيصبح الذكاء الاصطناعي مساعدًا تعليميًا مذهلًا، حيث سيعمل على تصحيح الأوراق وكتابة تقارير المتابعة والتواصل وتخصيص الفصول الدراسية وكتابة الخطط الدراسية، كما سيزوّد المعلّمين برؤى حول فصولهم الدراسية لم يتنبّهوا لها من قبل، لكنه لن يقدر أبدًا على بناء علاقات إنسانية مع الطلاب.
وهذا هو السبب الذي يدفع المعلمين لدخول المجال، فهم لا يرغبون في الانشغال بالأعمال الروتينية كتصحيح الأوراق وكتابة الخطط الدراسية، بل يتطلعون إلى تغيير حياة الطلاب. والآن سيحظون بدعم أكبر لتحقيق غرضهم، ولهذا الدعم أهمية خاصة في الوقت الحالي نظرًا لشدة الاحتياج إلى هذه المهنة ونقص عدد المعلمين على مستوى العالم.
- نحن بصدد شهود ثورة حقيقية في التعليم رفيع المستوى
تتمثل مهمة أكاديمية خان، بصفتها مؤسسة غير ربحية، في توفير تعليم مجاني رفيع المستوى لأي شخص في أي مكان. لدينا تصور منذ البداية أن التكنولوجيا -بما فيها الإنترنت ومقاطع الفيديو حسب الطلب والبرمجيات المخصصة وأدوات المعلم- يمكن استخدامها لتوسيع نطاق أنواع التفاعلات التي كنت أمارسها مع أبناء عمومتي.
بدأت قصة أكاديمية خان عندما عملت في مجال التكنولوجيا محللًا في صندوق التحوّط. احتاجت ابنة عمي مساعدة في الدراسة فشرعت في التدريس لها. انتشر بين عائلتي خبر هذه الدروس المجانية، وسرعان ما وجدت نفسي أدرّس للعديد من أبناء عمومتي. تتمثل رحلة أكاديمية خان من بدايتها حتى الآن في الاستفادة من التكنولوجيا والأدوات حتى يتمكّن المعلمون من توسيع نطاق التعليم المخصص الذي يركز على الطالب، وهو ما كنت أقوم به في الأصل مع أبناء عمومتي.
لقد قطعنا شوطًا طويلًا في أكاديمية خان، والذكاء الاصطناعي التوليدي يقرّبنا الآن من هدف التعليم رفيع المستوى. إنه يرفع سقف الممكن.
اعتدت على توزيع كتب الخيال العلمي على موظفي أكاديمية خان والتحدث معهم عن معلّمي الذكاء الاصطناعي المستقبليين. كانت تراودني هذه الفكرة “ستحقق أكاديمية خان هذا يومًا ما، ربما ليس في حياتي لكن آمل أنه سيتحقق طالما بقينا عقودًا عديدة”.وها قد أصبح الأمر وشيكًا. من المهم أن يدرك الجميع مدى قوة هذه الأدوات، سواء كان لديك أطفال أو كنت تهتم بالأطفال أو ترغب في تعلم شيء ما بنفسك.
- ستتحسن الكتابة ولن تتدهور
هذا توقع جريء لأن ظهور ChatGPT أثار مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في الغش، وبالتالي كان يُعتقد أنه سيقوض مهارات الكتابة كما عهدناها.
تحدثت مع مسؤولين في عدد من أبرز الجامعات في العالم، ووجدت أن هناك مخاوف من احتمالية دخول الطلاب الجامعات الانتقائية دون امتلاك مهارة الكتابة. لا أحد يعلم السبب بالضبط، لكن قد يُعزى ذلك إلى الاختبارات الموحدة التي تركز على الاختيار من متعدد، وقلّة فرص الكتابة واستقبال الملاحظات عليها. تعمل أكاديمية خان على بناء أدوات للمساعدة في هذا الشأن، حيث سيتعاون المعلم مع الذكاء الاصطناعي لكتابة الخطط الدراسية وإعداد تكليفات للطلاب ووضع معايير للتقييم، كما يمكنه الاعتماد عليه لإدارة تلك المهمات.
عندما يستخدم الطالب أداة ذكاء اصطناعي أخلاقية، فإنها لن تكتب المقالة نيابةً عنه، بل ستعينه في صياغة بيان الأطروحة أو تأطير المقالة أو تحسين الاستشهاد، أو تقدم له ملاحظات أو تقترح مصادر أفضل. لا يستقبل أكثر الطلاب ملاحظات على كتابتهم إلا إن كانوا يستعينون بمدرب كتابة أو والدين متابعين بشكل وثيق.
وعندما ينتهي الطالب يسأله الذكاء الاصطناعي “هل أنت جاهز للتسليم؟”، فيسلّم كتابته للمعلم الذي يقدم الملاحظات النهائية. سيُتاح للمعلم الاطلاع على عملية الكتابة كاملة، والتحدث مع الذكاء الاصطناعي كما لو كان مدرب كتابة عمل مع كل طالب من طلابه. كما يمكن أن يكتب الذكاء الاصطناعي تقريرًا عن مدة عمل الطالب على المشروع والصعوبات التي لاقاها وما أحسن فيه.
ثم يقيّم الذكاء الاصطناعي عمل الطالب بناءً على معايير التقييم التي وضعها المعلم، سيظل المعلم هو المسؤول لكن الذكاء الاصطناعي سيساعد في العملية، ونأمل أن يحفظ ذلك وقت المعلم. وبإمكان الذكاء الاصطناعي أن يتحقق مما إذا كان عمل الطالب متسقًا مع أعماله السابقة، ويقدم سجلًا كاملًا يوضح طريقة استخدام الطالب للذكاء الاصطناعي.
كما قد يعطي الذكاء الاصطناعي المعلم رؤى لم ينتبه لها من قبل حول الفصل بأكمله، كأن يخبره أن 15 طالبًا لديهم مشكلة مع صياغة بيان الأطروحة، ويضع خطة دراسية لمساعدة أولئك الطلاب.
هذا سيدعم الطلاب بدرجة لم نشهدها من قبل وسيعطيهم ملاحظات أسرع وسيوفر وقت المعلم. تخيل أن تكون معلمًا للمرحلة المتوسطة وعليك أن تصحح مئة ورقة عن غاتسبي العظيم خلال عطلة نهاية الأسبوع. الأمر ليس ممتعًا، وقد لا تتمكن من تصحيح جميع الأوراق بنفس الدقة، لكن الآن توفر الدعم مع فرصة الحصول رؤى قيمة حول عملية التصحيح.
كان الغش موجودًا قبل ظهور chat GPT، فهناك على الإنترنت من يكتبون أي مقالة مقابل خمسة دولارات للصفحة. لكن هذه الأداة يمكن فعلًا أن تقوّض جميع أنواع الغش، بما في ذلك دفع المال لشخص على الإنترنت أو استعانة الطالب بأخته الكبرى لكتابة المقال نيابةً عنه. وأهم ما في الأمر أن الذكاء الاصطناعي يقدم دعمًا فوريًا للطلاب، مما يوفر للمعلمين رؤى أعمق حول أداء طلابهم.
- ما زال الأطفال بحاجة إلى تعلم الكثير
كلما ظهرت تقنية جديدة ادّعى البعض أن الأطفال لم يعودوا بحاجة إلى تعلم المهارات المرتبطة بهذه التقنية، فمثلًا عندما ظهرت الآلة الحاسبة قيل إنه لا حاجة لأن يتعلم الأطفال الحساب. وقد يرى البعض أنه لا يلزم أن يتعلم الأطفال بعض الأمور بما أنهم يستطيعون البحث عن المعلومات على الإنترنت.
لكني لم أومن بهذا يومًا. إن كنتَ جيدًا في الحساب فستُحسن استخدام الآلة الحاسبة، وستأتي أوقات لا تتوفر معك آلة حاسبة، كما أن معرفة الحساب تساعد على الربط بين المفاهيم.
إن كنت مثقفًا في موضوع معين أو لديك معرفة عامة، فستكون مستخدمًا مُنتجًا لأشياء مثل محرك البحث. والشيء نفسه ينطبق الآن على الذكاء الاصطناعي التوليدي، فامتلاك المعرفة والمهارات يعينك على حُسن استخدامها. إن كنت طالبًا أو إن كان لديك أبناء، فهل تود أن يتفوق عليك الذكاء الاصطناعي أم أن تكون قادرًا على دمج هذه الإمكانيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي بفعالية؟
يستطيع الذكاء الاصطناعي كتابة التعليمات البرمجية، لكن إنشاء تطبيقات متميزة بحق يتطلب معرفة ما تستلزمه التعليمات البرمجية عالية الجودة والقدرة على دمجها معًا. وحتى تحقق ذلك لا بد أن تكون مماثلًا للذكاء الاصطناعي أو على الأقل قادرًا على مواكبته. والشيء نفسه ينطبق على الكتابة أو تأليف الموسيقى أو التحرير، فأولئك الذين يتقنون هذه المهارات، إلى جانب المهارات اللازمة لدمجها مع مكونات الذكاء الاصطناعي، هم الذين سيتألقون في سوق العمل في المستقبل، أما مَن يغلبهم الذكاء الاصطناعي -أولئك الذين يعتمدون عليه لكن لا يعرفون كيفية توظيفه للخروج بنتائج عظيمة- فسيقعون في مأزق.
- الذكاء الاصطناعي أداة محايدة
لا يخلو اجتماع على العشاء الآن من الحديث عن فلسفة الذكاء الاصطناعي، حيث يناقش الناس أضراره المحتملة كالمعلومات المضللة والتزييف العميق والاحتيال.
لكن ما المجالات التي يمكن أن يحقق فيها نتائج إيجابية؟ ربما سيفيد في مجال الرعاية الصحية أو التعليم. أؤكد دائمًا أن الأمر ليس وليد الصدفة، هذه التقنية تعزز الهدف البشريمثل التقنيات السابقة، لكن الذكاء الاصطناعي قد يتميز ببعض الخصوصية مقارنة بالتقنيات التي سبقته لأنه يلامس شيئًا طالما اعتقدنا أنه يخص البشر: الذكاء.
لكن بما أنه يعزز الهدف البشري، فإن ما يهم هو هدفنا. نحن نعلم أنه توجد جهات فاعلة سيئة ذات أهداف سلبية، وأنهم سيبذلون جهدًا بالغة لتحقيق تلك الأهداف الخبيثة، وبالتالي من الضروري أن نبذل جميعًا أقصى جهد ممكن في سبيل الأهداف الإيجابية.
إن مجرد استخدام شرار الناس الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة ليس سببًا للفرار منه، وليس سببًا لإبطاء الجهود الإيجابية المبذولة. الجهات الفاعلة لا تتوانى. علينا جميعًا أن نتعلم أكبر قدر ممكن عنه، وأن نعرّض أنفسنا له، وأن نستخدمه بذكاء لتمكين الآخرين. الفرصة قائمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الذكاء البشري، والإمكانات البشرية، والمعنى الإنساني.
التعليم والذكاء الاصطناعي: مراجعة لكتاب كلمات جديدة شجاعة لسلمان خان. قراءة المزيد »