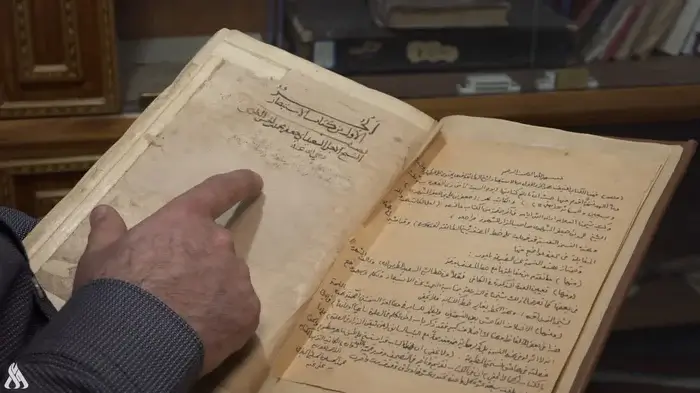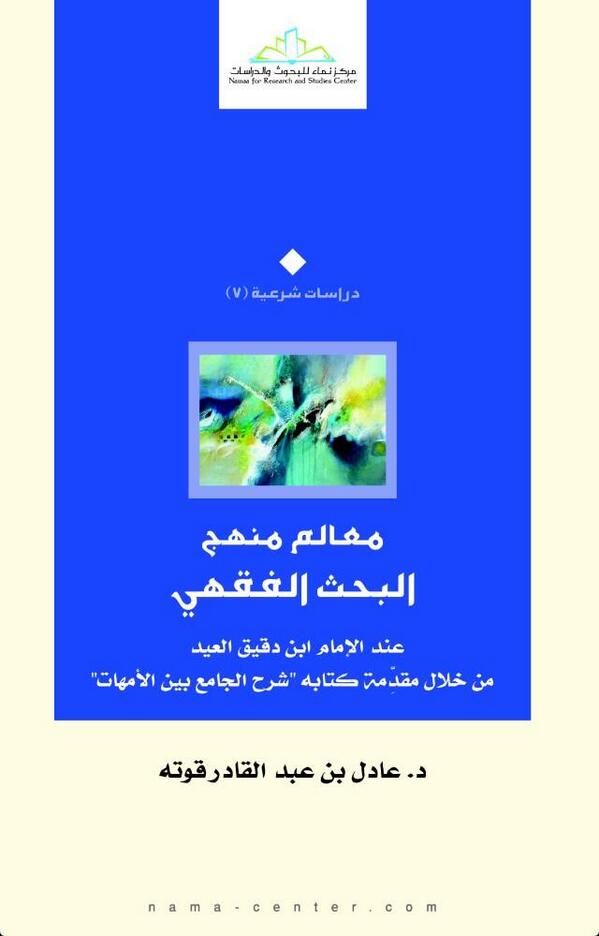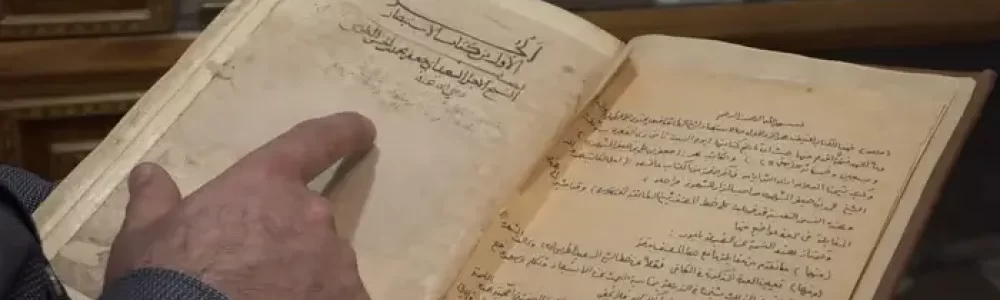في مختصرات النحو ومُتُونه
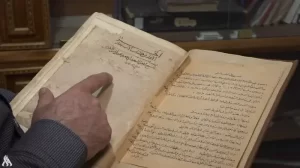
دكتوراه من قسم اللغويات بالجامعة الإسلامية بالمدينة، ومعلم سابق لعلوم العربية بمعهد المسجد النبوي
- تاريخ النشر |
– ننشر هذه المقالة ضمن برامج مبادرة إرث المتخصصة في تاريخ العلوم التراثية –
لعلَّ «عِلْمَ النَّحْوِ» أقدَمُ العلوم الإسلامية تصنيفًا وتأليفًا، وتكاد تُجْمِعُ الروايات العتيقة على أنَّ أبا الأسود الدؤليَّ أوَّلُ «من أَسَّسَ الْعَرَبيَّةَ وَفَتَحَ بَابَهَا وَأَنْهَجَ سَبِيلَهَا وَوضَعَ قِيَاسَهَا»[1]، من عِنْدِهِ أو بأمرٍ من عليِّ بْنِ أبي طالبٍ أو عُمَرَ بنِ الخطَّابِ أو حَثٍّ من ابن عباس رضي الله عنهم أو حضٍّ من زياد بن أبيه[2]، والأكثرون على أنَّ ذلك في عهدِ عليٍّ رضي الله عنه، والزَّمانُ إذ ذاك غضّ، والناسُ لم يبلُغُوا بَعْدُ سنة أربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وقد كان من سِمَات التأليف فيه: وَضْعُ المختصرات والمُتُونِ الجامِعَة، و«الاختصار» تَرْكُ فُضُولِ الكَلام واستِيجازُ معانيه أو أخْذُ أوسَاطِه وتَرْكُ شُعَبِه[3]، ثم درج المتأخرون بعد المئة الثامنة -تقريبًا- على تسميتها «مُتُونًا» وتلقيب الْمُخْتَصِر بـ«الماتِنِ»[4]، و«المتن» في العربية القُدْمى: ما اشتدَّ من الأرض وارتَفَع، وفي ظَهْرِ الإنسان مُكْتَنَفُ صُلْبَهِ -لَحْمًا وعَصَبًا- يَمِينًا وشِمَالًا، وفي السَّهْمِ ما بين رِيشِه وَوَسَطِه، فالجامِعُ لمعانيه: الصَّلَابة[5].
واستعمَلَ لفظَ «المتن» -قبلَ ذلك بزمان- عُلَماءُ الحديث[6]، حين نظروا فيه «سنَدًا ومَتْنًا»، فالأول الطريقُ الموصل إليه، والثاني ما انتهى إليه الإسناد من الكلام، فكأنَّهم شبَّهُوه بمتن الأرض، فهو أعلى ما في الرِّوَايَة وأَجْلَاه، ولعلَّ المتأخِّرين استعاروا هذه الدلالة منهم لـ«المختصرات»، ونزَّلُوها منزلة الرواية، إذ هي غايةُ المتعلم، أو أنَّه غلب -على المختصرات- الروايةُ بالإسناد المتصل عن صاحبها، مع إيجازها وحُسْنِ سَبْكِها، فكان الشَّبَهُ بينهما.
والطبيعيُّ في نَشَاءَةِ العلوم أن تبتدئَ كُتُبُهَا مختصرَةً فمتوسِّطَةً فمُطَوَّلة، ثم يعود الناسُ للاختصار الجامعِ مقاصد المطوَّلات، وهذا ما نلْمَحُه من رواية أبي بكر الأنباري (328هـ) لقصة أبي الأسودِ في نقط المصحف، حين قال في آخرها: «فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره، ثم وضع (المختصر) المنسوب إليه بعد ذلك»[7]، والناسُ مختلفُون في المختصَر أهو للنَّحْوِ أم للنقط.
وأقدَمُ ما بينَ يدينا اليوم في النَّحْو كتابُ سيبويه (180هـ)، إمام النحويين ورئيسهم، وهو سِفْرٌ من أعظَمِ أسفار الدُّنْيا، بيد أنَّ حاجاتِ أهل كُلِّ زمانٍ مختلفة، فأنشأ الناسُ يصنفون على ما يُشَاكِلُهم.
وكثيرٌ من الباحثين -اليوم- لا يحضُرُه من كُتُبِ النَّحْوِ سوى تصانيف المتأخرين، كألفية ابن مالك (672هـ) والآجرومية وكُتُبِ ابن هشام (761هـ)، مع أن مختصرات النَّحْوِ الجامعة أقدم من كلِّ هذه، وقد عُرِفَتْ في زمانٍ لم يضَعْ أهْلُه ما يُماثِلُها -في العلوم الأخرى- افتنانًا وإيجازًا، وأُحِبُّ أن أَلْفِتَ نَظَرَك -في هذه الكلمة- إلى أهمِّ ما وصلَ إلينا مطبوعًا منها -من القرن الثاني حتى أواخر العاشر الهجري-، وبعضُها كان نَدِيَّ النحويين ومحتَشَدَ تصانيفهم وأقاويلهم ومذاهبهم، وهي بابُ ما وراءَها من المطوَّلات، وهذه المختصرات منها ما ضمَّ في تضاعيفِه أبوابَ عِلْمِ النَّحو وحدَه -بمعناه المتأخر المعنيِّ بأحوال اللفظ المركب-، ومنها ما زاد مسائلَ من التصريف المعنوي كـ«المصادر والجُمُوعِ والتصغير والنَّسَب»، ومنها ما زادَ مسائلَ من التصريف اللفظي كـ«الإعلال والإبدال والإمالة»، ومنها ما زاد مسائل «الخطِّ والكتابة»، أي «الإملاء» باللفظ المعاصر، ومن هذه المختصرات ما صحَّتْ نسبِتُه إلى زَمَانِه ومؤلِّفه، ومنها ما نُحِلَ عليه، أو تنازَعه النقيضان، وهي درجات في الحجم وسَعَةِ الحديث، فمنها ما خُوطِبَ به المبتدئون، ومنها ما خُوطِبَ به المتوسِّطون، ومنها ما خُوطِبَ به المُنْتَهُون، وإن كان المنتهي منتفعًا بما خُوطِبَ به المبتدئ، ليكون تذكرَة له.
وضابِطُ ما سأوردُه منها هنا: أن يكون مُسَمًّى بما يفيد الاختصار أو التَّقْدمة، أو مُضَمَّنًا ذلك، أو قائمًا على الإيجاز، أو مبنيًّا على عرضِ جُلِّ المسائل مجرَّدة عن شواهِدها وعِلَلِها، ولم يتجاوز حدَّ التوسُّط، أو هو مما تناوله العلماءُ بالشَّرْحِ والإبانة.
ومن المختصرات ما كانَ في أبوابٍ نحويَّةٍ خاصَّة، وقد تَكُون أقربَ إلى علم متن اللغَةِ من النَّحو كالمصنفات في حروف المعاني أو الجُمَل أو قواعد الإعراب، وذلك مما لن أُعَرِّجَ عليه هنا، إذ الغرضُ ما صُنِّفَ في جُلِّ مسائل النَّحْو وما لَحِقها في كُتُبهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] من لفظ ابن سَلَّامٍ الجُمَحِيّ (232هـ). طبقات فحول الشعراء: 1/12.
[2] ينظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: 27-32، ومراحل تطور الدرس النحوي: 57 (فما بعدها).
[3] ينظر: مقاييس اللغة: 2/189 (خ ص ر).
[4] يقول الأستاذ سعيد الأفغاني (1417هـ): «(المتون) في العلوم: اصطلاح جرى عليه المعلمون، يطلقونه على مبادئ فن من الفنون، تُكَثَّفُ في رسائلَ قصيرةٍ يستظهرُها للطلاب، ترسيخا لمسائل العلم في حفظهم… ثم يشرعون بعد استظهار الطلاب لها في شرح ألفاظها وحل معقداتها» من تاريخ النحو: 180.
[5] ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: 6/2200 (م ت ن)، ومقاييس اللغة: 5/294-295 (م ت ن).
[6] ممن استعمل لفظ «المتن» للحديث: الإمام مسلم بن الحجاج (261هـ)، ينظر: التمييز (له): 170، 171.
[7] إيضاح الوقف والابتداء: 41، وأميلُ إلى أنَّه مختصر النقط، وبيانُ هذا يطول، وممن حمله على (النحو) د. غانم قَدُّوري الحمد، ينظر كتابه: علم النَّقْطِ والشكل (التاريخ والأصول): 24 (الحاشية: 2).
في مختصرات النحو ومُتُونه قراءة المزيد »