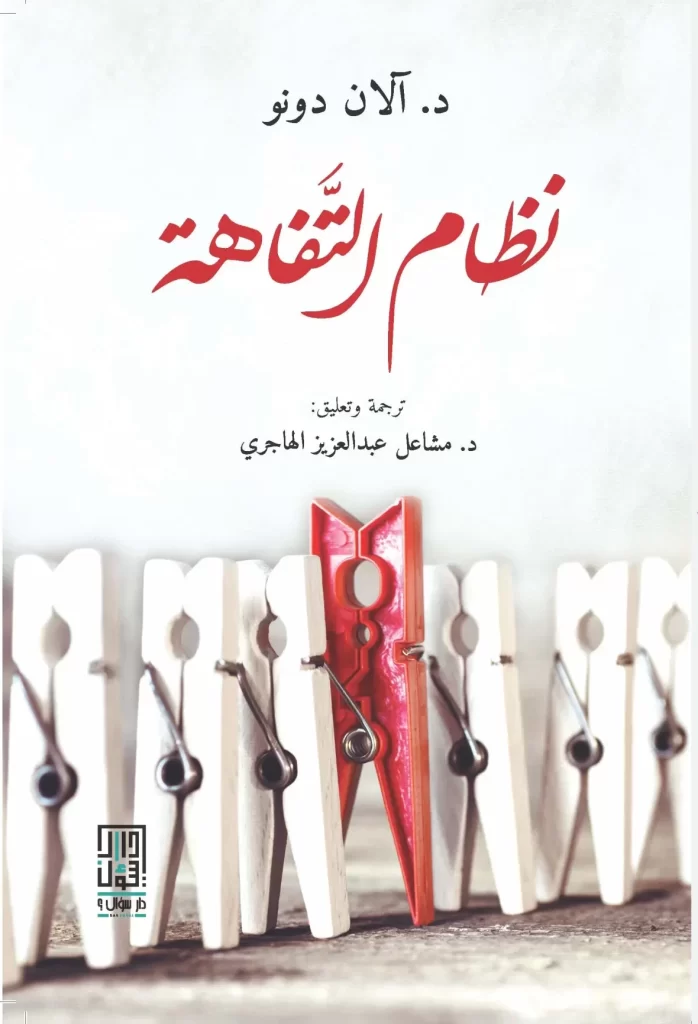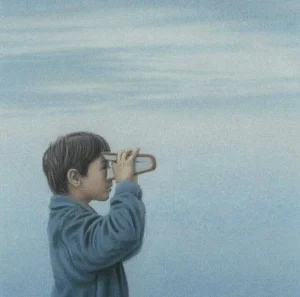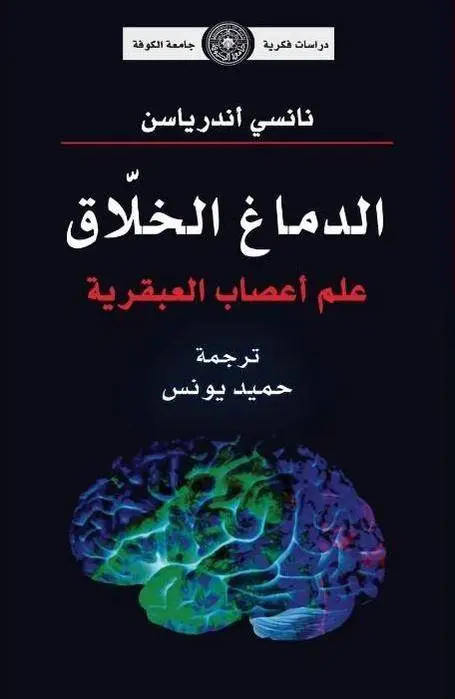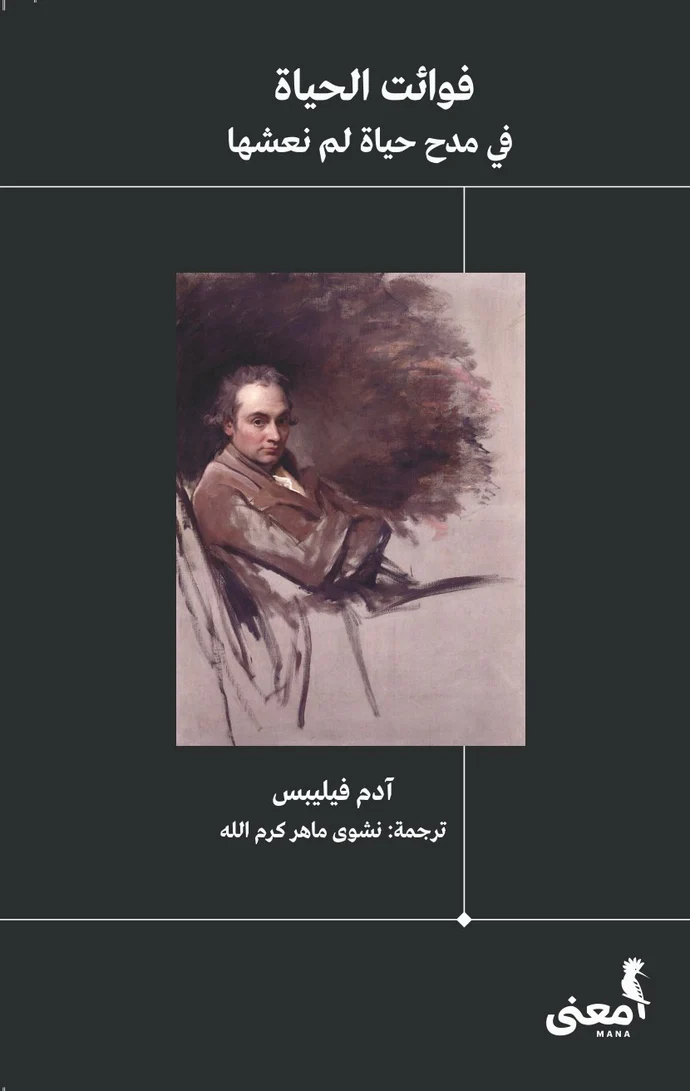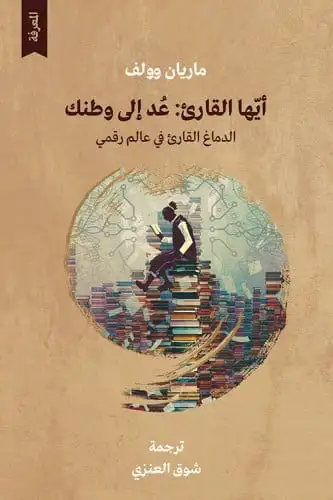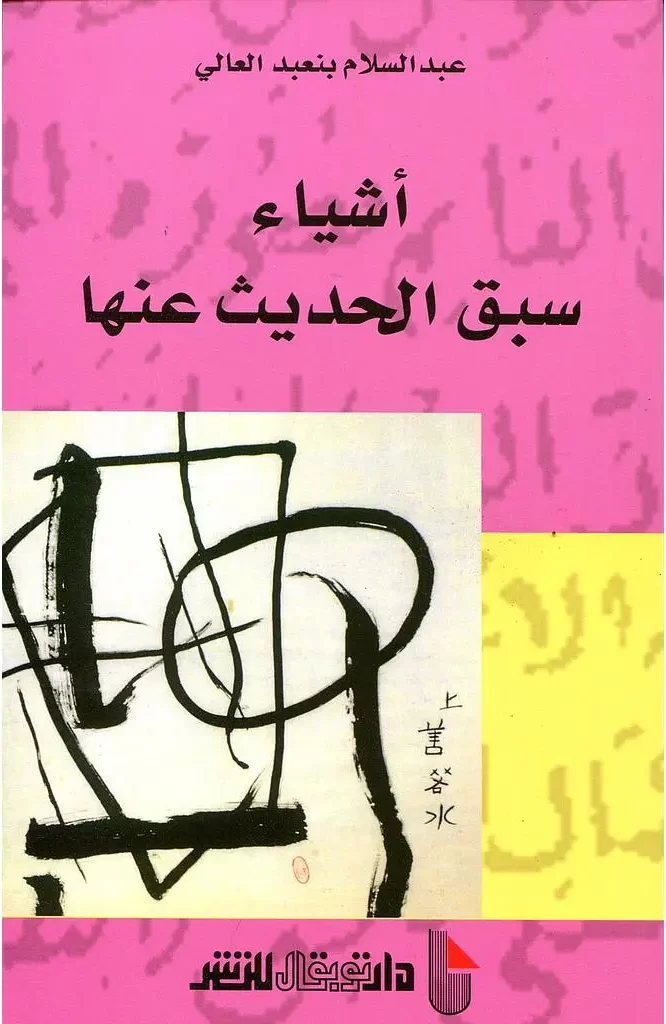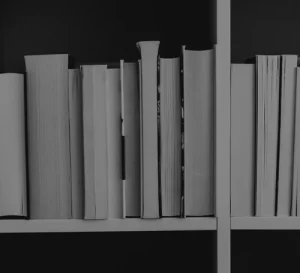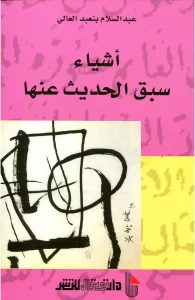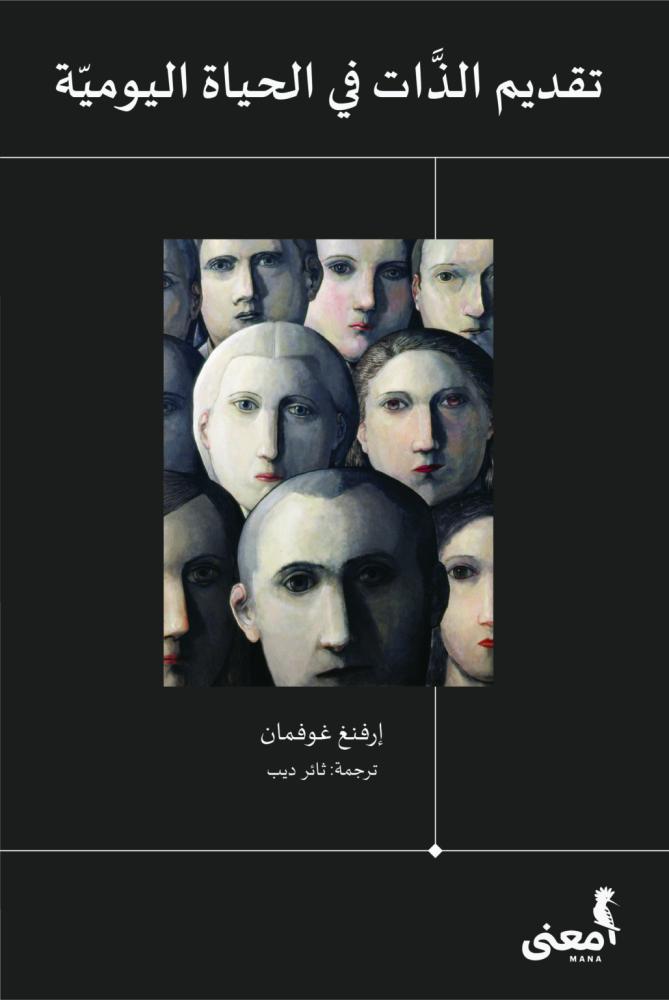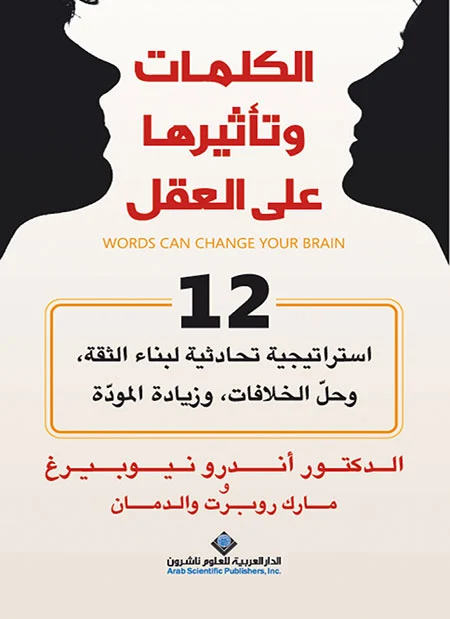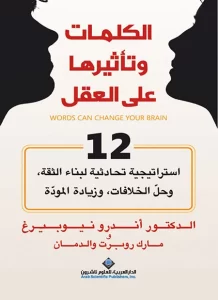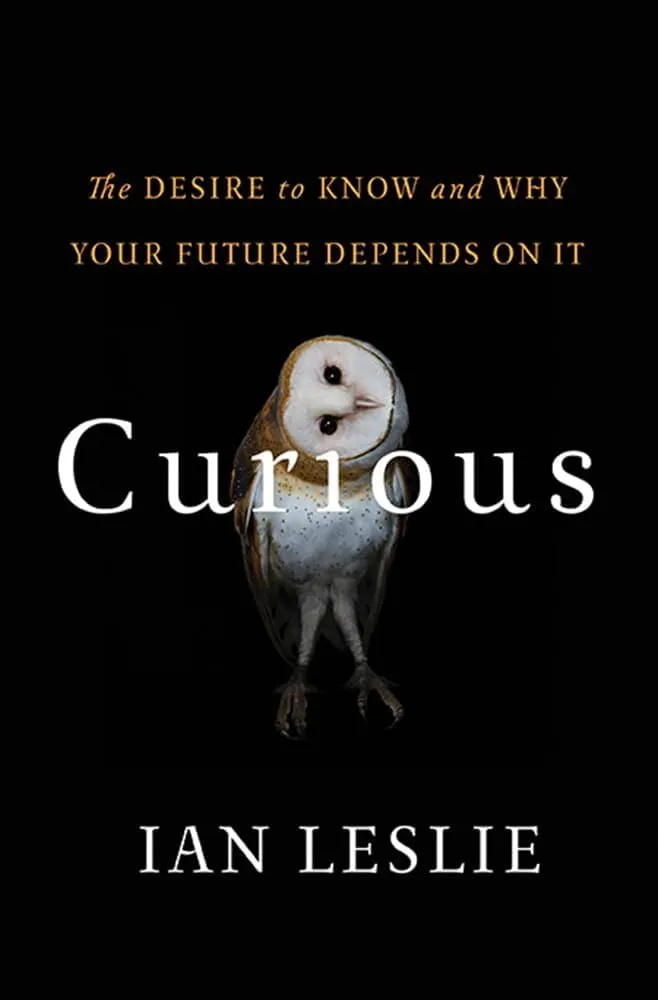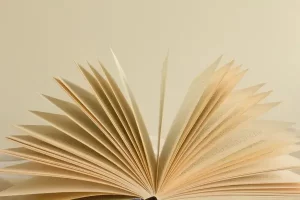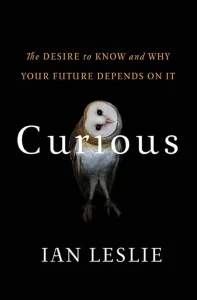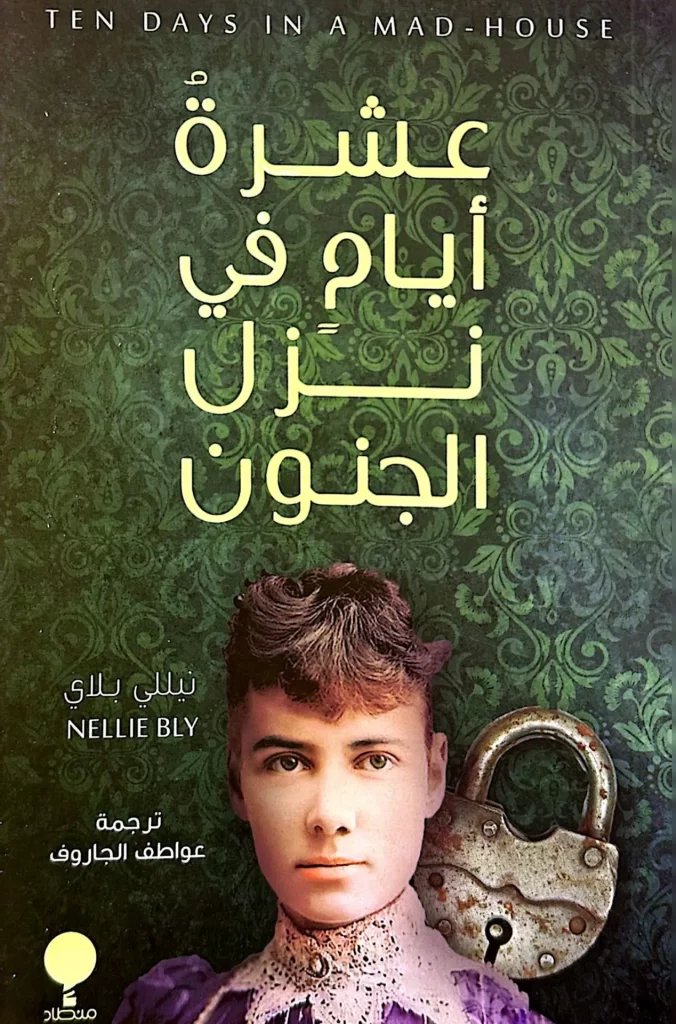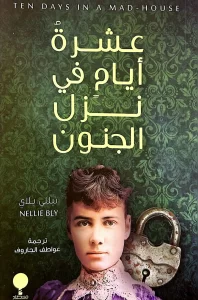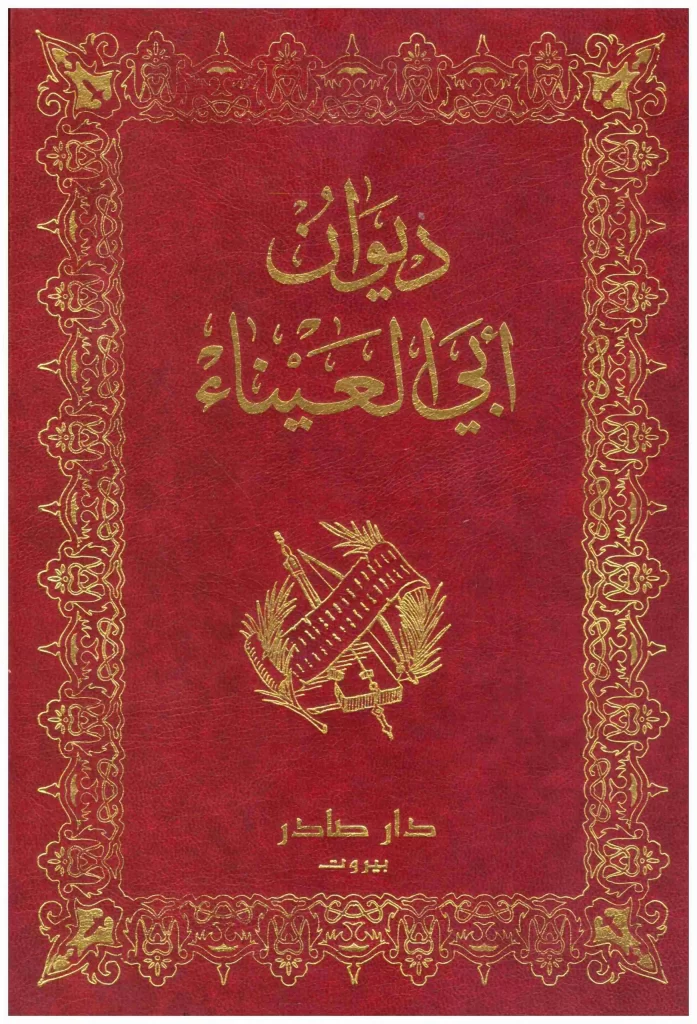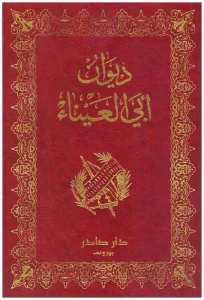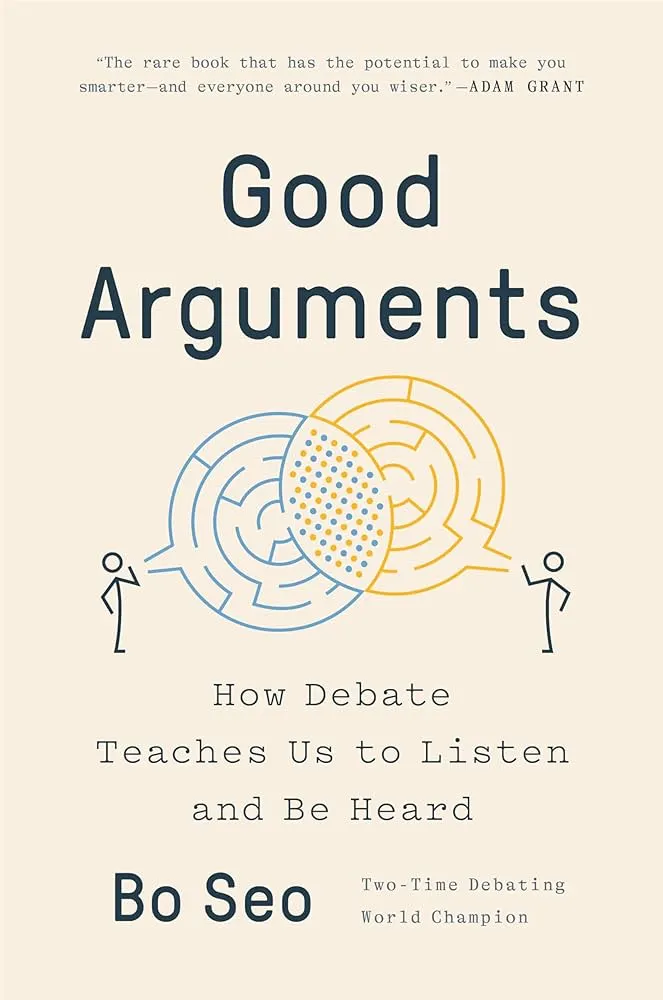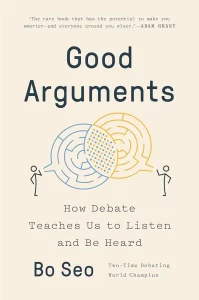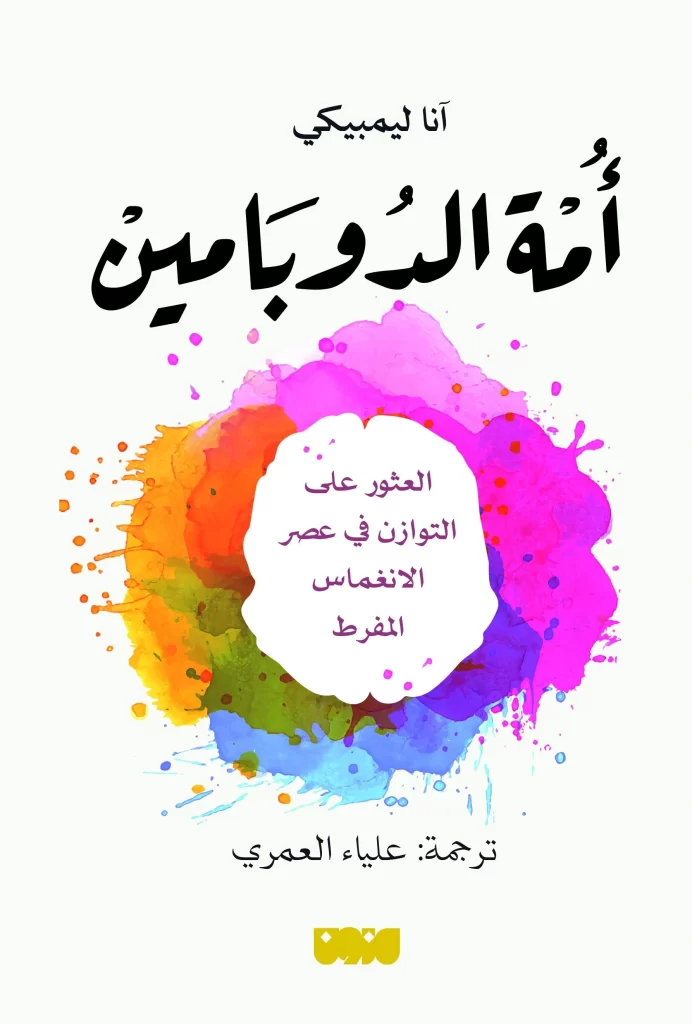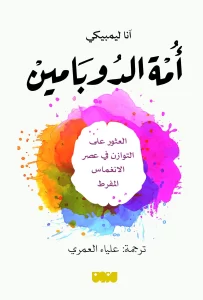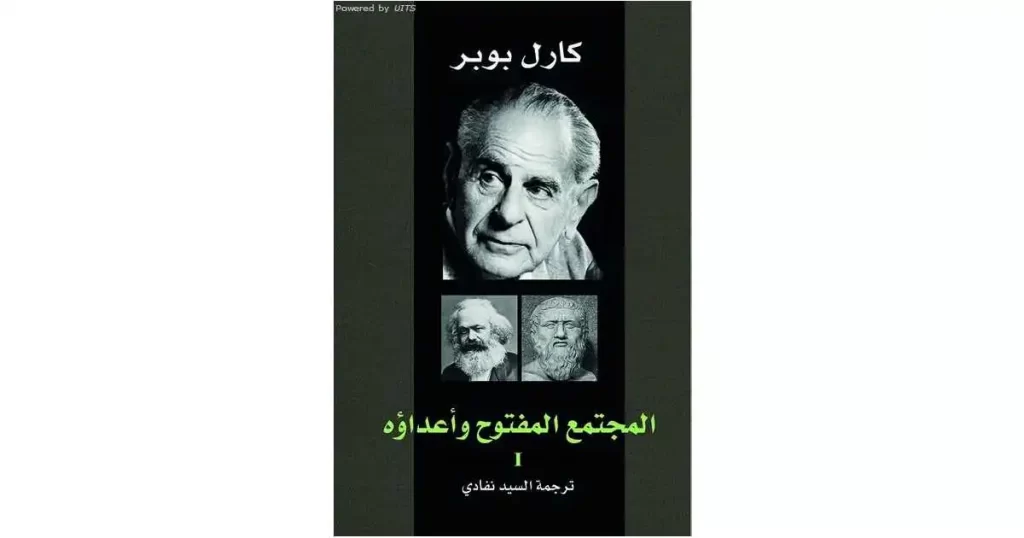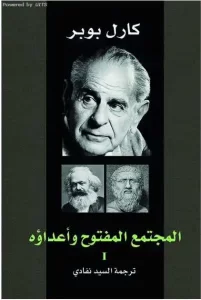أعماق السطحية: مراجعة لكتاب “نظام التفاهة” لآلان دونو
يُعدّ كتاب “نظام التفاهة” للكاتب والمفكر الكندي آلان دونو من الأعمال الفريدة التي تتناول ظاهرة اجتماعية معقدة، تتعلق بكيفية تحول المجتمعات الحديثة إلى نظم تهيمن عليها ثقافة التفاهة. في هذا الكتاب، يوضح دونو أن التفاهة لم تعد مجرد صفة سلبية لأشخاص أو أفعال معينة، بل أصبحت نظامًا متكاملًا يتحكم في مختلف مجالات الحياة، من التعليم والسياسة إلى الاقتصاد والثقافة. إذ تسيطر قيم الامتثال والخضوع على حساب الإبداع والتميز، ويتم تهميش الأفراد الذين يسعون لتغيير هذا الواقع أو التميز فيه.
اعتنى بالكتاب ونقله إلى العربية الدكتورة مشاعل الهاجري مع إثرائها بتعليقات وشرح وافي زاد من فائدة الكتاب المعرفية، وطُبع الكتاب في دار سؤال للنشر وعدد صفحاته 366 صفحة.
يتناول الكاتب تحولات المجتمع بتفصيل دقيق وعميق، ليقدم نقدًا شاملاً للنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحديثة، ويبين كيف أن هذه النظم قد أصبحت تدعم التفاهة وتستبعد أي محاولة للخروج عن الخطوط المرسومة لها. يعتمد دونو على منهج علمي وأدبي في آنٍ واحد لتحليل هذه الظاهرة، وهو ما يجعل الكتاب قراءة ضرورية لكل من يسعى لفهم التحولات العميقة التي يشهدها العالم المعاصر.
الفكرة المحورية: نظام التفاهة
يرى دونو أن التفاهة قد أصبحت نظامًا، ولم تعد مجرد ظاهرة سلوكية فردية. وفقًا له، النظام المعاصر -وخاصةً في الدول الصناعية المتقدمة- أصبح يعتمد على “تسطيح” كل ما يتعلق بالقيم والمعايير المجتمعية. يتم تمكين الأفراد الذين يتماشون مع التيار السائد ولا يتحدون القواعد، بينما يتم تهميش وإقصاء الأفراد الذين يملكون مواهب أو قدرات استثنائية ويرغبون في تحدي هذا النظام.
هذا النظام قائم على تجنب المخاطر وتفضيل الحلول المريحة والسهلة التي لا تتطلب إبداعًا أو اجتهادًا. ويؤدي ذلك إلى إحلال التفاهة في جميع جوانب الحياة: من السياسية إلى الاقتصادية والتعليمية، وحتى في الحياة اليومية للأفراد. ويعزز النظام الرأسمالي هذه الظاهرة من خلال سعيه الدائم لزيادة الاستهلاك، مما يدفع المجتمعات إلى تفضيل الحلول الجاهزة والقوالب الجاهزة على التفكير النقدي أو الإبداع.
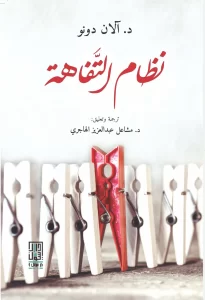
التفاهة في التعليم: إنتاج العمال وليس المفكرين
يشير دونو إلى أن النظام التعليمي الحديث أصبح من أهم المؤسسات التي تخدم نظام التفاهة. التعليم، كما يراه، لم يعد يهدف إلى تحفيز التفكير النقدي أو تطوير الإبداع لدى الأفراد، بل أصبح موجهًا نحو إنتاج عمال أكثر من كونه موجهًا نحو إنتاج مفكرين. الطلاب يتم تدريبهم على قبول ما يُملى عليهم دون التفكير بعمق أو مساءلة الأمور من حولهم.
الهدف الأساسي من التعليم اليوم، وفقًا لدونو، هو إعداد الأفراد للاندماج في سوق العمل والامتثال للقواعد الاقتصادية والسياسية السائدة. يتم تعليم الطلاب المهارات الضرورية للبقاء في النظام وليس المهارات التي تمكنهم من تغييره أو تطويره. وبهذا، يتحول التعليم إلى وسيلة للحفاظ على الوضع الراهن بدلًا من أن يكون أداة لتطوير المجتمع.
كما أن النظام التعليمي يشجع على الامتثال أكثر من تشجيعه على التفكير النقدي. الطلاب يُحَثّون على اتباع المسارات التقليدية وعدم محاولة الخروج عن المألوف أو تقديم أفكار جديدة. وبالتالي، يتم تقويض دور التعليم كأداة لتطوير المجتمع والإبداع الفكري.
التفاهة في السياسة: قادة بلا رؤية
يركز دونو بشكل خاص على المجال السياسي، حيث يرى أن التفاهة قد تمكنت من الاستيلاء على السياسة بشكل كبير. القادة السياسيون اليوم، وفقًا لدونو، ليسوا بالضرورة الأكثر ذكاءً أو خبرةً، بل هم الأكثر قدرةً على التماشي مع النظام القائم. هؤلاء القادة لا يسعون إلى تقديم رؤى جديدة أو إحداث تغيير جذري، بل يهتمون بالمحافظة على مواقعهم في السلطة والبقاء في قلب النظام.
السياسيون في هذا النظام يفضلون استخدام لغة مبسطة وسطحية وسهلة الفهم، حتى لو كانت هذه اللغة تفتقر إلى العمق أو الحقيقة. يتم تقديم الأفكار السياسية كمنتجات استهلاكية يمكن تسويقها بسهولة للجماهير، ويتم تفضيل الشعارات البسيطة التي تلقى قبولًا واسعًا دون الحاجة إلى التفكير أو النقاش.
بالتالي، تحولت السياسة إلى مجال يخدم التفاهة، حيث لا يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة أو الإبداع، بل بناءً على قدرتهم على البقاء ضمن الإطار المحدد لهم. السياسيون الذين يجرؤون على تقديم رؤى جديدة أو تحدي النظام القائم يتم تهميشهم أو حتى استبعادهم.
التفاهة في الإعلام: تسطيح الوعي
وسائل الإعلام لم تسلم من تأثير نظام التفاهة، بل أصبحت أحد أدواته الرئيسية. الإعلام اليوم، كما يصفه دونو، يعتمد على تسطيح الوعي وتقديم محتوى سطحي وسهل الهضم للجماهير. يتم التركيز على الأخبار السريعة والمعلومات الترفيهية التي تجذب الانتباه لفترات قصيرة دون أن تتطلب تفكيرًا عميقًا أو تحليلًا نقديًا.
يُعَد الإعلام أحد العوامل التي تساهم في ترويج ثقافة الاستهلاك السريع للمعلومات دون التحليل أو التعمق. يتم توجيه الجمهور نحو استهلاك الأخبار بشكل متكرر وسريع، مع التركيز على الإثارة والترفيه بدلاً من تقديم معلومات دقيقة أو متعمقة. وبهذا، يتحول الإعلام إلى أداة لترويج التفاهة بدلًا من أن يكون وسيلة لتنوير المجتمع أو تعزيز الوعي العام.
يتم تسليط الضوء على القصص المثيرة أو الغريبة التي تجذب الانتباه بسهولة، في حين يتم تهميش الأخبار الجادة أو المعقدة التي تتطلب تحليلًا أو تفكيرًا نقديًا. وبالتالي، يتحول الإعلام إلى أداة لتغذية ثقافة التفاهة بدلاً من أن يكون وسيلة لتنوير المجتمعات أو تعزيز النقاش العام حول القضايا الهامة.
التفاهة في الاقتصاد: الشركات وقيم الامتثال
الاقتصاد أيضًا ليس بمعزل عن تأثير نظام التفاهة. وفقًا لدونو، الشركات والمؤسسات الاقتصادية اليوم أصبحت تفضل الأفراد الذين يمكن التنبؤ بسلوكهم والذين يتبعون القواعد المحددة دون محاولة تجاوزها أو تحسينها. يتم تشجيع الامتثال والطاعة على حساب الإبداع والتفكير الخلّاق.
في النظام الاقتصادي الحديث، يتم تفضيل الموظفين الذين ينفذون الأوامر دون طرح تساؤلات أو اقتراحات لتحسين النظام. الابتكار والتغيير يتم تهميشهما لأنهما يمثلان تهديدًا للنظام القائم. بل إن النجاح في هذا النظام يعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة الفرد على التماشي مع القواعد المعمول بها دون السعي لتحديها أو تحسينها.
يرى دونو أن هذا النوع من الاقتصاد يعزز نظام التفاهة بشكل كبير لأنه يحد من الإبداع والتميز. الموظفون الذين يحاولون تقديم أفكار جديدة أو الذين يرغبون في تغيير طرق العمل التقليدية يواجهون غالبًا بالرفض أو التهميش. وبهذا، يتم تكريس نظام يفضل الاستقرار والجمود على الابتكار والتطور.
التفاهة في الثقافة: الترفيه السطحي بدلاً من الفن
الثقافة بدورها لم تسلم من تأثير نظام التفاهة. يشير دونو إلى أن الإنتاج الثقافي في المجتمعات الحديثة أصبح موجهًا نحو الترفيه السريع والسطحي بدلاً من تقديم أعمال فنية ذات قيمة فكرية أو جمالية. الأفلام والمسلسلات والأغاني أصبحت تعتمد بشكل كبير على جذب الجمهور بأبسط الطرق الممكنة، دون إيلاء أهمية للجودة أو المضمون.
الثقافة أصبحت تركز بشكل أساسي على تسويق المنتجات الثقافية كمجرد سلع استهلاكية سريعة الزوال. يتم تقديم الأفلام والمسلسلات الموسيقية والمسرحيات وغيرها من المنتجات الثقافية بطريقة تجعلها سهلة الاستهلاك، دون أن تتطلب تفكيرًا عميقًا أو نقدًا فنيًا. وبهذا، يتحول الفن إلى مجرد وسيلة لجذب الجمهور بدلاً من أن يكون وسيلة لتحفيز التفكير أو التعبير عن الأفكار المعقدة.
كما أن دور المثقفين في المجتمع قد تقلص إلى حد كبير. المثقفون، الذين كان يُفترض أن يكونوا قادة الرأي وصناع الثقافة، تم تهميشهم أو تحييدهم لصالح فنانين أو مشاهير يمكن استهلاك منتجاتهم بسهولة. وبهذا، تتحول الثقافة إلى منتج سطحي، يمكن استهلاكه بسرعة دون أن يترك أثرًا دائمًا.
نقد المجتمع: تجديد الروح النقدية
في نهاية الكتاب، يدعو دونو إلى إحياء الروح النقدية في المجتمعات. يعتقد أن الحلول لا تكمن في المؤسسات القائمة، بل يجب أن تبدأ من الأفراد الذين يتحلون بالشجاعة للتفكير خارج الأطر المحددة لهم. النظام الحالي يعتمد على الامتثال، ومن ثم فإن أي محاولة لتحديه يجب أن تبدأ بالتحرر من هذه القيود.
يرى دونو أن الأفراد يجب أن يتحدوا النظام الذي يعزز التفاهة عن طريق تطوير قدراتهم النقدية والإبداعية. يمكن للإنسان أن يرفض الاستسلام لهذا النظام إذا اختار التفكير النقدي والبحث عن حلول جديدة للمشاكل التي تواجهه.
أعماق السطحية: مراجعة لكتاب “نظام التفاهة” لآلان دونو قراءة المزيد »