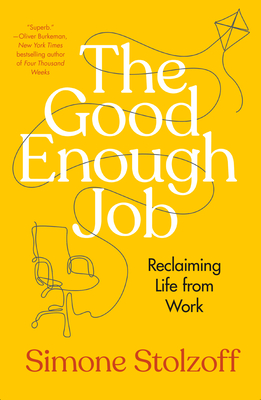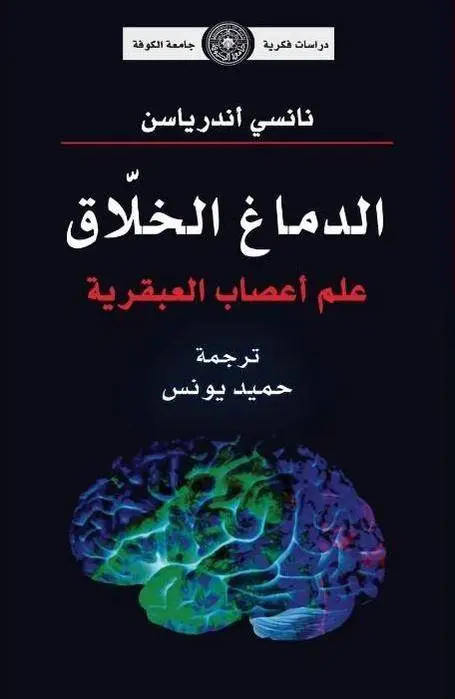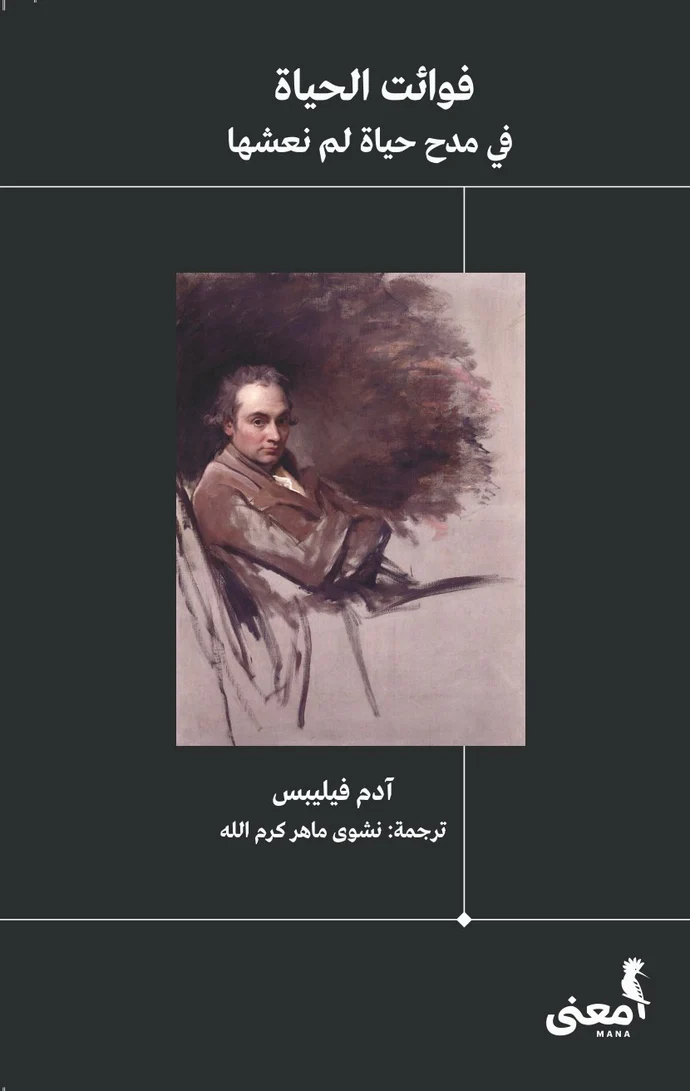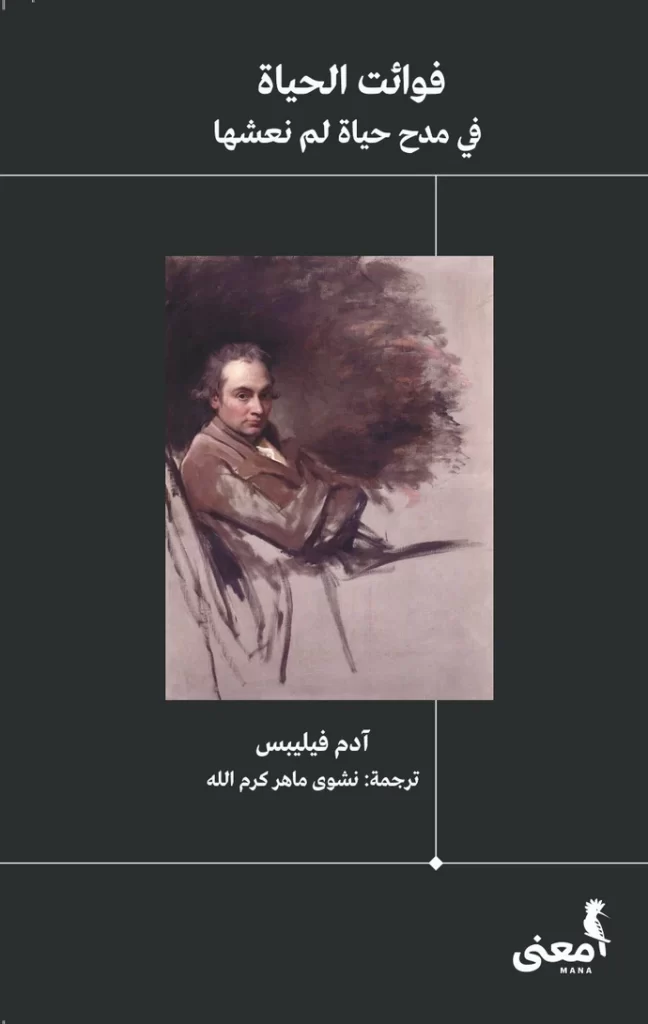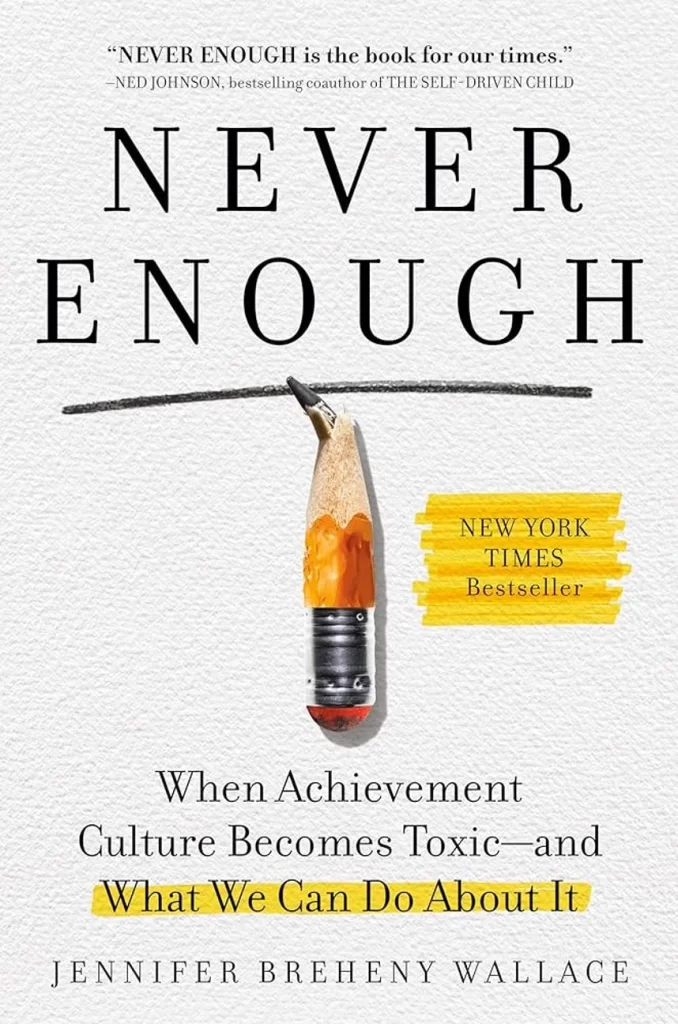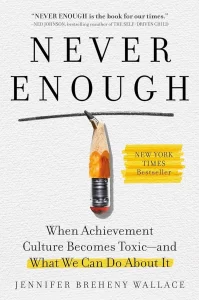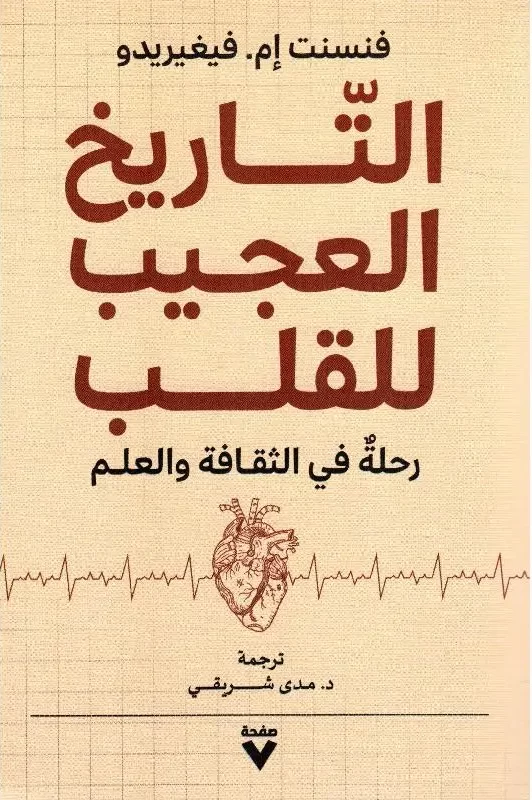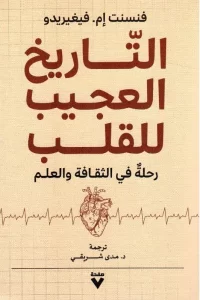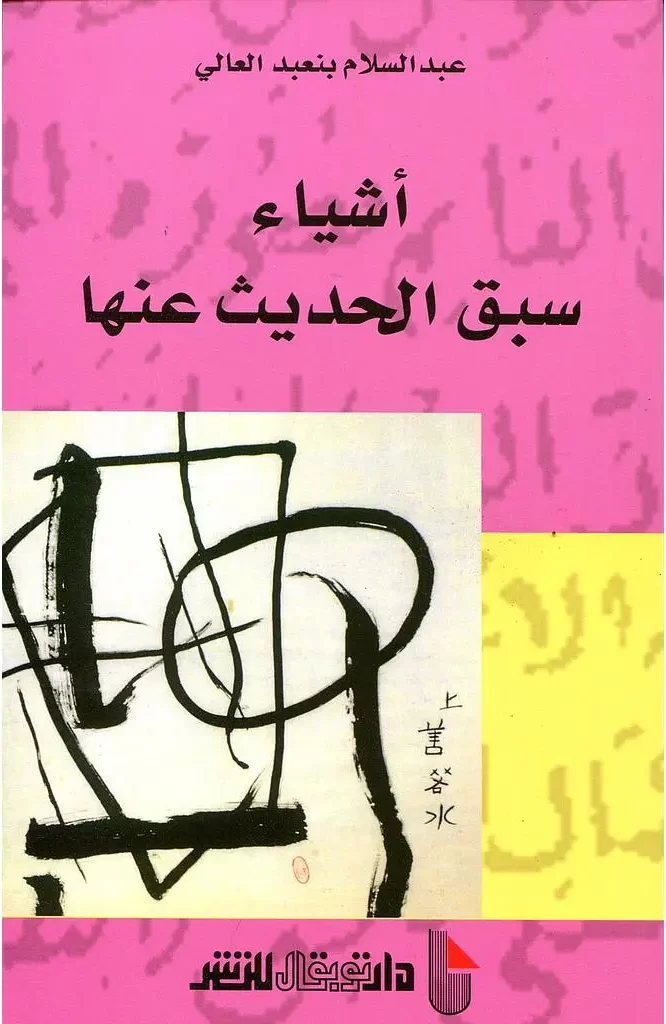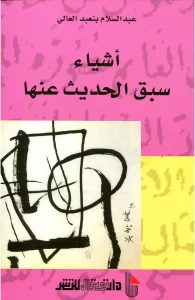خدعة الشغف: مراجعة لكتاب الوظيفة المُرضية
“الوظيفة المُرضية: استرداد حياةٍ سلبها العمل”، كتابٌ يسلط الضوء على أسطورة أنّ قيمتنا مرتبطة بحياتنا المهنية. رغم تركيز الكتاب على ثقافة العمل في الولايات المتحدة، فإني موقنة بأن هذه الظاهرة شائعة في جميع أنحاء العالم، وأنّ رسالة الكتاب عالمية. يروي سيمون ستولزوف في كل فصل قصصًا من قطاعات مختلفة، مما يجعل الكتاب مناسبًا للقراء من مختلف الخلفيات، ويشجع على التأمل في علاقة الفرد بالعمل. يوصي المؤلف باستخدام الكتاب كأداة للتأمل، حتى تدرك أن هويتك تتجاوز عملك الذي تكسب به قوت يومك.
أرى أن الكتاب سيلقى قبولًا لدى أولئك الذين ينعمون بالامتياز والأمن المالي الذي يسمح لهم باختيار وظائفهم وتحديد معنى الرضا بالنسبة لهم، أما من يعيش على الكفاف فقد يصعب عليهم تطبيق أفكار الكتاب. يتناول ستولزوف هذه القضايا النظامية ويختتم ببعض التوصيات: على الحكومات أن تفصل بين البقاء والعمل، وعلى الشركات أن تهتم بأمر موظفيها بصدق، وعلى الأفراد أن يحددوا معنى الرضا بأنفسهم.
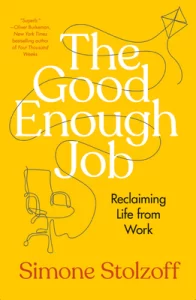
الملخص
كل إنسان مشغول في ظل هذا العالم المعولم. جميعنا محاصرون في نظام رأسمالي يتجاوز الاقتصاد، بل هو اعتقاد اجتماعي أيضًا. هذا الاعتقاد يخبرنا أنّ قيمتنا مرتبطة بقدر ما ننتج، فصارت الإنتاجية تُرى فضيلة أخلاقية، وليست مجرد مقياس.
لماذا نعمل كثيرًا؟
- العوامل الاقتصادية: الأجور الراكدة تجبر كثيرًا من الناس على العمل ساعات أطول من أجل توفير الاحتياجات الأساسية فحسب.
- العوامل النظامية: يفتقر الكثير إلى قوة المساومة الاجتماعية للمطالبة بتحسين ظروف العمل.
- العوامل الأيديولوجية: كانت الرأسمالية متأصلة بعمق في ثقافتنا، إلا أننا شهدنا تحولًا ثقافيًا كبيرًا في العقود الأخيرة، حتى صار يُتوقع الآن أنّ العمل وسيلة لتحقيق الذات والشعور بالمعنى. وبهذا الاعتقاد الجديد أصبح العمل انعكاسًا لشغفنا وهويتنا.
توقع أن العمل سيكون مُرضيًا دائمًا قد يفضي إلى المعاناة
أثبتت الدراسات أن “الشغف المفرط” بالعمل يؤدي غالبًا إلى ارتفاع معدلات الإرهاق والضغوط المرتبطة بالعمل. أضف إلى ذلك أن أنماط الحياة المتمركزة حول العمل في دول مثل اليابان تساهم بشكل كبير في انخفاض معدلات الخصوبة. كما أن التوقعات المبالغ فيها عن النجاح المهني مرتبطة بارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق. ومما ينذر بالخطر أن العدد السنوي للوفيات الناتجة عن المشكلات المرتبطة بالعمل الزائد أكبر من عدد الوفيات الناتجة عن الملاريا.
“سيظل العمل هو نفسه العمل. بعض الناس يعملون فيما يحبونه، وبعضهم يعمل ليتسنّى لهم ممارسة ما يحبونه في أوقات فراغهم، وكلا الغرضين شريف.”
أنيس مججاني
وبعيدًا عن الأبحاث: نحن نعلم بديهيًا أن التوقعات العالية للغاية تؤدي غالبًا إلى خيبة الأمل. عندما نتوقع أن العمل هو سبيل تحقيق الذات، فسنرى كل ما هو دون ذلك فشلًا. وظائفنا ليست بيدنا دائمًا، وربط قيمتنا الذاتية بحياتنا المهنية نهج محفوف بالمخاطر.
ربط الحياة المهنية بالهوية
تشير الأبحاث النفسية إلى أننا نُحسن التعامل مع الصدمات عندما نطور جوانب مختلفة من أنفسنا. إن تركنا جانبًا واحدًا من هويتنا يهيمن على شعورنا بالذات، فستقل قدرتنا على التأقلم مع التغيير. على سبيل المثال، الأشخاص ذوو الاهتمامات المتنوعة أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب أو الأمراض الجسدية بعد المرور بحدث مرهق.
عندما ترتبط هويتك بشيء واحد، مثل وظيفتك أو ثروتك أو نجاحك كأب، فإن أي مشكلة في هذا الجانب يمكن أن تضر باحترامك لذاتك بشدة. فقدان هويتك المهنية قد يكون صدمةً كبرى، خاصة إن لم تبذل وقتًا لتطوير جوانب أخرى ذات معنى في حياتك.
نحن أكثر من مجرد وظائفنا، نحن أشقّاء وأصدقاء وهواة وجيران. وتحتاج هوياتنا، مثل النباتات، إلى وقت ورعاية حتى تنمو، وإن لم نرعَها قد تذبل. غالبًا ما يكون أصحاب الهوايات والاهتمامات المتنوعة خارج العمل أكثر إنتاجيةً في وظائفهم.
إعادة النظر في وظائف الأحلام
- نحن نعزز مفهوم وظيفة الأحلام ونجعله الهدف النهائي في الحياة منذ اللحظة التي نسأل فيها الطفل: ماذا تريد أن “تكون” عندما تكبر؟
- النصيحة الشائعة بأن تتبع شغفك قد تكون مضلّلة أو مؤذية حتى. بالنسبة لأولئك الذين يحبون عملهم: توقع أن هذه الوظيفة ستظل وظيفة الأحلام دائمًا يجعلهم عرضة لخيبة.
- الوظيفة علاقة اقتصادية في المقام الأول.
عملك لا يساوي قيمتك
تقول عالمة النفس جانا كورتز إنه ينبغي أن نستكشف هُويات مختلفة ونستثمر بجد في أنشطة خارج العمل حتى نبني شعورًا أقوى بالذات. بعبارة أبسط: حتى نفهم مَن نحن خارج إطار وظائفنا، ينبغي أن نقوم بأنشطة غير مرتبطة بالعمل.
الهوايات التي تركز على هدف، مثل التدريب لسباق الماراثون أو تحديد هدف قرائي للعام، قد تحفزنا للقيام بأنشطة خارج العمل، لكنها ما زالت تنطوي على شعور بالإنجاز، وهو ما يجعلها تبدو شبيهة بالعمل. هذا لا يعني أنّ هذه الهوايات ضارة، لكنها قد تُنسينا متعة اللعب التي عرفناها في الصغر.
يعد اللعب علاجًا طبيعيًا للهوس بالعمل، فهو يركز على الفضول والدهشة بدلًا من المنفعة أو التحسن، ويساعدنا على عيش اللحظة، ويذكّرنا بأننا أكثر من مجرد موظفين.
المكانة لا تعادل النجاح
عندما نقول إن شخصًا ما ناجح فنحن نقصد غالبًا أنه يكسب مالًا كثيرًا، لا أنه سعيد ومُعافى. نحن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي الآن منابرَ لإظهار إنجازاتنا. قد تلهمنا الجوائز والتقديرات لتحقيق أهدافنا، إلا أننا نفقد استقلاليتنا باعتماد تعريفات غيرنا للنجاح. فبدلًا من أن ننشئ فكرتنا الخاصة للنجاح، نقبل فكرة موضوعة مسبقًا.
إن اختيار مهنة بناءً على الرغبات الشخصية فحسب، دون النظر إلى متطلبات السوق، يُحتمل أن يؤدي إلى نفقات تعليمية باهظة ثم قد لا تحظى بفرصة عمل جيدة. الفنانون -على سبيل المثال- قد يجدون صعوبة في التركيز على فنهم بسبب القلق المستمر إزاء دفع الإيجار. ومن الجهة الأخرى، اختيار مهنة بناءً على متطلبات السوق فحسب، دون النظر إلى الشغف الشخصي، قد يؤدي إلى سلوك طريق لم يرغب فيه المرء أبدًا. حتى وإن كنت تحب ما تفعله، فإن الضغط من أجل التقدم في حياتك المهنية قد يطغى على المتعة التي جذبتك إليها في المقام الأول.
الحل هو أن تضع تعريفًا شخصيًا للنجاح يوازن بين قيمك ومتطلبات السوق. كما قال عالم اللاهوت فريدريك بوخنر: ابحث عن “النقطة التي تتلاقى فيها متعتك العميقة وأشد احتياجات العالم”.
مشكلة العمل الزائد لا تخضع لسيطرتنا وحدنا
العمل الزائد مشكلة نظامية تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية، مما يصعّب معالجتها فرديًا.
كما أن الحلول النظامية لها حدودها. على سبيل المثال، سياسات العطلات السخية والمزايا الصحية للموظفين لا تحدث فرقًا كبيرًا إن استمر المديرون في فرض أعباء عمل ثقيلة على الموظفين.
وعلى المستوى السياسي، الحماية الحكومية لا تؤثر إلا عندما تطبَّق بصرامة.
تغيير ثقافة العمل يتطلب أكثر من مجرد إعلان الشركات عن أيام للصحة النفسية أو ممارسة الموظفين هواياتهم. كثير منا يحتاج إلى إعادة التفكير بشكل جذري في دور العمل في حياتنا. على المؤسسات أن تغيّر عملياتها، وعلى الموظفين أن يتخلصوا من فكرة أن قيمتهم مرتبطة بإنتاجيتهم فحسب.
خدعة الشغف: مراجعة لكتاب الوظيفة المُرضية قراءة المزيد »