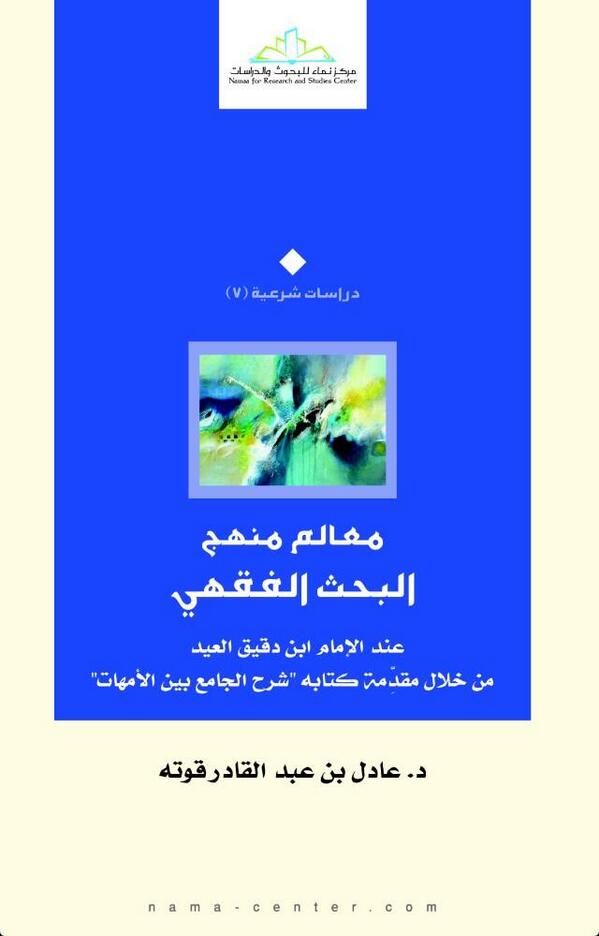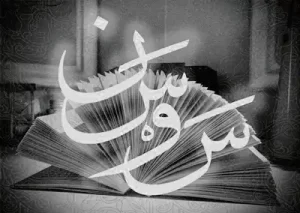تأملاتٌ في مقدمات الجرجاني

دكتوراة البلاغة والنقد
- تاريخ النشر |

إن بناء الحضارات لا يشيّد إلا بالعلم والمعرفة، وكل كتاب فذ هو بذرة يسهم في تحريك الفكر وتحفيزه، ولا تخلو هذه المؤلفات من مقدمات من شأنها أن تحوي على أسس الأفكار التي صنعت زهار المعرفة وفجرت مكامن قوى الأفكار.
وإذا جئنا لأصل كلمة مقدمة في اللغة نجد أن أصل المقدمة من مقدمة الجيش وطليعته، وهي التي تتولي الحماية وتتصدى للخطر، وهذا المعنى اللغوي يلقي بظلاله على المعنى الاصطلاحي لمقدمات الكتب التي تنشد صناعة الفكر وبناءه، وتتصدى لسبات الفكر ورقوده، أما المعنى الاصطلاحي فهي العتبة الكبرى التي تعد مدخلا للقارئ يصوغ فيها الكاتب مقاصد كتابه ومضامينه، وإشكالاته المعرفية وسياقاتها ويبيّن فيها طرق المعالجة.
إن مقدمات الكتب علم مهجور، فيها من الذخائر والنفائس والكنوز المعرفية ما ينبغي أن نتوقف عندها ونتداول كرائمها. تعرض المقدمات مقاصد المعرفة التي يرومها المؤلف، والأصول الفكرية الثاوية في ذهنه، وما من مقدمة إلا تنطوي على هم كاتبها، والإشكال المعرفي الذي يتغيا إلى تفكيكه وتحليله ثم تقويمه وتركيبه، ومن يطالع بناء المقدمات في تراثنا فسيلحظ أنها إما قصيرة تشتبك مع موضوع الكتاب، أو متوسطة يعبُر فيها الكاتب إلى موضوعه، أو مقدمة مطولة يثوّر فيها الكاتب رؤاه وطرائق تفكيره في كيفية الاشتغال، وهذه الأخيرة هي ما تميّزت به المقدمة في العصر الحديث، وإن وجدت في المقدمة التراثية لكن بصبغة عصرها.
هذا المقال يتحسس ويتدسس في عقل عبد القاهر الجرجاني من خلال مقدماته الثلاث في (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة) و (والرسالة الشافية) وهو يؤسس لنظرية النظم، تلك النظرية التي أسست ركائز البلاغة العربية بعلومها الثلاث، المعاني والبيان والبديع، فهل حدثنا الجرجاني في هذه المقدمات عن نظم آخر غير النظم (معاني النحو)؟ وهل كانت الأصول التي بنى عليها النظرية هي أصول لغوية فقط؟ وهل لهذه المقدمات الثلاث وشائج تربطها ببعضها؟ وإذا كان الجرجاني قد أسس لكل من كتب بعده في البلاغة والبيان، وأظهر دقة الصناعة في مدرسته التحليلية الأدبية، فهل في مقدماته أشياء أخرى توازن قدرته في الصنعة البيانية؟ وهل لعناوين كتبه تعالق مع مقدماتها؟ تشتغل هذه المقالة في مقاربة أجوبة هذه الأسئلة التي أثيرت من خلال قراءة مقدمات الجرجاني.
تبرز مكانة أي عالم من خلال صناعته للفن الذي يشتغل فيه، فهناك من يشرح، أو يعلق، أو يختصر، أو يقرر، وهناك من يصنع نظرية، وهذه هي أحد معالم بروز الجرجاني، فصناعة النظرية تُعرف من خلالها أسرار بناء المنظومة المراد دراستها وما تحويه من مفاهيم وعلاقات يُقدم من خلالها المبررات المنطقية والبراهين الممنهجة وفق أصول منتظمة ورؤية كلية، وقد هدانا الجرجاني من خلال استثمار جهود سابقيه في اللغة والأدب والنقد، وعقله المتوقد إلى صياغة علمية جامعة نقف من خلالها على أسرار البيان ومقاربة وجه الإعجاز البلاغي للنظم الكريم، ومعرفة مدى تحقق انسجام الصياغة مع المعنى المراد، الذي يلقي أثره على صقل الملكة النقدية التي تعلل تفاضل الأقوال على بعضها.

إن الذهنية التي أنتجت لنا نظرية النظم مزجت معها أصولا فكرية ترقى أن تكون بناءً لوعي أشمل وعقل شغوف ونفس متطلعة، أولى هذه الأصول هي الحض على طلب العلم وبيان فضله، ومنه تخرج كل خصلة حسنة، يقول عبد القاهر في الدلائل: “فإذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف، ونبيّن مواقعها من العظم، ونعلم أيّ أحق منها بالتقديم، وأسبق في استيجاب التعظيم، وجدنا العلم أولاها بذلك وأولها هنالك”. ومن وجود العلم إلى عدمه ينبه قائلاً: “وإذا هي خلت من العلم أو أبت أن تتمثل أمره وتقتفي أثره ورسمه، آلت ولا شيء أحشد للذم على صاحبها منها، ولا شيء أشين من إعمالها لها”. ومن كمال البيان أن يساق الشيء وضده كما سبق حتى يستبان الأمر، وتقع الفكرة موقعها، والمقابلة لها شأن في التأثير وقبول الأفكار كونها تبرز مواطن التشابه والاختلاف، وهذه سمة من سمات التفكير العليا أو المركبة، والحق إن العقلية الشمولية تعطيك من منهاجها قبل أن تعطيك نتاجها، وإذا سلمنا بفضيلة العلم فليس لها سبيل إلا الهمة والعزم ورباطة الجأش وهذا الأصل الثاني الذي أردفه الجرجاني بالأول، فيقول في الدلائل: “وإذا نظرت إلى الفصاحة هذا النظر، وطلبتها هذا الطلب، احتجت إلى صبر على التأمل، ومواظبة على التدبر وإلى همة تأبى لك أن تقنع إلا بالتمام، وأن تربع إلا بعد بلوغ الغاية، ومتى جشمت ذلك، وأبيت إلا أن تكون هنالك، فقد أممت إلى غرض كريم، وتعرضت لأمر جسيم، وآثرت التي هي أتم لدينك وفضلك، وأنبل عند ذوي العقول الراجحة لك، وذلك أن تعرف حجة الله تعالى من الوجه الذي هو أضوأ لها وأنوه لها وأخلق بأن يزداد نورها سطوعا وكوكبها طلوعا، وأن تسلك إليها الطريق الذي هو آمن لك من الشك وأبعد من الريب وأصح لليقين وأحرى بأن يبلغك قاصة التبيين”. وإذا تأملتَ هذه الدرر وجدتها من أنبل المحفزات للطلب والعكوف على أبواب العلم والكتب، ولو كان الأمر بيدي لجعلت هذه الكلمات ترفرف عند مدخل مؤسساتنا التعليمية، ولا يفتأ عبد القاهر أن يدلك على الطريق، وكما قيل: إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، حيث يوصي بالتفكير التأملي في العلم ودقائقه وسبر أغواره إلى ذوقه والتلذذ به، وهذا الأصل الثالث فيقول في الدلائل: “فانظر لتعرف كما عرفت، وراجع نفسك، واسبر وذق لتجد مثل الذي وجدت فإن عرفت فذاك، وإلا فبينكما التناكر، تنسبه إلى سوء التأمل، وينسبك إلى سوء التخيل”. وإذا وجدت هذه الأصول إلى نفسك المتطلعة موردا فاستبشر بها خيرا وأملا، فأساسها العلم، وطريقها الهمة، ونماؤها التأمل.
وفي السياق ذاته ينقلنا الجرجاني من الأصول إلى أدوات العلم والبحث، وأولى هذه الأدوات اللغة وهي التي تكشف عن الأسرار وتبرز الكنوز، يقول في الدلائل: “ثم إنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا، وأبسق فرعا، وأحلى جنى، وأعذب وردا، وأكرم نتاجا، وأنور سراجا من علم البيان، الذي لولاه لم تر لسانا يحوك الوشي ويصوغ الحلي … والذي لولا تحفّيه بالعلوم، وعنايته بها، وتصويره إياها، لبقيت كامنة مستورة ولما استنبت لها أبد الدهر صورة ولا استمر السرار بأهلتها، واستولى الخفاء على جملتها”. وهذه من الكلمات العالية، وفيها تتجلى حركة العقول الحية، التي تكاشف لك المعنى بأكثر من مورد، وهذا يدل على إخلاص العالم في تبليغه للعلم، كما أن للجانب الجمالي تأثير في حصول الطراوة العقلية بقبولها للفكرة، والمتمثل في الأساليب البديعية من المقابلة والسجع، وهذان الفنان وغيرهما من أساليب البديع مما يميّز المقدمة ويجذب لها السامع.
ويؤكد الجرجاني دور البيان باللغة، حيث يقول في أسرار البلاغة: “فلولاه – يقصد البيان – لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمه، ولا صح من العاقل أن يفتق عن أزاهير كمائمه، ولتعطلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها، واستوت القضية في موجودها وفانيها، نعم، ولوقع الحي الحساس في مرتبة الجماد، ولكان الإدراك كالذي ينافيه من الأضداد، ولبقيت القلوب مقفلة على ودائعها، والمعاني مسجونة في مواضعها، ولصارت القرائح عن تصرفها معقولة، والأذهان عن سلطانها معزولة، ولما عرف كفر من إيمان، وإساءة من إحسان، ولما ظهر فرق بين مدح وتزيين، وذم وتهجين”. وفي توظيف طاقات اللغة يكمن سر النبوغ والوصول، ومن اللغة تتولد الأداة الثانية وهي الإعراب، وما من علم من العلوم العربية أو الشرعية إلا له وصل ونسب به، والإعراب المتبصر في نظرية النظم هو الذي يوقفنا على الأسرار البيانية الكامنة في البنية الداخلية للكلام، يقول في الدلائل: “وفي علم الإعراب الذي هو لها كالناسب الذي ينميها وينسبها ويردها إلى أصولها، ويبيّن فاضلها من مفضولها”. وهذا الكلام هو لب نظرية النظم التي رسم ملامحها من تثوير المعرفة الواعية باللغة، يقول في الدلائل: “وإذا كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها، وأنه المعيار الذي لا يبيّن نقصان كلام ورجحانه حتى يُعرض عليه، والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه، لا ينكر ذلك إلا من ينكر حسه وإلا من غالط في الحقائق نفسه”. وهذا القول يدل على القراءة الواعية المستنيرة لكتاب سيبويه الذي صب ثمرته في علم البلاغة، ثم يلي الإعراب العلم بالشعر وصنعته، يقول في الدلائل: “وذاك إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت وبانت وبهرت هي إن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر، ومنتيها إلى غاية لا يُطمح إليها إلا بالفكر، وكان محالا أن يعرف كونه كذلك إلا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الأدب”. فالشعر صياغة ومضمونا أمد العلوم العربية بعلم زاخر وافر، وعلى ذلك فإن المكنة من اللغة التي تهبك صحة البيان، والعلم بالنحو والإعراب، وإدراك الصناعة الشعرية ونقد الشعر عن طريق الموازنات الشعرية منطلق أساس في الوقوف على أسرار البيان القرآني.
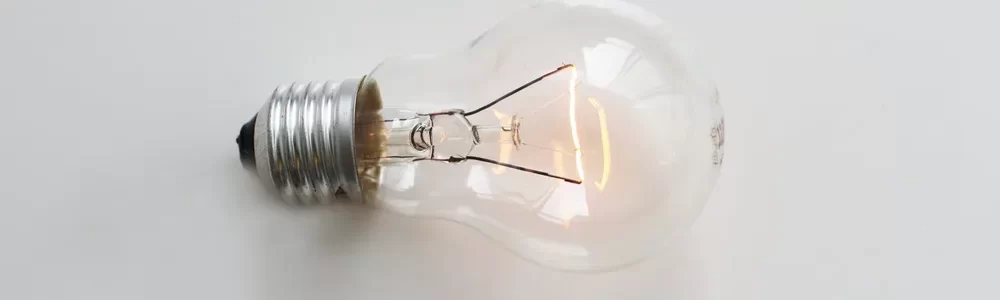
إن تثوير هذه الأصول والأدوات الفكرية والعلمية لصناعة نظرية لا تنشأ إلا مشكل معرفي عويص، ومن خلال النظر في مقدمات الجرجاني فقد تمثل الإشكال جليا في الرسالة الشافية والأسرار والدلائل، يقول في الرسالة الشافية: “معلوم أن سبيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل، وأن للتفاضل فيه غايات ينأى بعضها عن بعض، ومنازل يعلو بعضها بعضا”. ويقول في الأسرار: “ويتقرر في نفس المتأمل، كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان، ويعدل القسمة بصائب القسطاس والميزان”. ويقول في الدلائل: “وجملة الأمر إنك لن تعلم في شيء من الصناعات علما تمر فيه وتُحلْي حتى تكون ممن يعرف الخطأ من الصواب، ويفضل بين الإساءة والإحسان، بل حتى تفاضل بين الإحسان والإحسان وتعرف طبقات المحسنين”.
وإذا سلمنا أن كل نظرية انطلقت من أزمة عاصرت زمانها، فإن من يفحص الخلفيات التاريخية التي عاصرت الجرجاني، ويكشف عن مظاهر البنية الفكرية في ذلك العصر يلحظ سيادة النزعة العقلانية الذي التبس به مذهب المعتزلة ومنها كونوا أصولهم الخمسة، حيث أدى تصورهم العقدي إلى تركيزهم على العناصر الصوتية واللفظية للإعجاز القرآني فأولوا العناية الكبرى للألفاظ وحسن موقعها في الأسماع، في حين أن الأشاعرة – والجرجاني منهم – يرتكزون إلى الألفاظ من حيث ارتباطها بالمعاني وهو ما يعرف بالإسناد الذي ينظر إلى العلاقات والروابط المعنوية واللغوية، يقول في الأسرار: “وهذا الحكم _ أعني الاختصاص في الترتيب – يقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس، المنتظمة على قضية العقل، ولا يتصور في الألفاظ وجوب تقديم وتأخير وتخصص في ترتيب وتنزيل”. وعلى أساس هذا السياق الإشكالي تبلورت نظرية النظم، ومن الأمثلة التي نوجزها لبيان النظرية ما جاء في قوله تعالى في سورة مريم: (واشتعل الرأس شيبا) آية: 4، فتأمل معي هنا التمييز المحول عن فاعل (شيبا) وماذا أحدث في المعنى، إذ الأصل في غير القرآن: اشتعل شيب الرأس، وفائدة العدول – من المفاهيم الرئيسة في علم البلاغة – إلى التمييز إفادة شمول الشيب لجميع شعر الرأس، وهذا المعنى هو المقصود في هذا المقام، ولا يكون في صياغة نحوية أخرى كـ: اشتعل شيب الرأس، أو الشيب في الرأس، أو رأس الشيب اشتعل، فالعلم بالمواقع النحوية يفيد مدى مطابقة الكلام لمقتضى الحال.
ومما سبق نهتدي أن الإشكال المعرفي كان واضحا جليا عند الجرجاني ومتسقا في كتبه الثلاث؛ حيث إن الصناعة النقدية في تراثنا العربي التي على أساسها اُستدل على الإعجاز القرآني بدأت بالمفاضلة النسقية المتمحورة في البنية الشعرية وهو ما يعرف بالنقد اللغوي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الشاعر بما يفضي إلى سر تفاضل الأقوال ومعرفة درجات الإحسان وهو ما يعرف بالموازنات الشعرية، ثم بعد ذلك ارتقت نظرية النقد العربي واتسعت بفضل مقاربة فهم الإعجاز القرآني وهي ذروة نظرية النقد العربي الذي تبلورت قضاياه ورؤاه بعد ذلك في جانبين، الأول: في قضايا النقد التي تموضعت في الطبع والصنع وعمود الشعر واللفظ والمعنى والصنعة الشعرية، والثاني: في مقاربة الإعجاز القرآني الذي تجلى عند الخطابي والرماني والباقلاني، والمحصلة أن برزت نظرية النظم التي على أساسها ولدت البلاغة العربية بعلومها الثلاث: المعاني والبيان والبديع، ولذا فإن المعالجة التي تفنن الجرجاني في صناعتها ثوّرها الإشكال المعرفي الذي بدا واضحا عنده.
إن الأصول الفكرية لنظرية النظم بنيت على أسس التفكير النقدي، وهذا بازر في معالجة الجرجاني، لكن السؤال الحاضر هنا: هل في مقدمة عبد القاهر ما يشير إلى التأصيل النظري؟ نعم نرصد له أقوال في مقدمته نستطيع من خلالها أن نعرف حضور هذه الأصول النقدية، منها عدم التعجل في الحكم والتريث مما يؤثر على الاشتغال بالتقويم، وأن الإدلاء بأي فكرة أو قبولها لا يكون إلا بالدليل والبرهان، وكل هذه الأصول تحاط بإعمال العقل واستثمار قواه، يقول في الدلائل في شأن التقويم القائم على إصدار الحكم بعد الفحص والتحري: “ويستقصي النظر في جميعه ويتتبعه شيئا فشيئا، ويستقصيه بابا فبابا، حتى يعرف كلا منه بشاهده ودليله، ويعلمه بتفسيره وتأويله، ويوثق بتصويره وتمثيله” ويؤكد أن الحكم لا بد أن يساق بدليله بينا لا غموض فيه مع الإقناع الذي يصل إلى قطع الإعذار في الرفض، يقول: “قد قطعت عذر المتهاون، ودللت على ما أضاع من حظه، وهديته لرشده، وصح أن لا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمور”. وبالمقابل وعلى نهج الجرجاني في أسلوب المقابلة نجده يحذر من العزوف عن الدليل والتسليم دون التعقل وطلب الحق، وهذه آفة التفكير النقدي، يقول في الدلائل: “وإذا كان الأمر كذلك فليت شعري ما عذر من تهاون وزهد فيه ولم ير أن يستقصيه من مصبه، ويأخذه من معدنه ورضي لنفسه بالنقص، والكمال لها معرض، وآثر الغبينة وهو يجد إلى الربح سبيلا”. وهذا الكلام عين ما قاله المتنبي:
ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام
وفي المعنى نفسه لكن بأسلوب التقريع يقول في الدلائل: “إنا نسكت عنكم في هذا الضرب أيضا ونعذركم فيه ونسامحكم على علم منا بأن قد أسأتم الاختيار ومنعتم أنفسكم ما فيه الحظ، ومنعتموها مدارج الحكمة وعلى العلوم الجمة”.
كما يحذر من التصور الأولي أو قبول الفكرة الأولى؛ كون الفكرة الأولى قد تكون وهما كما ينبه الدلائل: “وهذه جملة قد يرى في أول الأمر وبادئ الظن أنه تكفي وتغني، حتى إذا نظرنا فيها وعدنا وبدأنا وجدنا الأمر على خلاف ما حسبناه، وصادفنا الحال على غير ما توهمناه”، ويقول كذلك في الأسرار: “وها هنا أقسام قد يتوهم في بدء الفكرة، وقبل إتمام العبرة، أن الحسن والقبح فيها لا يتعدى اللفظ والجرس، إلى ما يناجي فيه العقل والنفس، ولها إذا حقق النظر مرجع إلى ذلك”. ولا يكون التفكير النقدي إلا بإعمال العقل، يقول في الأسرار: “فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو يستجيد نثرا، ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول: حلو رشيق، وعذب سائع، وخلوب رائع، فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف، وإلى ظاهر الوضع اللغوي، بل أمر يقع من المرء في فؤاده، وفضل يقتدحه العقل من زناده”. وهذه الأسس النقدية نلمحها مع كل قول ومثال يسوقه الجرجاني في مقدمته، حيث يوصي بالنظر والفحص والتحري والتأمل وعدم التسليم بدون دليل.
إن عناوين الكتب الثلاثة التي ذكرها الجرجاني وهو يعالج نظرية البيان نلمح أنها تتكامل مع بعضها وتتآزر نحو تحقيق النظرية، ولو جمعنا عناوين كتبه الأسرار والدلائل والشافية في تركيب واحد لصارت: دلائل الأسرار الشافية، وهذا يصوّر لنا حركة عقل الجرجاني نحو همه المعرفي وهدفه الذي يروم تحقيقه، وقد حقق الجرجاني – بتوفيق الله – الغاية العظيمة التي سعى إليها من خلال نظرية النظم، التي ترشد إلى مقاربة فهم الإعجاز المتمثل بالوجه البلاغي، واستخلاص نظرية يقيم عليه وجه التمايز بين الأساليب، ووصفها بالشافية؛ كونه قد أفاد كل من جاء بعده سواء على وازن مدرسته التحليلية الأدبية كما تمثلت عند الزمخشري الذي طبق نظرية النظم في تفسيره الكشاف، أو المدرسة التقعيدية التي اهتمت بالتقسيم والتفريع كما عند الرازي والسكاكي.
تأملاتٌ في مقدمات الجرجاني قراءة المزيد »