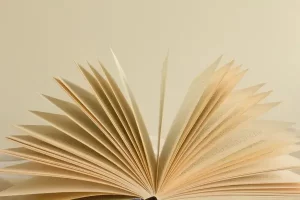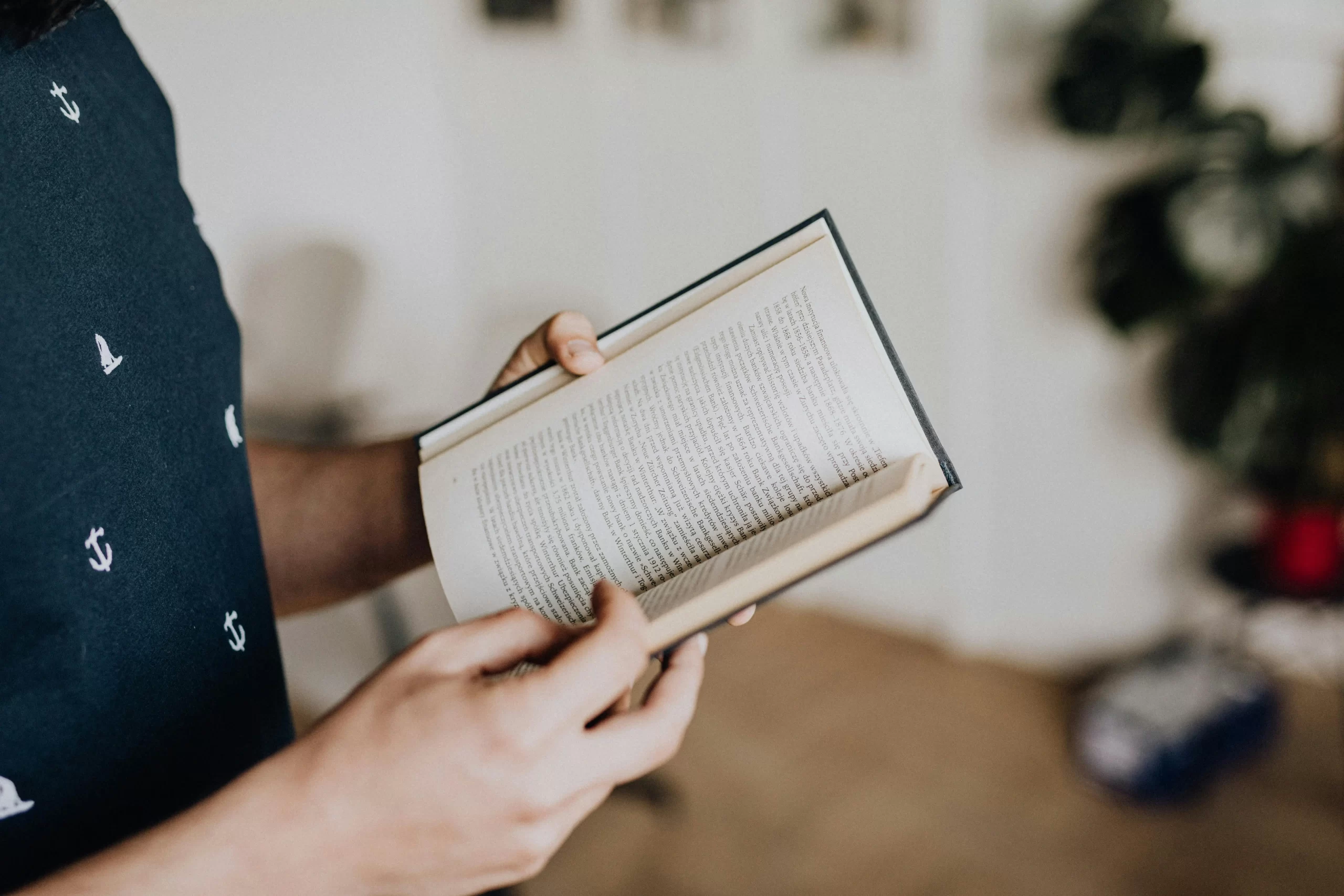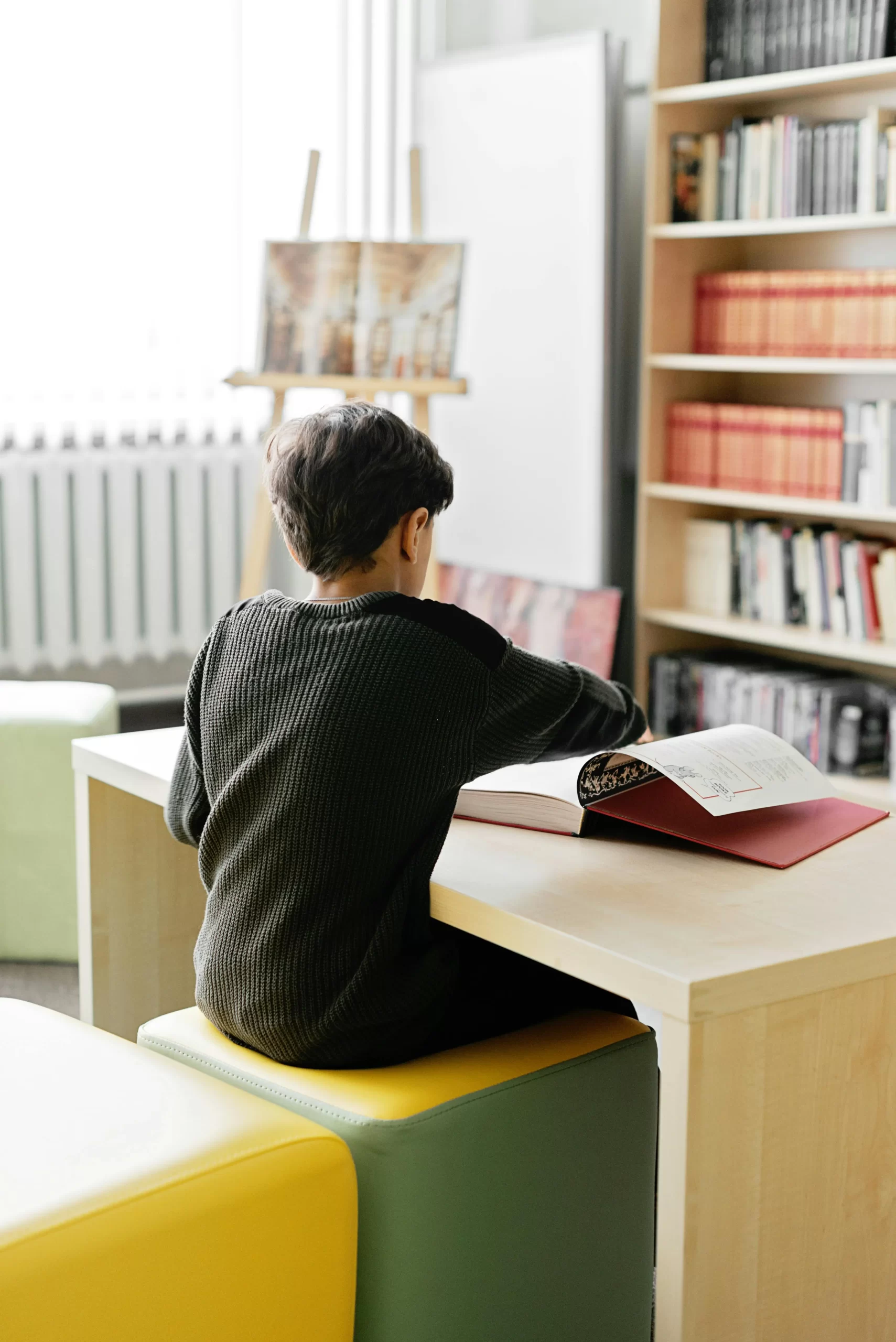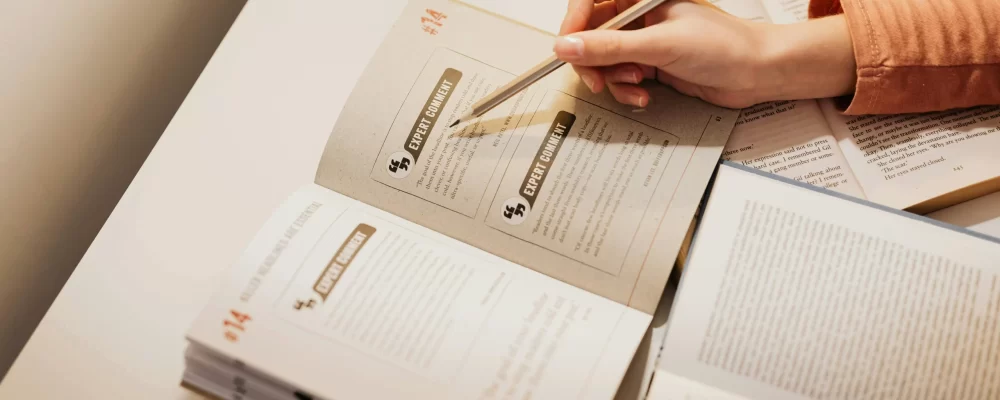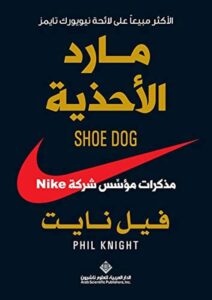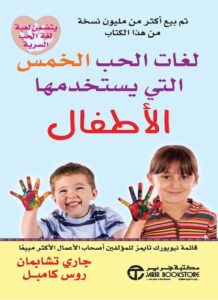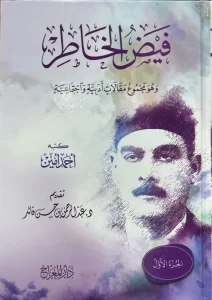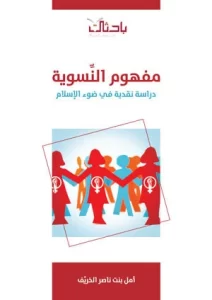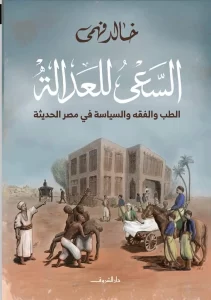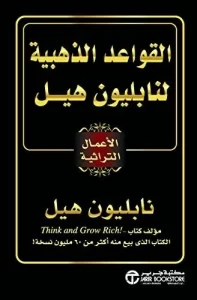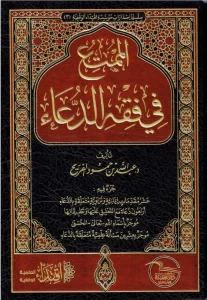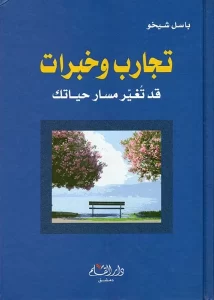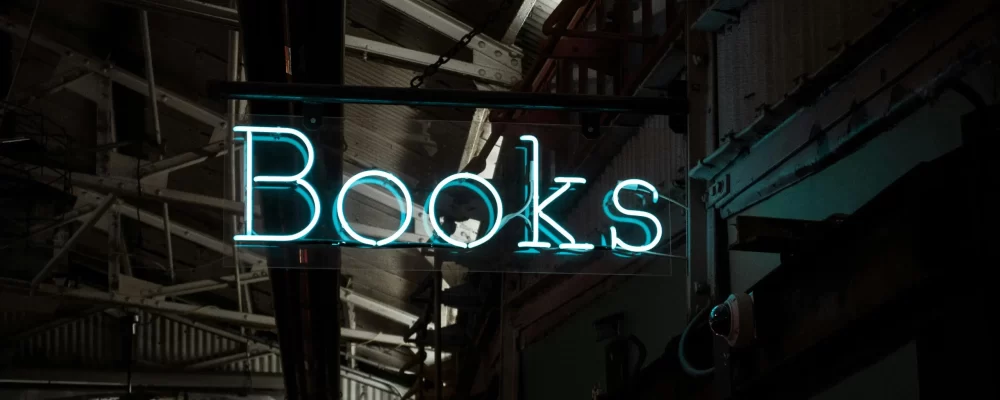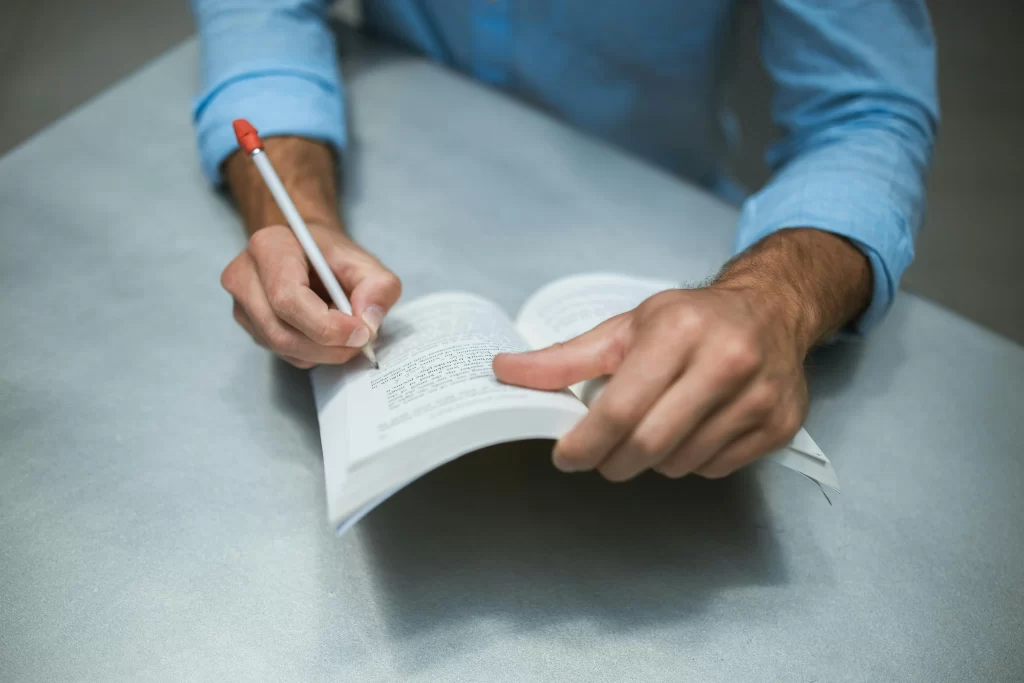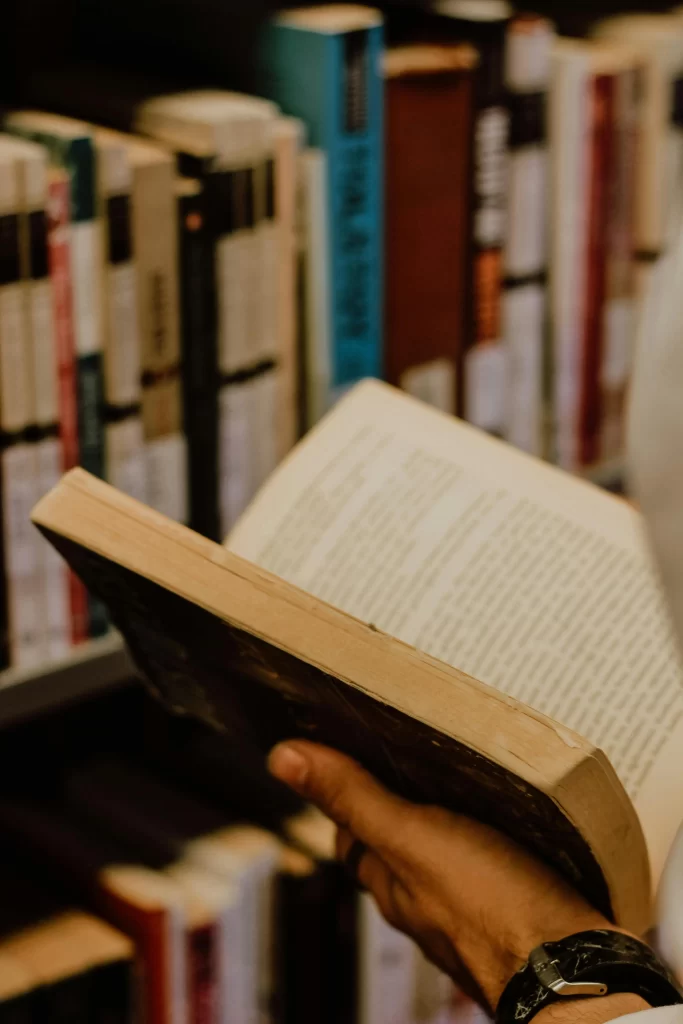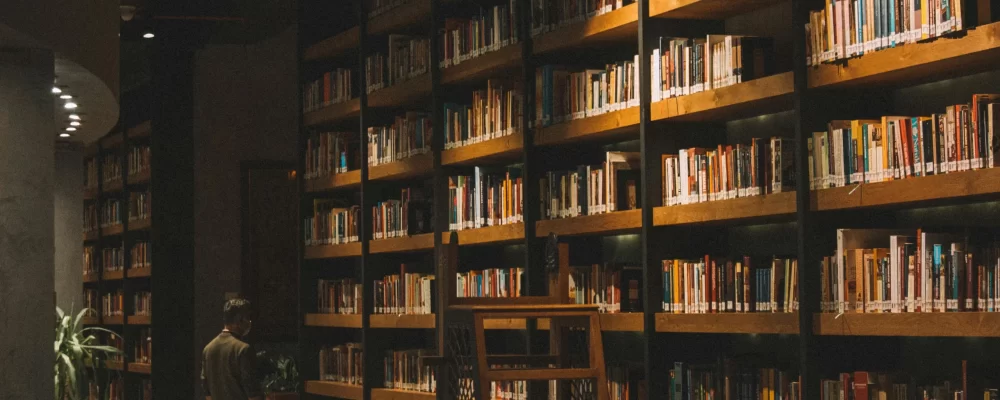القراءة الجهرية للأطفال وأثرها على السلوك والانتباه

من المسلّمات في مجال نموّ الطفل أن الأطفال الصغار يتعلمون من خلال العلاقات والتفاعلات المتبادلة، بما في ذلك التفاعلات التي تحدث عندما يقرأ لهم الآباء. تقدم إحدى الدراسات الحديثة دليلًا على مدى التأثير المستدام للقراءة واللعب مع الأطفال الصغار، حيث تشكّل تطورهم الاجتماعي والعاطفي بطرق تتجاوز مساعدتهم على تعلم اللغة ومهارات القراءة المبكرة. وجدت الدراسة أن اللحظات التي يقضيها أحد الوالدين والطفل مع الكتاب تساعد في الحد من المشكلات السلوكية، كالعدوانية وفرط الحركة وصعوبة الانتباه.
قال الدكتور آلان مندلسون، الأستاذ المساعد في طب الأطفال بكلية الطب جامعة نيويورك، والباحث الرئيسي في دراسة نشرت في مجلة طب الأطفال تحت عنوان (القراءة الجهرية واللعب والتطور الاجتماعي والعاطفي): “نحن نرى القراءة من زوايا مختلفة كثيرة، لكن هذه الدراسة تقدم منظورًا جديدًا لم نفكر فيه من قبل”.
أظهر الباحثون -وكثير منهم أصدقاء وزملاء لي- أن هذا التدخل القائم على الرعاية الأولية للأطفال، والذي يهدف إلى تشجيع الآباء على القراءة الجهرية واللعب مع أطفالهم الصغار يمكن أن يحدث تأثيرًا مستدامًا على سلوك الأطفال.
شملت الدراسة 675 أسرة تتراوح أعمار أطفالهم من سن الولادة إلى خمس سنوات. كانت تجربةً عشوائية تلقت فيها 225 أسرة التدخل المسمى بمشروع الفيديو التفاعلي، بينما ظلت الأسر المتبقية كمجموعة مقارنة. طُور نموذج المشروع في الأصل عام 1998، ودرسته هذه المجموعة البحثية على نطاق واسع منذ ذلك الحين.
مُنحت الأسر المشاركة كتبًا وألعابًا أثناء زيارتهم عيادة الأطفال، واجتمعوا مدة وجيزة مع مدرب التربية في البرنامج للتحدث عن نمو أبنائهم، وما لاحظه الآباء، وما قد يُتوقع من الناحية التنموية، ثم صُوروا بالفيديو وهم يلعبون ويقرأون مع أطفالهم لمدة خمس دقائق (أو أطول قليلًا في الجزء من الدراسة الذي استمر حتى سنوات ما قبل المدرسة). وبعد ذلك مباشرة شاهدوا المقطع المسجل مع أخصائي التدخل في الدراسة، والذي وضّح لهم استجابات الطفل.
قالت أدريانا ويزليدر، وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة وأستاذة مساعدة في قسم علوم الاتصال والاضطرابات في جامعة نورث ويسترن “شاهد الآباء أنفسهم على أشرطة الفيديو المسجلة، مما كشف لهم عن طريقة تفاعل أطفالهم معهم عند القيام بأشياء مختلفة. لقد حاولنا أن نسلط الضوء على الأمور الإيجابية في هذا التفاعل. قد يشعر الوالدان أن ما يقومون به سخيف بعض الشيء، ثم نعرض لهم على الشريط مدى حب طفلهم لهذه الأشياء واستمتاعه بها. هذا محفز للغاية”.
وقال الدكتور بينارد دراير، أستاذ طب الأطفال في كلية الطب بجامعة نيويورك والرئيس السابق للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة “إن أنشطة التربية الإيجابية تؤثر تأثيرًا حقيقيًا على الأطفال”. لقد لاحظ أن الفترة الحرجة في نمو الطفل تبدأ من الميلاد، وهو الوقت الذي تكثر فيه زيارات طبيب الأطفال، ويضيف “هذه فرصة رائعة لنا للوصول إلى الآباء ومساعدتهم على تحسين مهارات الوالدية، وهو ما يريدونه”.
بدأ مشروع الفيديو التفاعلي كبرنامج للرضّع والأطفال الصغار من الميلاد إلى سن الثالثة، وكان يركز على الأسر الحضرية منخفضة الدخل في نيويورك أثناء زياراتهم العيادات. أظهرت بيانات منشورة سابقًا من تجربة عشوائية مضبوطة بتمويل من المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية أن الأطفال في سن الثالثة الذين تلقوا التدخل قد تحسّنوا سلوكيًا – أي أنهم كانوا أقل عرضة للعدوانية وفرط الحركة مقارنةً بالأطفال في مثل سنهم في المجموعة الضابطة.
فحصت هذه الدراسة الجديدة أولئك الأطفال بعد عام ونصف -قريبًا من دخول المدرسة- ووجدت أن التأثيرات على السلوك ما زالت مستمرة. كما كان الأطفال المشاركين الأصغر سنًا أقل عرضة لظهور المشكلات السلوكية -العدوانية، فرط الحركة، صعوبة الانتباه- التي تصعّب على الأطفال التفوق والتعلم والازدهار عند الالتحاق بالمدرسة.
انضم بعض الأطفال إلى مرحلة ثانية من المشروع، وحصلوا على كتب وألعابًا وصُوروا أيضًا أثناء زياراتهم العيادة من سن الثالثة إلى الخامسة. تبيّن أن هناك علاقة مباشرة بين زيادة جرعة التدخل وتحسن سلوك الأطفال، فزيادة التعرض لأساليب “التربية الإيجابية” يعني تأثيرات إيجابية أقوى.
قال الدكتور مندلسون “إن انخفاض فرط الحركة يعني انخفاض المستويات المَرضية التي تستدعي تدخلًا طبيًا، نحن بذلك قد نساعد بعض الأطفال حتى لا يحتاجوا إلى الخضوع لأنواع معنية من التقييمات”. إن الأطفال الذين ينشؤون في ظل الفقر معرّضون بدرجة أكبر بكثير لخطر المشكلات السلوكية في المدرسة، ولذا فإن تقليل خطر مشكلات الانتباه والسلوك هذه من أهم الاستراتيجيات للحد من الفوارق التعليمية، وكذلك تحسين المهارات اللغوية عند الأطفال – مصدرٌ آخر للمشكلات المدرسية التي يعاني منها الأطفال الفقراء.
لكن ينبغي أن يدرك الآباء جميعهم مدى تأثير القراءة واللعب على التطور المعرفي والاجتماعي والعاطفي، بالإضافة إلى قيمة اهتماهم في مساعدة الطفل على الازدهار. قالت الدكتورة فايزليدر إن الأطفال أثناء اللعب والقراءة يواجهون مواقف أصعب مما يواجهونه في الحياة اليومية عادة، ويمكن أن يساعدهم الكبار في التفكير في كيفية إدارة هذه المواقف.
تقول “الإكثار من القراءة واللعب يقلل المشكلات السلوكية عند الأطفال بشكل مباشر، ذلك لأنها تُشعرهم بالسعادة، كما تجعل الأبوين يستمتعون بطفلهم ويرون هذه العلاقة بنظرة إيجابية”.
قد توفر القراءة الجهرية والألعاب التخيلية فرصًا اجتماعية وعاطفية خاصة. يقول الدكتور مندلسون “عندما يُكثر الآباء من القراءة واللعب مع الأطفال، فإنه تتاح لهم فرصة التفكير في الشخصيات، وفي مشاعر تلك الشخصيات. فيتعلمون استخدام الكلمات لوصف المشاعر التي قد يصعب عليهم الإفصاح عنها، وهذا يمكّنهم من ضبط سلوكهم عندما يمرون بمشاعر سلبية كالغضب أو الحزن”.
“الرسالة الأساسية هنا بالنسبة لي هي أن قراءة الآباء مع أبنائهم واللعب معهم في سن صغيرة جدًا -نتحدث عن سن الميلاد إلى الثالثة- لها تأثيرات كبيرة حقًا على سلوك الأطفال”. وهذا ليس مقتصرًا على الأسر المعرضة للخطر، بل إن “جميع الأسر يجب أن تعلم أنه بقراءتهم مع أبنائهم ولعبهم معهم يساعدونهم على تعلم ضبط سلوكهم” مما يهيّئهم للانتباه والتعلم في المدرسة.
القراءة الجهرية للأطفال وأثرها على السلوك والانتباه قراءة المزيد »