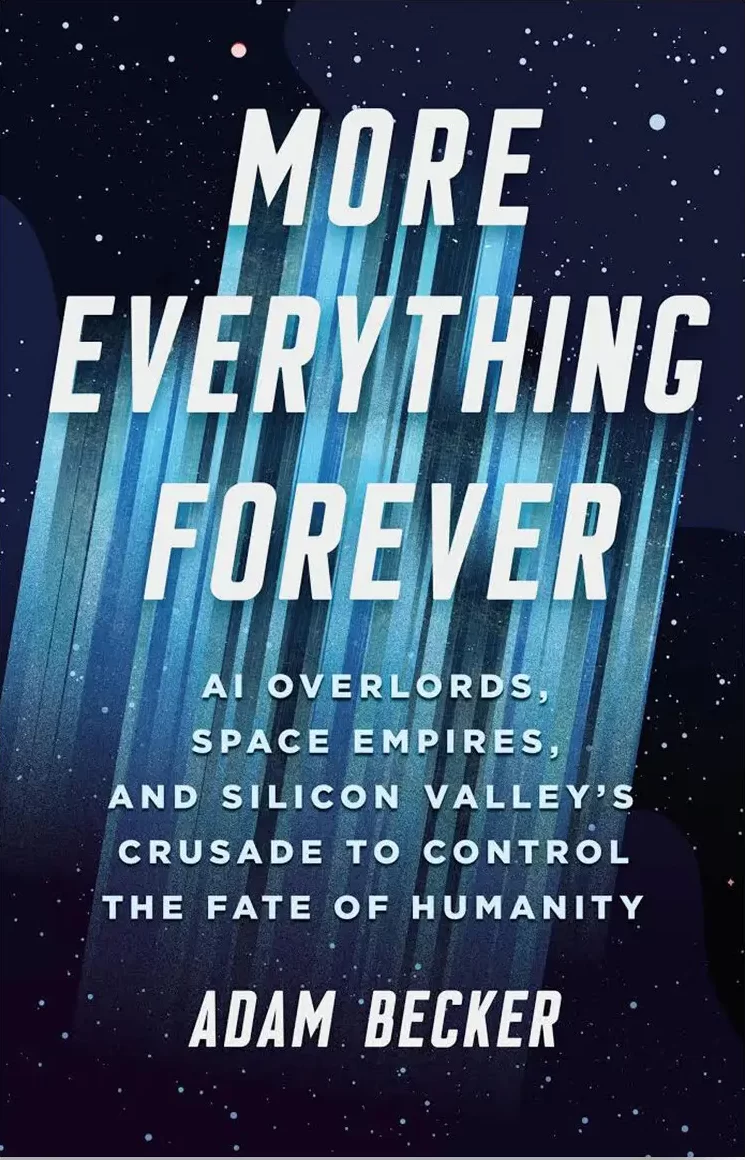يُعدّ كتاب “كيف تتحدث عن كتاب لم تقرأه؟” لبيير بايارد أحد الكتب التي تغيِّر في نفس المرء، وتعلِّمه كيف يمضي في حياته بين المعارف والكتب ومصادر الثقافة المختلفة، من دون أن يتسبَّب له ذلك بالتشوش، أو القلق، أو الادعاء، أو الخوف، أو البُعد عن ذاته، وذلك عبر تناول مسائل ومفاهيم عديدة تخصُّ رحلة المعرفة التي ننطلق بها إثر قراءاتنا.
بدايةً، يناقش الكاتب ضرورة أن يكون للمرء نظرة شمولية لمصادر المعرفة، أي الكتب، ونظرية العلائق التي تجمع بينها، والمستويات التي تترتب عليها، ليُدرك موقع كل كاتبٍ وكتابٍ في هذا الترتيب، ما يعني ضرورة أن يتجاوز المرء فردية الكتاب ليحكم عليه من حيث موقعه بالنسبة لبقية الكتب في مجاله، والعلاقة التي تربطه بها، ومن هنا يمكن أن يناقش المرء كتباً لم يقرأها لمعرفته بموقعها من حيث المستويات والعلاقات، كأن يستمع إلى نقاش يدور حولها أو يقرأ مراجعة عنها أو يتصفح الكتاب متوقفاً عند خطوطه العريضة.
ويرى فاليري بأن ملامسة المرء للفكرة أهم من الغوص فيها، وكذلك فإن ملامسة الكتاب أهم من قراءته والانغماس فيه والاندماج معه، ففعل الملامسة يحافظ على المسافة بين القارئ والكتاب والتي يتمكن عبرها المرء من تحديد موقع الكتاب وأهميته، وربما تحديد وظيفته في حياته فيما بعد، وهكذا تكون الممارسة النقدية عند فاليري متجهة للتعبير عن الذات لدرجة تستغني عن النص ذاته.
إن قراءة الكتب تغيِّر فينا وتبدِّلنا وتمتزج بعاطفتنا ونظريات المعرفة لدينا، ولكننا مع ذلك ننسى محتواها مع الوقت ولا نعود نذكر الجزء الأعظم منها، ولا مفرَّ من النسيان المرافق للقراءة، لذلك من الأفضل أن يركن المرء دائماً إلى الاقتراب من الفكرة ومجاورة الكتب والربط المعرفي بين مواضيعها، ومحاولة تطويع ذلك كله للاستفادة به في حياته، بدلاً من التوقف في كل مرة عند كتابٍ بعينه للغوص فيه وفي تفاصيله التي ستنسى مع الوقت.
ويشير الكاتب إلى مفهوم المكتبة الداخلية المتشكلة في كلٍّ منها، والتي تكون مجموع القراءات والأفكار والتصورات والعواطف التي يمر بها المرء، فتشكل هويته الثقافية، ويعتمد عليها المرء عادة في التعليق على الكتب التي لم يقرأها، ولكن التي يعرف موقعها من حيث موضوعها ومحتواها. لذلك يصحُّ القول بأن كل قارئ يقرأ نفسه في الكتاب، وكل كاتبٍ يفشل في إيصال معانيه الخاصة إلى القرِّاء، ما قد يضع الكاتب في ألمٍ لا بد منه عند حديث القراء إليه عن كتبه، لا سيما إن أحبُّوها بشدَّة.
وتضم المكتبة الجماعية مجموع الكتب التي قرأها المرء والتي لم يقرأها، أي التي يمكنه الحديث عنها بصورة عامة وتناولها من حيث أهميتها والوظيفة التي تلبيها، ولأن الكتب عادة ما تنتمي إلى المجال الافتراضي الذي نتحقق فيه، فإنها، كاللغة، طريقة مشوهة للتعبير عن نفوسنا، ذاك أننا لا نستطيع التعبير عما نريد عادة، لذلك يجب أن نقنع بالوجود الحتمي للغموض في عباراتنا والفضاء الذي نخلقه مع الآخرين.
من هنا يرى الكاتب بأن ما يُفهم من النصوص أهم بكثير ممَّا كُتب فيها، فأن يُشكل المرء عباراته بوساطة الكتب أهم بكثير من أن يفهم ما أريد حقاً بالكتاب ومعانيه:
“الحقيقة الموجهة للآخرين أقل أهمية من حقيقة الأنا التي لا يصل إليها إلَّا مَن تحرَّر مِن نير الضرورة التي تُكرهنا على أن نظهر أمام الناس بمظهر الثقافة، والتي تعذبنا في أعماقنا وتمنعنا من أن نبقى على طبيعتنا، ونكون ما نحن عليه حقاً”.

وبما أن لكل كتاب سياق الحديث الخاص به، والمنطوي على كاتبه وناشره وموضوعه، فإن له سياقاً داخلياً فينا كذلك يُحدد قيمته وموقعه ومدى قدرتنا على توظيفه لإفادتنا،وبالطبع فإن هذا السياق يتبدل ويتغير بمرور الزمن ونضوج الفرد وتغير مكانة الكتاب الخارجية.
واللافت في الأمر إثبات الكاتب بأن فعل قراءة الكتب ما هو إلا قراءة لأنفسنا، أي أننا ننتهي من قراءة كتبٍ نحن وضعناها وألَّفناها، ونفهم منها معانٍ متوهمة نحاول تصديرها من جديد، لتتموضع في فضاء متوهم كذلك ومختلف، وتقع على مسامع الآخر الذي سيفهمها تبعاً لمعجمه الخاص و”كتابه الداخلي”، أي أن فعل مناقشة مواضيع الكتب عملية تعبيرية تقوم على الوهم المشترك والمتحقق، ولا علاقة لها عادة بحقيقة الكتاب الذي تتم مناقشته.
ويمضي الكاتب متحدثاً عن تحويل القراء للكتب في أذهانهم وتغييرهم فيها بمرور الزمن، وذلك ضمن صيرورة إبداعية يكون فيها الإبداع أهم من الفهم، والاحتمال أقوى من الواقع، والعبارة النسبية أثقل من القاطعة:
“ما يهم في الكتاب هو خارجٌ عنه، لأن المهم هو لحظة النقاش التي لا يُمثل الكتاب إلا ذريعتها أو وسيلتها”.
بل إنه يرى الدقة والوضوح في التعبير عن محتوى الكتاب تنطوي على اعتداء على حق الآخر في الفهم كما يحلو له، أو كما يملي عليه كتابه الداخلي، يجب أن نترك لأنفسنا والآخرين حرية اللاقراءة وإمكانية الحُلم، أي يجب أن تكون القراءة فرصة للإبداع أكثر من الفهم، ولا تتحقق هذه العملية إلا عندما يدرك القارئ بأن جوهر الأدب لا يكمن في الرواية التي يقرأها، وجوهر المعرفة لن يجده في الكتاب الذي يقرأه، بل في العلائق التي يرسمها بنفسه بين التعبيرات المختلفة عن الموضوع، أي المحاولات الإنسانية العديدة لقول الشيء ذاته، ربما، ولكن بطرق إنسانية وإبداعية مختلفة ومبتكرة، عندئذٍ تصير قراءة العمل عائقاً لفهمه في مقابل عدم قراءته.
يُذكرنا ذلك بما تحدث عنه عبد السلام بنعبد العالي في كتابه “انتعاشة اللغة”، وذلك في مناقشته فعل الترجمة والأصل على أنها محاولات إنسانية على مستوى واحد، تحاول قول الشيء ذاته بطرق إبداعية مختلفة، وتنطوي كلٌ منها على القيمة ذاتها من حيث كونها التعبير الإبداعي والمبتكر عما يدور في خلد المرء حول الموضوع ذاته. وهذا ما يختتم به الكاتب كتابه، أي أن الغاية النهائية هي وصول المرء إلى القدرة الإبداعية لديه بوساطة الكتب، لا عبر قراءتها، بل عبر تعلم عدم قراءتها والوقوف على موقعها بدلاً من ذلك، هناك ضرورة يراها الكاتب في عدم الانغماس في العمل الفني وضرورة الانفصال عنه وتجاوزه ليتمكن من التعبير عنا:
“ليس الكذب بشأن النص هو الذي يجب أن نخشاه بل الكذب بشأن أنفسنا”.
أي أن غاية القراءة الاقتراب من الذات والحديث عنها وتطوير ملكة تعبيرية تمكِّننا من الكتابة بدورنا، ولو بمعنى مجازي.