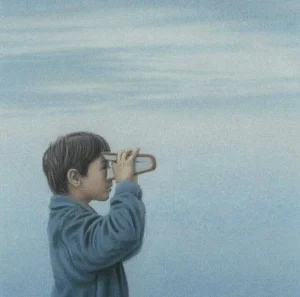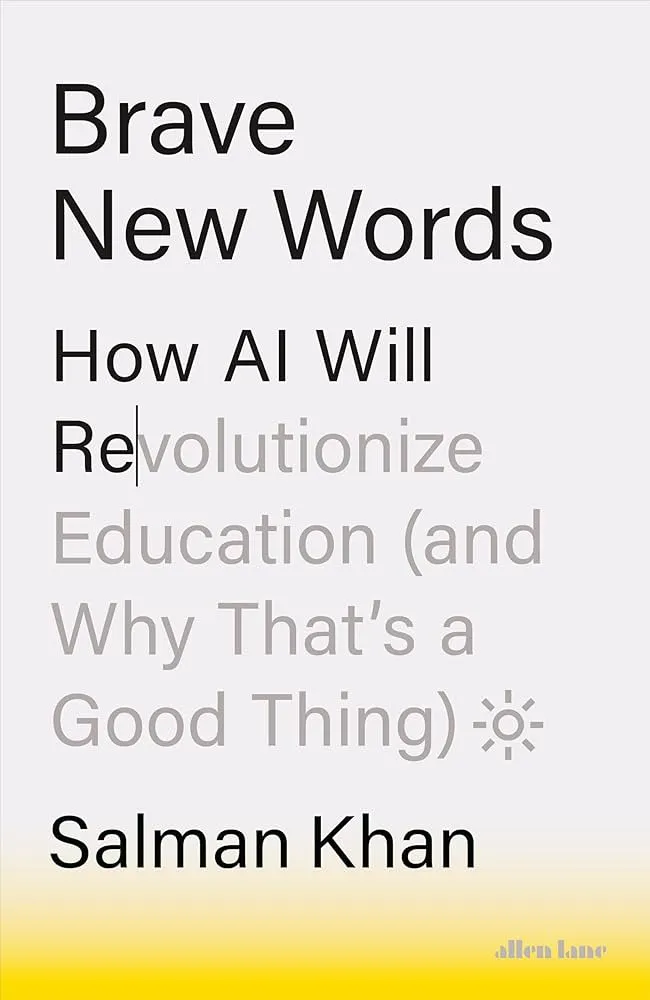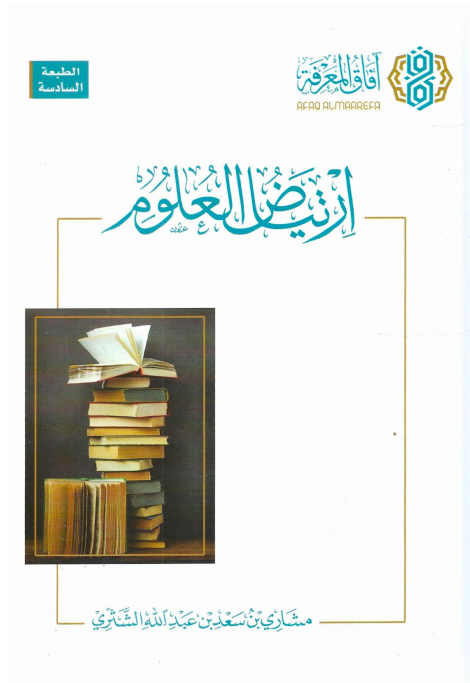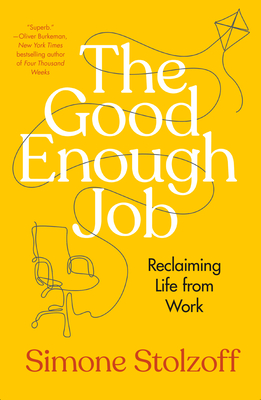يأتي كتاب “التاريخ العجيب للقلب” للطبيب والباحث فنسنت إم. فيغيريدو (Vincent M. Figueredo) ليسدّ فجوة مهمة في دراسة تاريخ الطب من منظور يجمع بين الدقة العلمية والعمق الثقافي.
الكتاب يقع في 393 صفحة وترجمه إلى العربية الدكتور مدى شريقي وطُبع في دار صفحة سبعة للنشر والتوزيع عام 2023.
يتميّز المؤلف فنسنت إم. فيغيريدو بخلفيّته الطبية المتخصّصة في أمراض القلب، إلى جانب اهتمامه بتاريخ العلوم، مما مكّنه من بناء نص شامل يستعرض التحولات الجوهرية في فهم البشرية لهذا العضو المركزي، بدءاً من تصوّرات الحضارات القديمة ووصولاً إلى أحدث المنجزات الطبية والجراحية. لا ينحصر الكتاب في مسار سردي تقليدي، بل يقدّم رؤية بانورامية تتداخل فيها المعاني الرمزية والثقافية بالقوانين الفسيولوجية، في محاولة لتفكيك التصوّر الثنائي التقليدي للقلب: فهو ليس فقط مضخّة للدم، بل أيضاً مركزاً رمزياً للمشاعر والهوية الروحية. بهذا، يحقق المؤلف توازناً نادراً بين المنهج التاريخي الدقيق والتحليل العلمي الرصين والرؤية الإنسانية الشاملة.
منذ الصفحات الأولى، يدرك القارئ أنّ هدف فيغيريدو لا يقتصر على توثيق الحقائق الطبية، بل يسعى إلى تقديم مقاربة متعددة الأبعاد لفهم القلب. يراعي المؤلف المنهج العلمي عبر الاستناد إلى مصادر موثوقة، سواء كانت نصوصاً طبية قديمة، أو سجلات تشريح، أو أبحاثاً حديثة في مجال علم القلب، ليضعها جنباً إلى جنب مع أعمال أدبية وفنية ودينية تناولت القلب بوصفه مستودعاً للمشاعر وأيقونة للحب أو موطناً للضمير الأخلاقي. هذه الازدواجية في التعاطي مع الموضوع تمثل نقطة قوة الكتاب: فهو يقود القارئ في رحلة زمنية طويلة، تبدأ من الرؤى الأسطورية التي ارتبطت بالقلب كجوهر للحياة، وتمرّ بالتطبيقات العلمية الأولى التي سعت لفهم تركيبه ووظيفته، وتنتهي بالعصر الحديث الذي يشهد تطوّراً هائلاً في التقنيات التشخيصية والجراحات المعقدة وزراعة القلب والأعضاء الصناعية. بهذه الصورة الشاملة، يرسم الكتاب خريطة معرفية تربط بين منجزات العقل البشري وتصوراته الروحية، لتقديم قراءة متكاملة للتاريخ العجيب للقلب.
الجذور التاريخية والتمثلات البدائية للقلب في الحضارات القديمة
ينطلق المؤلف من أقدم النصوص المكتوبة وأقدم الشواهد الأثرية للكشف عن مكانة القلب في وعي الإنسان البدائي. قبل اكتشاف مبادئ التشريح التجريبي، اعتمدت الحضارات القديمة على الملاحظة المباشرة وربطت نبض القلب وسرعة خفقانه بعناصر الحياة والموت. ففي حضارة وادي النيل، حمل القلب بُعداً دينياً وأخلاقياً محورياً، إذ اعتُبر موضعاً للضمير ومركزاً لتقييم أعمال الإنسان بعد مماته. في هذه النصوص، نرى أنّ المصريين القدماء تعاملوا مع القلب باعتباره جوهر الهوية البشرية، يتلقى الحساب في العالم الآخر، ويزن أمام ريشة الإلهة ماعت. وفي حضارة وادي الرافدين، اقترنت نبضات القلب بالقوى الخفية التي تحرك الكون، فيما انعكست في المنظومات الفلسفية القديمة في الهند والصين رؤى مختلفة تربط القلب بمنظومة الطاقة الداخلية (Qi) أو البرانا، مع اعتبار القلب نقطة التقاء المسارات الحيوية، مما أكسبه بعداً كوزمولوجياً وصحياً يتجاوز مجرد كونه عضواً تشريحياً.
أما في الحضارة الإغريقية، فقد كانت المعرفة الطبية لا تزال تتشكل تحت تأثير الفلسفة، فاعتمد أرسطو على التأمل المنطقي في وصف القلب كمركز الفكر والإدراك. وهنا يبيّن المؤلف كيف ساد الاعتقاد بأن القلب منشأ المشاعر والأحاسيس، وأن الدم يحمل “النفس” التي تمنح الحياة للأعضاء الأخرى. رغم بدائية هذه الأفكار من منظورنا المعاصر، فإنها وضعت اللبنة الأولى لإدراك أهمية القلب ودوره الحيوي. وعندما ننتقل إلى الحضارات القديمة في الأمريكيتين، كحضارة الأزتك والمايا، نكتشف حضوراً طقسياً للقلب في الاحتفالات الدينية والتضحيات البشرية، إذ اعتُبر القلب ذبيحة مقدّمة للآلهة، في سياق تصورات كونية معقدة رأت في الدم قوةً لاستمرار دورة الحياة. كل هذه الشهادات التاريخية المبكرة، التي يجمعها الكتاب، تكشف عن تفاعل الإنسان مع القلب بوصفه لغزاً يتخطى المحدوديات المعرفية، وتشكّل إرثاً فكرياً وثقافياً يمهد للمنهجية التشريحية والتجريبية التي ستأتي لاحقاً.
من التنظير الفلسفي إلى التجريب التشريحي – التحولات المعرفية بين العصور الوسطى والنهضة
مع دخول البشرية حقبة جديدة تتسم بظهور الحضارات الإسلامية وازدهار الترجمة والعلم في بلاد العرب، بدأ الأطباء والمفكّرون في مراجعة الأفكار الإغريقية والرومانية القديمة ونقدها. هنا يبرز دور العلماء المسلمين الذين استفادوا من إرث جالينوس وأرسطو، ولكنهم لم يكتفوا بمجرّد النقل، بل أضافوا تصويبات مهمة. يأتي اسم الطبيب والفقيه ابن النفيس في مقدمة هؤلاء، إذ اكتشف الدورة الدموية الصغرى (الرئوية) في القرن الثالث عشر، كاشفاً عن مسار الدم بين القلب والرئتين، وممهّداً الطريق لفهم أفضل لطبيعة القلب بوصفه مضخّة فعّالة تعمل وفق نظام دقيق. لم تكن هذه الرؤية نتيجة حدس مجرّد، بل استندت إلى تشريح منهجي ودراسات مقارنة سمحت بتشكيل تصوّر أكثر واقعية لدور القلب في ضخّ الدم.
ومع انتقالنا إلى أوروبا في عصر النهضة، تتبلور معالم ثورة طبية وفلسفية: اتسعت آفاق المعرفة بفضل إعادة اكتشاف النصوص الكلاسيكية وتطوير أدوات جديدة للتشريح. وهنا يسطع نجم ويليام هارفي (القرن السابع عشر)، الذي قدّم للعالم اكتشاف الدورة الدموية الكبرى، وأثبت عملياً أنّ القلب ليس مخزناً للحرارة أو للعواطف، بل مضخة قوية تضخّ الدم باستمرار في الشرايين والأوردة في حلقة متكاملة. بهذا الاكتشاف، اهتزّت قناعات طبية عمرها قرون، وفتح الباب أمام المنهج التجريبي ليحلّ مكان التنظير الفلسفي. يشير المؤلف إلى مدى صعوبة هذه القفزة المعرفية، إذ اصطدمت في بدايتها بعوائق اجتماعية ودينية، لكن بفضل الإصرار على الدليل التجريبي، وإقامة جلسات التشريح العلني، واختراع المجاهر، بدأت تتضح الملامح التفصيلية لأجزاء القلب الداخلية، من صمامات وبطينات وأذينات. احتاجت البشرية قروناً لتتجاوز التصورات الأسطورية، لكن الدقة العلمية التي أرسيت في هذه الفترة مكّنت من صياغة فهم حديث لوظيفة القلب، وأسهمت في بناء أساس متين للطب الحديث. وعبر هذه المسيرة، يتجلّى للقارئ كيف أنّ تراكم المعرفة الطبية حول القلب كان نتاج توتر دائم بين المعارف السابقة والمنهج التجريبي الجديد، وبين التقاليد الراسخة والابتكار العلمي الجريء.
أبعاد رمزية وثقافية – القلب بين الدين والفن والفلسفة
لا يكتفي المؤلف بسرد حقائق علمية، بل يفتح الباب أمام القرّاء لاستكشاف المعاني الرمزية التي التصقت بالقلب عبر القرون. ففي الأديان الكبرى، اكتسب القلب مكانة مقدسة، كما في المسيحية التي حظي فيها “القلب المقدّس” بأهمية روحية وأيقونية، وفي التصوف الإسلامي حيث رُفع القلب إلى مصاف المركز الروحي الذي يشرق بنور الإيمان ويمتاز بالقرب من الله. هذا البعد الروحي الديني يبرز دور القلب في نظام القيم الأخلاقية، حيث تُنسب إليه القدرة على التمييز بين الخير والشر، وأصبح الحَكم الخفيّ على أفعال الإنسان ونواياه.
من جهة أخرى، كان للأدب والفن نصيب وافر في صياغة صورة القلب. فالشعراء والمسرحيون والروائيون استخدموا القلب كاستعارة للتعبير عن الحب والحنين والرغبات الجامحة، وصوّروه في مختلف الحالات الشعورية، من الشوق إلى الفقدان. كذلك خَلَق الفنانون التشكيليون، عبر القرون، أعمالاً فنيّة صوّرت القلب بأشكال رمزية، بدءاً من الرسوم الدينية في القرون الوسطى، ووصولاً إلى فناني عصر النهضة الذين اهتموا بالتشريح الدقيق في لوحاتهم، ثم الحركات الفنية الحديثة التي استلهمت شكل القلب المجرّد من حقيقته التشريحية لتصنع رموزاً عالمية للحب والرومانسية. ويشير المؤلف إلى انتشار الرمز الشكلي للقلب، ذلك الشكل الذي يأخذ هيئة منحنيات علوية وقمة مدببة سفلية، والذي بات أيقونة عالمية تتخطى الثقافات، على الرغم من كونه بعيداً عن الشكل التشريحي الحقيقي للقلب. هذا التحوّل الرمزي يعكس قدرة الإنسان على تحويل الحقائق التشريحية إلى أيقونات فنية وفكرية، ويؤكد أنّ تاريخ القلب ليس فقط تاريخ تقدّم علمي، بل أيضاً مسار اجتماعي وثقافي غني بالتفاعلات والتأويلات.
وفي الفلسفة، يستعرض الكتاب جدلية توزيع الوظائف بين العقل والقلب. فعلى مرّ التاريخ، تنازعت الأفكار حول إن كان القلب مصدراً للمشاعر فحسب، أم أنه موضع الإدراك والحكمة. ومن خلال تتبّع آراء الفلاسفة، من أرسطو الذي اعتبر القلب مركز الفكر إلى ديكارت الذي وضع العقل في الدماغ، يظهر الكتاب كيف تأثر فهم القلب بالمناخ الفلسفي والروحي، وكيف تباينت الآراء باختلاف الأنماط الثقافية والحقب الزمنية. بهذا يرسم المؤلف لوحة شاملة تُظهر أنّ القلب لم يكن مجرد عضلة، بل مرآة تنعكس عليها تصورات الإنسان عن ذاته وعن الكون من حوله.
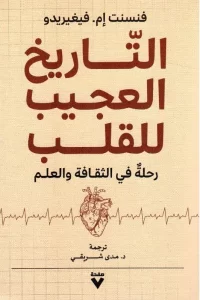
إنجازات الطب الحديث وآفاق المستقبل
بعد استعراض التطورات التاريخية والثقافية، يتجه الكتاب إلى تناول مرحلة التحولات الجذرية في فهم القلب منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم. يستعرض المؤلف كيفية إسهام اختراع السماعة الطبية (الستيتوسكوب) وأجهزة تخطيط القلب الكهربائي (ECG) وتقنيات التصوير الحديثة (مثل الأشعة السينية، والأشعة المقطعية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وتصوير الأوعية) في تمكين الأطباء من فهم أدق لوظائف القلب وحالاته المرضية. كما يسلّط الضوء على التجارب السريرية التي ساعدت في تطوير عقاقير جديدة وتحسين معايير التشخيص والعلاج.
يخصّص الكتاب مساحة لمناقشة التطوّر الهائل في جراحات القلب، بدءاً من العمليات الجراحية الطفيفة وصولاً إلى جراحات القلب المفتوح، وزرع القلب، والاستعانة بأجهزة مساعدة الدورة الدموية. كما يتوقف عند تطور علم الجينات القلبية والبحوث التي تستكشف الخلفية الوراثية لاعتلالات العضلة القلبية، ما يفتح المجال أمام طب شخصي يضع المريض في بؤرة الاهتمام. لا يغفل المؤلف ذكر التحديات الحاضرة والمستقبلية، مثل ازدياد معدلات أمراض القلب الناتجة عن أنماط الحياة غير الصحية، وانتشار عوامل الخطر كالسمنة والتدخين وداء السكري. كما يناقش الآفاق المستقبلية، مثل تطوير قلوب صناعية أكثر كفاءة، والاستفادة من الخلايا الجذعية في إصلاح أنسجة القلب التالفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص المبكر وتحديد مخاطر المرض.
إنّ عرض هذه الإنجازات الطبية الحديثة في سياق تاريخي يبرز القيمة المعرفية للكتاب، إذ يبيّن للقارئ أنّ الانجازات التكنولوجية والطبية الحالية لم تنبثق من فراغ، بل كانت ثمرة قرون من الجهد، والاستقصاء، والنقد، والتجريب. هذا الربط المتين بين الماضي والحاضر يجعل الكتاب دليلاً مفيداً لفهم طبيعة التقدم العلمي، وأن التطوّر في فهم القلب لا ينفصل عن التطوّر الإنساني برمّته. بهذا، يضيف المؤلف بُعداً مستقبلياً للقلب، حيث يقدّم تصوراً عن إمكانات العلم في رسم معالم فهم أكثر عمقاً لهذه المضخّة الحيوية، ويشجّع القرّاء على التفكير في الخطوات القادمة نحو مزيد من الاكتشافات والإنجازات.
الخلاصة والتقييم النقدي للكتاب
يمثّل “التاريخ العجيب للقلب” عملاً يجمع بين الغزارة المعرفية والاتساع التاريخي، ويقدّم طرحاً متكاملاً لمسيرة فهم القلب عبر مختلف الأزمنة والفضاءات الثقافية. يمتاز الكتاب بأسلوب علمي صارم في توثيق الحقائق والمعلومات، مدعوماً بشبكة من المراجع الموثوقة، مما يمنحه طابعاً أكاديمياً متيناً. في الوقت نفسه، لا يتخلّى المؤلف عن النزعة السردية التي تجعل النص ممتعاً وشيقاً، إذ يروي الأحداث والمكتشفات بلغة مفهومة، ويعرض شخصية العلماء والأطباء بصورة حية. هذه الثنائية في الأسلوب، بين الدقة البحثية والجاذبية الأدبية، تزيد من قيمة الكتاب بوصفه جسراً بين المختصين والقرّاء المهتمين بالشؤون العلمية والثقافية.
من الناحية النقدية، قد يشعر بعض القرّاء بأن المؤلف منح بعض الحقب التاريخية اهتماماً أكبر من غيرها، أو أنّه مرّ سريعاً على بعض التفاصيل التشريحية المعقدة. لكن يمكن تفهّم هذه الانتقائية في ضوء اتساع الموضوع وتشعّبه. كما قد يثير التساؤل مدى اعتماد المؤلف على مصادر ثانوية أحياناً، إلا أنّ هذا أمر معتاد في الدراسات التاريخية واسعة النطاق. إذا كان ثمة ملاحظة، فقد تتعلّق بعدم التعمّق في بعض الجوانب الفلسفية أو عدم إبراز الاختلافات في الرأي بين المؤرخين والأطباء حول قضايا معيّنة، ولكنّ هذه تبقى ملاحظات طفيفة في مقابل الجهد المبذول.
يحسن بالقارئ الذي يبحث عن فهم شامل للعلاقة بين الطب والثقافة والتاريخ أن يقتني هذا الكتاب. فهو لا يكتفي بعرض المسار العلمي لفهم القلب، بل يُظهر أهمية النظر إلى العلم في سياق حضاري أوسع. ويُقدّم دروساً حول كيفية نمو المعرفة الإنسانية في بيئات متقاطعة، سواء كانت دينية أو فلسفية أو فنية. إنّ “التاريخ العجيب للقلب” يذكّرنا بأن العلم لا ينمو في فراغ، بل يتفاعل مع المناخ الفكري والاجتماعي والقيمي، وأنّ معرفتنا بالجسد مرتبطة بفهمنا للإنسانية ككل. باختصار، هو عمل موسوعي يعيد للقارئ الاعتبار في النظر إلى الطب كتجربة إنسانية معقّدة، يصعب اختزالها في مختبرات التعقيم والأدوات الجراحية وحدها. إن هذا الكتاب إضافة مهمة للمكتبة العربية والعالمية، إذ يُثري النقاش حول القلب بوصفه موضوعاً طبياً عريقاً، ورمزاً إنسانياً متعدد الأبعاد، وجدير بأن يُقرأ بعين فاحصة وعقل منفتح.