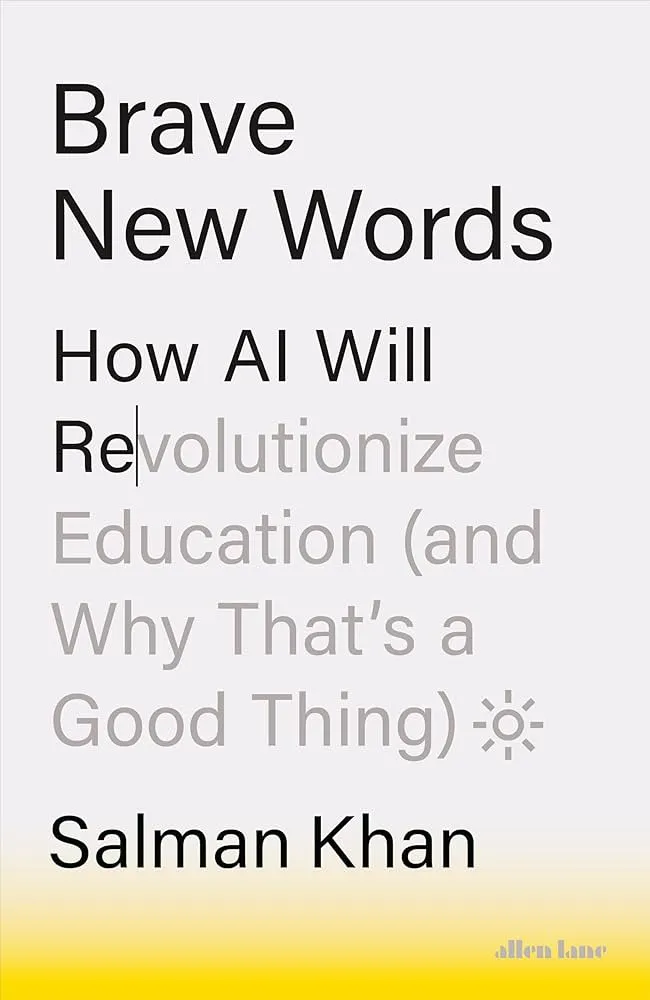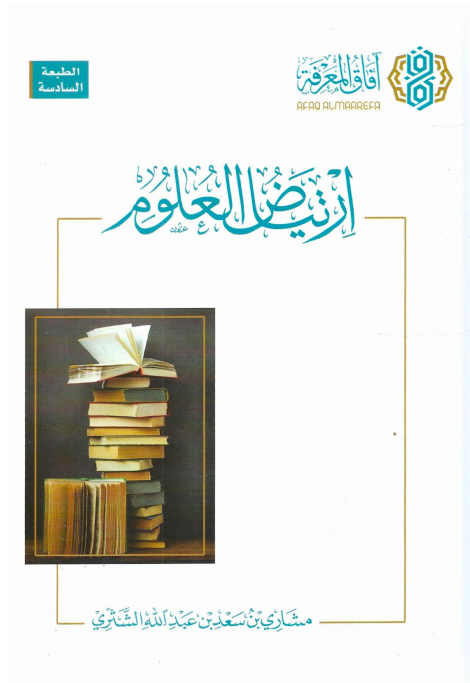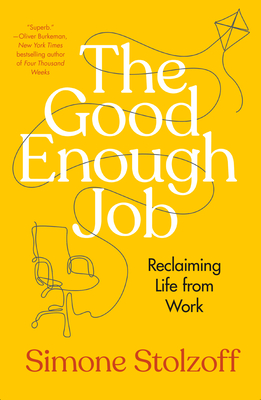مرآة الأفكار لميشيل تورنييه، كتابٌ من التأملات الفلسفية الجميلة، أبرز فيه الكاتب معنى أن يكون للمرء نظرة فلسفية لوجوده وصيرورته عبر الزمكان، وقدرة على استكناه طبائع الأمور وحقائقها عبر اللغة والمجاز، كان لبعض التشبيهات والمستويات المجازية غرابةٌ لذيذة استوقفتني عدة مرات، إنه من الكتب المُرهقة للعقل، لتنقله بين شتى المواضيع والأفكار، لذلك فإنه يُقرأ على مهل، هناك قيمة عظيمة ينطوي عليها، لا تكمن فقط في مادته، بل في أثره اللاحق على قارئه.
من الأفكار التي ناقشها الكاتب، دور الضحك في الحفاظ على المجتمع طرياً، غير متصلِّب تجاه معتقداته، إذ يمنع عنه التحوُّل الآلي، بينما يكون البكاء اعترافاً بالاستسلام أمام العناصر الحتمية في العالم، كما ناقش التغيرات التي تصيب المرء إثر انتقاله من براءة الطفولة إلى عنفوان المراهقة وتمرُّدها، مشيراً إلى أنها تغيرات محفوفة بالمخاطر دائماً، تورث في النفس كآبة وضيقاً يحتاج الوقت للتبدُّد، جديرٌ بالذكر أن رواية “الحارس في حقل الشوفان” كانت من أبرز الأعمال التي جسدت هذا العنفوان والضيق والتمرُّد الذي يكتسبه المرء في مراهقته.
وتحدث تورنييه عن الصداقة المعتمدة على التقدير المتبادل، مقابل الحُب الذي يمكن أن يظهر من طرفٍ واحد، فيُعمي صاحبه عن عيوب غيره وعمَّا يضرُّ نفسه، ويُعبِّر عن ذلك بقوله أنَّ الحب مشاعر متطرفة تقتات على النفس وتورثها الألم لأنه نتاج شعورٍ بانعدام المساواة في الأصل، في حين تنشأ الصداقة بين طرفين متساويين:
“الصداقة يقتلها الاحتقار. بينما حُمَّى الحبِّ قد تجعل العاشق لا مبالياً تجاه الحماقة، والجُبن، والدَّناءة التي يُبديها المعشوق. لا مبالياً؟ لا .. بل إنه أحياناً يتغذَّى، كالشره والجائع، على أشنع ما في المعشوق من عيوب. لأنَّ الحُبَّ يُمكن أن يكون قمَّاماً”.
والحيوانات القمّامة التي يقصدها هي تلك التي تقتات على الجيف وما يخلفه غيرها من الحيوانات. ويستعمل المؤلف لفظ coprophage التي تُشير إلى أكَلَة البراز.

كما ناقش مواضيع عديدة مُسقطاً الأفكار والتصورات الإنسانية على مجموعة من العلاقات التي تربط بين مفاهيم وموجودات ومخلوقات عديدة، كمناقشته العلاقة والاختلاف بين الكلاب والقطط، بين الثيران والبقر، بين الاستحمام تحت الدوش والاستحمام في الحوض، وما ينطوي عليه ذلك من دلالات فلسفية ونفسية وسياسية، كأن يشير الدوش إلى الرغبة التطهيرية واليسار السياسي المؤمن بالتغيير والتطور والتقدم والنقد، والاستحمام في الحوض إلى الرغبة في الإبقاء على الأمور كما هي عليه، كما في اليمين السياسي المتحفظ، والمؤمن بالحاضر وحماية المصالح وتحقيق الاستقرار.
وطالت تأملاته مرض الطبيعة الذي ينخر فيها باستمرار: أي الإنسان، والإسقاطات الفلسفية لطبائع المدن الحديثة المُصممة للتنقل السريع لا للتأمل والاستقرار والتمتع بمكان الإنسان في الطبيعة، كما أحببتُ مقابلته بين الماء والنار، في أن الأخيرة رمز الروح الإنسانية المشتعلة والمتطلعة، والأولى رمز ظروف الحياة القاهرة والباردة والبليدة: “الحياة تأتي من الماء، لكنَّ النار هي الحياة نفسها، بحرارتها ونورها وأيضاً بهشاشتها .. ’في الحرب بين النار والماء، دائماً ما تخسر النار‘. متشائم، نعم، لأنَّ النار تشير هنا إلى الحماسة، والروح الشابة، والجرأة، بينما يشير الماء إلى القهر الذي تمارسه علينا الحياة الواقعية”.
كما استطاع الكاتب التكهن بمنظور المؤرخ والجغرافيِّ للزمان، في أنَّ الزمان عند الأول تتالٍ لأحداث كارثية أليمة، محورها الحروب والشر المطلق، بينما عند الثاني يكون الزمان مجزأ تبعاً للفصول، حاضراً على الدوام، يمتزج بتفاؤلٍ إنسانيٍّ يؤمن بالتغيير. وتناول الكاتب الراحة الفكرية في الاعتقاد والإيمان، والتي يعدُّها المؤمن مكافأة على حسن تفكيره، في مقابل القلق الفلسفي المتمثل في الشك والأسئلة الدائرة والمحنة التي تصيب المرء إذ يُبتلى بها، وتفلسَفَ حول الفرح، ذلك الشعور الإنساني الذي يرافق فعل الإنسان الخلَّاق والإبداعيَّ، والذي يحمله على الشروع والبدء والفعل، في مقابل المتعة التي تهدم وتستهلك وتنقضي سريعاً وتكون خالية من العنصر الإنساني الأصيل، مشيراً إلى أن العلاقات الحميمية بين الجنسين تحمل بعضاً من الفرح والمتعة في آن، ذاك أنها تنطوي على العنصر الخلَّاق في إنشاء علاقة وثيقة مع الآخر، نتجه عبرها إليه ونستثمر فيه ونؤمن به.
أعجبني كذلك ما ورد حول الكتابة مقابل الكلام، فتورنييه يشير إلى أن الكتابة هي فعل الصمت الاختياري، يمارسه المرء في وحدته ويعبر أثره الزمان والمكان، في حين أنَّ الكلام ينطوي على انفعال شعوري وجداني في إفهام الآخر والتواجد حوله والعناية به، ينتهي ذكره في وقت قريب، من هنا كانت الكتابة المرحلة التالية لتعلم الإنسان الكلام، بما ينطوي عليه من أبعاد اجتماعية.
أحببتُ كذلك ما تفلسف به الكاتب حول اللون الرمادي، في كونه لون العالم الأصل قبل اعتداء الألوان على الأشياء وحجب براءة العالم عنا، وأعجِبت بحديثه عن “الكيف” في مقابل “الكم”، وطريقة الطبيعة الكيفية في مقاومة طريقة الإنساني الكمية، وتمكُّنها من الحفاظ على عنصر مبهم لها تنطوي عليه، به تتميز وتوجد وتبتعد عن الإنسان ووعيه، كما كان لحديثه حول واقعية الطبيعة التي تروِّض الإنسان الأهوج ومثاليته أهمية كبيرة في تبيان الحقيقة التبدُّلية التي تقوم عليها الحياة، أي التنسيب -إضفاء الطابع النسبي على الأشياء- في الطبيعة مقابل المُطلق الذي يبحث عنه الإنسان ليتشبَّه به ويتمثَّل فيه. وكان لحديثه حول الإنسان الذي يتملكه هاجس الموت والعدم أثر كبير في تبيان معنى الغثيان لدى سارتر، أي بكونه عالمٌ مُستقل يحيط بالإنسان فيوجد فيه ويصبغه بصبغته، ليدرك الوجود بصورة باهتة وفاترة، تستدعي الإنسان الفاعل لإحداث الفرق فيها، وتختبر صبره على نفسه أثناء ذلك.
ومن برغسون الذي آمن بأن الإنسان هو الذاكرة، إلى الحديث عن الثقافة والحضارة في كونهما متضادتين، ترفض إحداهما الأخرى وتنفيها، إذ تنطوي الأولى على النقد والعنصر الإنساني الفاعل، والثانية على تقدم خالٍ من رؤية واضحة وناجعة، ومن جمالية الرمز في مقابل الصورة، وقدرة اللغة على خلق جماليات تخصها وحدها للتعبير عن المعنى، في ارتباطها الشديد بالإنسان الفاعل ذي المعنى الأصل والتصور الفريد، إلى مفهوم الفاعلية الإنسانية المُقتبسة من الرب والمتجسدة في الانفعال المصاحب للفعل، والذي رأى فيه سبينوزا عنصراً إلهياً يُنبئ عن علاقة وطيدة بين الإنسان والرب، تمكَّن الكاتب من تبيان العديد من آرائه ووجهات نظره، والوقوف على بعض المعاني المُهمة التي تجعل عالم القارئ من بعده أكثر ثراءً وعمقاً، وتجربته الوجودية أكثر حقيقة وقرباً من جوهره.
إنَّه كتابٌ بديع في الحقيقة.