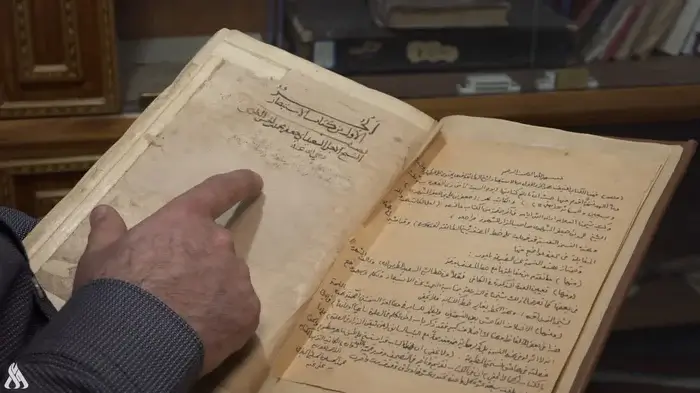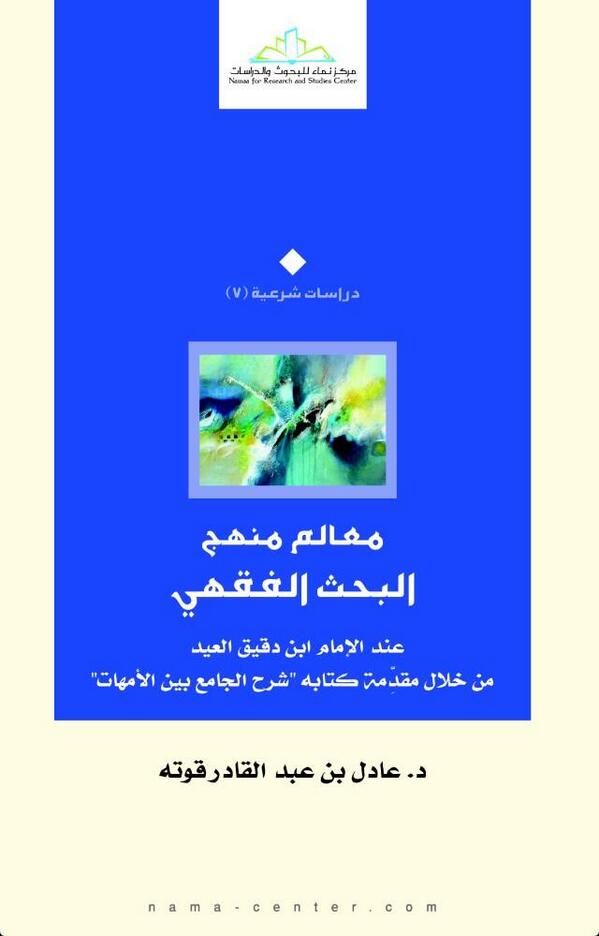– ننشر هذه المقالة ضمن برامج مبادرة إرث المتخصصة في تاريخ العلوم التراثية –
من الملاحظ أن نصوص المدونات الفقهية قد يُطوى فيها بعض المضمرات المعنوية، إما على جهة القصد، وإما على غير القصد. وهذه المضمرات تكون مستقرة في نفس المتكلم، ثم هو قد يستحضر عند وقوع المضمر في كلامه أن القارئ سيصل إليه دون الحاجة إلى الكشف عنه، وقد يقع منه الكلام على السجية دون قصد إلى الإضمار، بل يكون المضمر واقعاً على جهة غير الاستحضار.
وهذه المضمرات كثيرة في النصوص الفقهية، وتختلف بحسب الزمان والمكان، وكثيراً ما ترجع إلى ظروف سياقية للنص الفقهي، يكون العلم بها موجباً لمزيد من العلم بمقاصد النص.
والذي يقع عادة أن هذه المضمرات تكون جلية عند القارئ المفترَض للنص في الزمان الذي وجد فيه النص، ثم إنه، وبعد تعاقب الأزمنة وتبدل الأمكنة تتغير الظروف والسياقات إلى ظروف وسياقات مختلفة، فالقارئ الجديد للنص إذا أراد الكشف عن مقصود المدوِّن قد لا يصل إلى التحصيل الرشيد لمقاصده، ما لم يحاول استعادة الظروف والسياقات المفقودة.
وكثيراً ما تجد تحقيقات النصوص -والكلام هنا عن النصوص الفقهية- مشفوعة بمقدمات عن عصر المؤلف أو العصر الذي ألف فيه الكتاب؛ طلباً لتحصيل تصور عن بيئة النص وظروف المكان الذي وجد فيه، غير أن الملاحظ أن كثيراً من هذه المقدمات يكون دورانها عادة حول الظروف السياسية لعصر المؤلف مثلاً، أو تدور حول سياقات شديدة العموم بحيث لا تسعف في بيان خصوص الظروف المحتفة بالنص. ومع أن الظروف السياسية قد تكشف عن مضمرات النص الفقهي الذي دونت فيه، وخاصة ما كان من النصوص الفقهية في حقل الفتاوى والنوازل، إلا أن هذا المجال بالذات شهد نوعاً من التصعيد في الدراسات المعاصرة إلى مستوى لا يلاقي واقع القرون الماضيات.
وتتنوع طبيعة المضمرات المعنوية لنصوص الفقهية على وجه ربما لا يدخل تحت حصر، لأن الإضمار -كما سلف الإِشارة- لا يلزم أن يقصد إليه المصنف، بل ربما جرى منه الكلام على الاتفاق، ثم يوجد فيه أمور مطوية ومعان مضمرة، وإذا كان ذلك كذلك، وعلم أن ما لا يقصد لا حصر له، فكذلك المضمرات التي لا تقصد بالكلام لا حصر لها.
وسأضرب هنا أمثلة على نوعين من أنواع مضمرات النصوص الفقهية، هما: مضمرات الجدل الفقهي، ومضمرات السياق العام، موضحاً وجهَ وقوعهما فيها.
أولاً: مضمرات الجدل الفقهي:
يمكن أن نعد هذا النوع من المضمرات واحداً من أكثر المضمرات شيوعاً في النصوص الفقهية. وحقيقته ترجع إلى أن مبنى النص الفقهي قد يكون على وجهٍ قصد به الرد على المخالف، أو وضع على هيئة يُحَصِّل منها العارف بالقدر المضمَر وجهاً في الرد على خلاف فقهي، أو موقف صاحب النص من ذلك الخلاف.
ومن الأمثلة على ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بشأن موطأ الإمام مالك رحمه الله؛ فإنه قال عنه: (فإن الموطأ لمن تدبره وتدبرَ تراجمَه وما فيه من الآثار وترتيبَه علمَ قول من خالفها من أهل العراق، فقصد بذلك الترتيبِ والآثارِ بيانَ السنة والردَّ على من خالفها، ومن كان بمذهب أهل المدينة والعراق أعلم كان أعلم بمقدار الموطأ)[1]، ومن المعلوم أن هذه المعاني التي يشير الشيخ إلى قَصْدِ الإمام مالك قَصْدَها في الموطأ معانٍ لم يفصح بها مالك رحمه الله، وإنما تضمنها كتابه إضماراً، إما على جهة القصد، أو على جهة التبع، ثم إن كان على جهة التبع فلا يلزم أن يكون من مقصود مالك، وإنما يكون مالك قد وضع كتابه على ما جرى به العمل في المدينة، واستتبع ذلك الوضعُ النقضَ على أهل العراق ضرورة، وكان قد شُهر الخلاف بين المدرستين في ذلك الزمان، بحيث اختطت كل مدرسة طريقاً يلزم من سلوكه مفارقة المدرسة الأخرى في فروع كثيرة.
وكأن من مقاصد الإمام مالك بالموطأ بيان ما جرى به العمل في المدينة، ولذلك فقد ذُكر في سبب تأليفه له ما روي عن محمد بن أحمد بن عمرو القاضي المالكي، قال: حدثني المفضل بن محمد بن حرب المدني، قال: (أول من عمل كتاباً بالمدينة على معنى الموطأ من ذكر ما اجتمع عليه أهل المدينة عبدُ العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعمل ذلك كلاماً بغير حديث
قال القاضي: ورأيت أنا بعض ذلك الكتاب وسمعته ممن حدثني به، وفي موطأ ابن وهب منه عن عبد العزيز غيرُ شيء.
قال: فأُتي به مالك، فنظر فيه، فقال: ما أحسن ما عملَ! ولو كنت أنا الذي عملتُ لبدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام. قال: ثم إن مالكاً عزم على تصنيف الموطأ، فصنفه، فعمل من كان في المدينة يومئذ من العلماء الموطآت)[2]، فهذا يدل على طبيعة الموطأ، وأن من مقاصده بيان ما جرى به العمل في المدينة.
وعليه، فليس المقصود بالموطأ المذلَّلَ المسهلَ للناس كما يقوله بعض الناس، وإنما المراد به الموطأ على معنى ما جرى به العمل؛ فإنه يقال: هذا حديث موطوء، كما قال ابن أبي ذئب لما بلغه بعض الخلاف عن مالك: (هذا خبر موطوء بالمدينة)[3]، يعني مشهوراً معروفاً، كما أشار إلى ذلك ابن حزم[4].
وإذا كان ذلك كذلك فيكون مالك قد قصد بالموطأ بيانَ ما جرى به العمل من الأخبار، ولزم من ذلك وقوع الجواب عن خلاف أهل العراق، ثم لا يلزم أن يكون ذلك مقصوداً؛ لغلبة هاتين المدرستين في ذلك الوقت، لكن يبقى أن معرفة الخلاف الفقهي الدائر في ذلك الزمان يكشف عن مطويات الموطأ، ويفصح عن مخبوءاته.
وفي المقابل تجد محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة يورد نصَّ مالك في الموطأ في أكثر المسائل، ولا يصرح بأن ما نقله عن الموطأ، لكن هذا أقرب؛ فإن محمد بن الحسن يصرح بالنقل عن أهل المدينة، وأما مالك فلا يصرح بذلك أصلاً.
ومن الأمثلة على مضمرات الجدل الفقهي ما تجده في كلام الشافعي مما قد يظن الناظر إليه أنه فضلة إذا لم يعرف الجدلَ الفقهي الدائر في زمانه، وذلك كثير جداً في كلامه، وما أكثر ما تجد شراح المزني يفسرون بعض النصوص فيه بأن الشافعي قصد بها الرد على فلان، أو رمز به إلى الرد على فلان، ونحو ذلك.
ثم عدم العلم بالخلاف القديم قد لا يكون أثره قاصراً على التقصير في الكشف عن مخبآت النص، بل ربما أفضى إلى خفاء وجه الكلام، ومن الأمثلة على ذلك المسألة التي يلقبها الجويني بمسألة (الإصماء والإنماء)، وهي ما إذا أرسل الإنسان الصيد ثم توارى عنه ثم وجد الصيد مقتولاً، فقد قال فيها الشافعي رحمه الله: (وإذا رمى الرجل الصيدَ أو أرسل عليه بعض المُعَلَّمات، فتوارى عنه ووجده قتيلاً، فالخبر عن ابن عباس والقياس: ألا يأكله مِن قِبَل أنه قد يمكن أن يكون قَتَله غيرُ ما أرسل عليه من دواب الأرض، وقد سئل ابن عباس، فقال له قائل : إني أرمي فأصمي وأنمي، فقال له ابن عباس: (كل ما أصميت ودع ما أنميت)، قال الشافعي: ما أصميتَ: ما قتله الكلبُ وأنت تراه، وما أنميتَ: ما غاب عنك مقتلُه.
فإن كان قد بلغ وهو يراه مثلَ ما وصفتُ من الذبح، ثم تردَّى فتوارى أكله.
فأما إنفاذ المقاتل فقد يعيش بعدما ينفذ بعض المقاتل)[5].
وكلام الشافعي هنا بيِّنٌ، غير أن آخر جملة من كلامه: (فأما إنفاذ المقاتل…) قد لا تستبين على الوجه إلا بعد العلم بخلاف مالك رحمه الله؛ إذ يقول: (إذا أصابه ميتاً، وفيه أثر كلبه أو أثر سهمه أو أثر بازِه، وقد أنفذت هذه الأشياء مقاتِلَه فليأكله، إذا لم يفرط في طلبه، ما لم يبِت)[6]، فأناط الأمر بإنفاذ المَقاتِل، وأضمر الشافعي خلاف مالك، لكنه أجاب عن قوله بما أظهر، وغاية ما يُحَصِّله من كلام الشافعي مَن لم يعرف خلاف مالك أن يعرف استبعادَ الشافعي لأن يقال بهذا التفصيل، وأما أن يعرف مورِد الكلام ومصدره فلا.
ومن المعلوم -في هذا الصدد- أن البخاري رحمه الله كثيراً ما يقصد في صحيحه إلى الجواب عن الخلاف، خاصة في تبويباته، وخفاء الخلاف المتقدم قد يخفى به بعض مراده من التبويبات، بل إن بعض الكتب عقدها في صحيحه لبيان الحق في قضايا كانت مطروحة في عصره، ككتاب الحيل، وكتاب أخبار الآحاد.
وتجد في المتأخرين من أصحابنا الحنابلة مثلاً من يقول في باب زكاة الفطر: (ولا فرق بين أهل البوادي وغيرهم)[7]، والناظر في مثل هذه العبارة إذا لم يعرف الخلاف في المسألة سيمر بها مروراً دون وقوف على المطوي فيها من بيان الخلاف لمن فرق في وجوب زكاة الفطر بهذا الاعتبار[8].
وهذا كثير في كلام الفقهاء جداً، ولكونه كذلك، فقد يستدل به بطريق العكس أحياناً؛ إذ يتنبه الناظر إلى وجود الخلاف في المسألة عندما يظهر له في بعض العبارات أن فيها تأكيداً لطرد حكم معين، ونفياً للتفصيل، فيقع في نفسه أن في المسألة عند غير صاحب النص تفصيلاً، قبل أن يبحث ويصح له وجود ذلك بيقين، ومن هنا صار بعضهم يقول: إن (لو) في المتون إشارة إلى خلاف، وهذا قد يصح إلى حد ما، لكنه لا يطرد أولاً، ولا يختص بـ الـ (لو) ثانياً.
ولا أطيل بالتمثيل على ذلك، وإنما المقصود الإشارة إلى هذا النوع من المضمرات في النصوص الفقهية، وهو المضمرات العائدة إلى الجدل الفقهي.

ثانياً: مضمرات السياق العام
والمقصود بذلك أن السياقات والظروف والمحتفَّات بالنص الفقهي قد يكون لها تأثير في صياغته بحيث ينطوي في كلام المتكلم معانٍ لا تستبين إلا بمعرفة هذه السياقات. والسياق هنا هو السياق العام والظروف المحتفَّة بالنص، وليس المقصود به ما تضمنه كلام المتكلم في سباقه أو لحاقه.
ومن الأمثلة التي نجد فيها إعمالاً ظاهراً للسياق العام في الكشف عن المضمرات في النص الفقهي ما تناوله ابن تيمية من تفسير نص الإمام أحمد في مسألة الحمامات (وهي المُغْتَسَلات)، وذلك أنه قد روي عن أحمد رحمه الله كراهية بناء الحمام وبيعه وشرائه وكرائه، ونصوص أحمد هذه من ينظر فيها بالنظر الأول سيخلص إلى حملها على الإطلاق؛ لأنه لم يرد عن أحمد التقييد، وليس في منصوص كلامه ما يخصص عمومها، لكن ابن تيمية قصد إلى التفتيش في السياقات التي وردت فيها هذه النصوص؛ ليخلص بعد ذلك إلى أن الحكاية عن أحمد ينبغي أن تكون مقيدة باعتبارٍ، وإن كان ظاهر النص الإطلاق، فيقول شارحاً ذلك: (قد كره الإمام أحمد بناءَ الحمام وبيعَه وشراءَه وكراءَه… قلت: قد كتبت في غير هذا الموضع: أنه لا بد من تقييد ذلك بما إذا لم يحتج إليها، فأقول هنا:
إن جوابات أحمد ونصوصه:
(1) إما أن تكون مقيدةً في نفسه، بأن يكون خرج كلامه على الحمَّامات التي يعهدها في العراق والحجاز واليمن، وهي جمهور البلاد التي انتابها؛ فإنه لم يذهب إلى خراسان، ولم يأت إلى غير هذه البلاد إلا مرة في مجيئه إلى دمشق. وهذه البلادُ المذكورةُ الغالبُ عليها الحرُّ، وأهلُها لا يحتاجون إلى الحمام غالباً؛ ولهذا لم يكن بأرض الحجاز حمامٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حماماً ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. والحديث الذي يروى: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحمام) موضوعٌ باتفاق أهل المعرفة بالحديث. ولكن عليٌّ لما قدم العراق كان بها حماماتٌ، وقد دخل الحَمَّامَ غيرُ واحدٍ من الصحابة، وبني بالجحفة حمامٌ، دخلها ابن عباس وهو محرم.
(2) وإما أن يكون جوابُ أحمدَ كانَ مطلقاً في نفسه وصورة الحاجة لم يستشعرها نفياً ولا إثباتاً فلا يكون جوابه متناولاً لها، فلا يُحكى عنه فيها كراهة.
(3) وإما أن يكون قَصَدَ بجوابه المنعَ العامَّ عند الحاجة وعدمها، وهذا أبعدُ المحامل الثلاثة أن يحمل عليه كلامه؛ فإن أصوله وسائر نصوصه في نظائر ذلك تأبى ذلك، وهو أيضاً مخالفٌ لأصول الشريعة، وقد نُقل عنه أنه لما مرض وُصف له الحَمَّامُ. وكان أبو عبد الله لا يدخل الحَمَّام اقتداءً بابن عمر؛ فإنه كان لا يدخلها، ويقول: (هي من رقيق العيش). وهذا ممكنٌ في أرض يستغني أهلها عن الحمام، كما يمكن الاستغناء عن الفراء والحشايا في مثل تلك البلاد)[9].
وهذا كما ترى بحث في الإطلاق والتقييد يرجع إلى استحضار السياقات العامة والظروف التي احتفت بالنص الفقهي، ولم يستند الشيخُ إلى نص خاص من الإمام أحمد يقضي على إطلاق نصوصه بالتقييد، وإنما انتقل إلى البحث في المقيدات على الوجه الذي شرحه، ولذلك تجده يبحث فيما وقع في نفس الإمام أحمد، فيقول: (مقيدة في نفسه)، (مطلقاً في نفسه… يستشعر)، ونحو ذلك؛ إذ البحث هنا في أمور مضمرة، لا ظاهرة.
وهذا هو مُحصَّل القصد هنا، وهو التنبيه إلى ما يقع في نصوص المدونات الفقهية من مضمرات، يكون في إغفال الكشف عنها إهدار لشق كبير من دلالات تلك النصوص، والله سبحانه ولي التوفيق.
[1] مجموع الفتاوى20/ 372، وهي في رسالة صحة أصول أهل المدينة.
[2] التمهيد لابن عبد البر 1/ 407.
[3] العلل ومعرفة الرجال لأحمد 1/ 539.
[4] المحلى 7/ 238.
[5] الأم 3/ 595.
[6] المدونة 1/ 532.
[7] المبدع لابن مفلح 2/ 376، وتبعه عليها غيره، وهي بنحوها في الروض.
[8] وكأن ابتداء الإشارة إلى الخلاف في المسألة كان من ابن قدامة في المغني 3/ 83، ثم نجد مثل ذلك لدى ابن مفلح في الفروع 4/ 211، لكنه يزيد على من سماهم ابن قدامة.
[9] مجموع الفتاوى 21/ 301، 302.