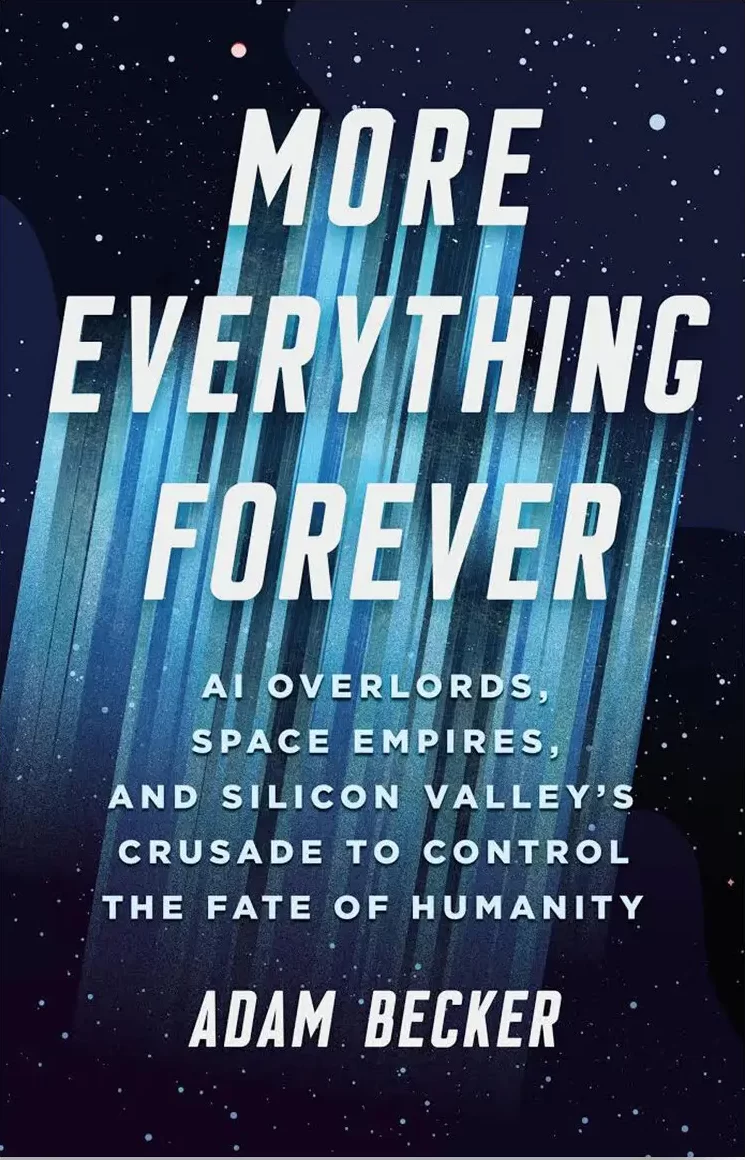«لم يسرّ أحد قطّ منكرة إلا ظهرت في آثار يده أو فلتات لسانه» أبو جعفر المنصور (ت158هـ)
«كل فلسفة كبيرة لا تعدو أن تكون -حتى يومنا هذا- اعترافًا يدلي به صاحبه» فريدريك نيتشه (ت1900م)
ظهرت في القرن العشرين كتب كثيرة تتناول حيوات الفلاسفة، ودقائق معايشهم الشخصية، وانشغل طائفة من الكتّاب بكشف خطاياهم، وإشهار حماقاتهم، كما فعل بول جونسون في كتابه المعروف (المثقفون Intellectuals) [صدر بالإنجليزية عام 1988م]، وأيضًا نايجل رودجرز وميل ثومبثون في كتابهما (جنون الفلاسفة Philosophers Behaving Badly) [صدر بالإنجليزية عام 2004م]، وكلاهما مترجم إلى العربية. والسمة البارزة في هذين الكتابين “الفضح” والتعرية، والهجاء المكثف، لاسيما وأن في حيوات جملة من الفلاسفة من المخازي ما يغري بذلك، وفي النفوس جواذب دفينة لتتبع ذنوب المشاهير والمبجّلين وقبائحهم، تتعزّى بها وتتعلّل عن سلوك سبل المعالي.
وفي سياق مقارب نشر عام 2015م الفيلسوف الفرنسي فرانسو نودلمان كتابه (عبقرية الكذب Le Génie du mensonge ) وقد صدرت ترجمته مؤخرًا عن دار صفحة سبعة، وهو يتناول “كذب الفلاسفة“، وعُني مؤلفه بطرح تحليل مطوّر لتناقضات حياة بعض الفلاسفة، وعلاقة نظرياتهم المركّبة مع حياتهم الشخصية، وتتبّع خطاباتهم الفلسفية لكشف ممارساتهم النظرية وسعيهم الدؤوب إلى «إعادة تطويع الواقع وتنسيقه».
ولابد لنا أولًا قبل المضي في الحديث أن نبرر هذا الاهتمام بالفلاسفة: لماذا الحديث عن كذب الفلاسفة؟ ولماذا هذا التدقيق والتنقيب عن الخطايا الشخصية لدى هذا الصنف من الناس؟ الجواب يكمن في حقيقة خطرة وجوهرية، وهي أن اللغة الفلسفية والخطابات التجريدية «توهم بوجودها المستقلّ عن الذوات التي شيّدتها»، فهي تشعر الدارس لها بنقاء أسطوري، وأصالة مزعومة، وتكرس قدرًا واسعًا من اشتغالها التأويلي للبرهنة على عموميتها النظرية، وعمق “موضوعيتها” المعرفية، وفي طريقها لاستئصال «المصالح الشخصية من اللغة لكي تقدم ذاتها في صورة الحقيقة الكونية التي لا تحمل اسمًا خاصًا، وعبر الإنكار للدوافع الذاتية التي تستند إليها؛ تشجّع على الكذب»، أي مناقضة حقيقة الذات تحديدًا، ولذا فإن تأمل أفكار الفيلسوف والكاتب ومقارنة توكيداته مع نمط حياته وسلوكه الشخصي وعقده الذاتية يكشف أحيانًا عن ظواهر لافتة تتجلى في صورة تناقض فجّ، أو مفارقة ملحوظة، أو كذب سافر.
يحاول نودلمان أن يتجاوز إغراء الرغبة بالفضح والإدانة والتشهير، إلى تبني مسار التحليل والربط والتعليل، أي إلى تعميق الفهم للأطروحة الفلسفية أو النظرية بوضعها أمام مرآة السلوك الشخصي لمنتجها، لاسيما وأن ما يمكن وصفه بالكذب أو التناقض في أفكار الفيلسوف وسلوكه لا يلزم أن يكون بالضرورة سلوكًا قصديًا واعيًا؛ «فالكذابون لا يعلمون دومًا أنهم يكذبون، لا سيما عندما تنطلي الخديعة على الآخرين، وعليهم هم أنفسهم في الوقت عينه» كما يقول، وهذا يصعّب المهمة في اكتشاف الكذبة التي من هذا النوع؛ لأن «أصعب ما يمكن اكتشافه من الأكاذيب هو الكذب الذي يثيره المرء تجاه نفسه دون أن يدرك بواعثه بوضوح»، وللأسف –كما يقرر أحد النفسانيين- فإن «القدرة البشرية على التخيّل تجعلنا قادرين على الحلم، وعلى صنع عوالم بديلة من وحي خيالنا، وهذا هو المصدر الأساسي لقدرتنا الإبداعية، لكن هذه القدرة الفريدة تأتي مصحوبة بنقيضها، أو الوجه الآخر للعملة: إذ يمكننا أن نخدع أنفسنا، والآخرين، ونتوهم أن الأمور على خلاف الحقيقة التي نعرفها، ونتصرف وفقًا لذلك».
ولاتساع مجال الموضوع اختار نودلمان حفنة قليلة من الفلاسفة الفرنسيين لإخضاع نتاجهم لهذه العملية التحليلية الكاشفة، وبيّن في البداية ملامح الطريقة التي تثير الريبة في خطاب “الكاذب”، والتي يتبعها –بقصد أو بدونه- لتشييد عالم متماسك ومنطقي، وتتمثل -عادةً- في الإلحاح والمبالغة والإعادة والإسهاب والاستفاضة لتأكيد قول “الحقيقة”؛ «فالإصرار، والتكرار، والشرح الذي لا ينتهي للفكرة يصدر عن صراعٍ مستعصٍ، فثمة شيء غير قابل للصياغة إطلاقًا، وهو ينخر في روح المتكلم حتى يبلغ مراتب الهوس»، وهو أيضًا نتيجة «نشاز معيشي في الوقت الحاضر، بل صراع معاصر بين ما يُقال وبين ما يُقصد به»، وليست الغاية هنا تأكيد التناقض بين النظرية الأخلاقية والممارسة المنافقة، بل ما هو أبعد من ذلك، حيث يتجلى الكذب أو النفاق اللاواعي في انبناء النظرية على السلوك بنحوٍ ما، فليست القضية أن الفيلسوف يقول شيئًا بينما يفعل خلافه، بل أن الفيلسوف إنما يقرر نظريته تلك على هذه الكيفية أو تلك؛ لأنه يعيش بصورة تناقضها!، والمؤلف يحاول بذلك تخفيف الإدانة الأخلاقية المتضمنة في الوصم بالكذب، وتغليب الأدوات التحليلية لسبر البنية النفسية المعقدة التي تقف خلف هذا “الكذب”.

يشير أولًا إلى جان جاك روسو (ت1778م)، وهو هدف مهم وسهل للكثير من الكتّاب في هفوات الفلاسفة، وهو يشتهر بتمجيد الحقيقة، ويكتب مئات الصفحات من “الاعترافات” بالحقيقة، ولأجل خدمتها، ثم يعود بعدها ليكتب كتابًا خاصًا بعنوان (روسو يحاكم روسو) ويدافع فيه بضراوة عن الاتهامات الموجهة ضده، كالسرقة والاحتيال والخلاعة والتجديف، إلا أنه يتجاهل تمامًا حقيقة ساطعة في حياته، وهي خطيئته الكبرى بتخليه عن أولاده الخمسة وتركهم في أحد الملاجئ، ويتعامى عن ذلك ليصف نفسه بالكائن الأخلاقي، بل يطبع على خاتمه عبارته المفضلة للشاعر الروماني جوفينال “نذر حياته في خدمة الحقيقة”.
كيف تصرف روسو حيال هذه المفارقة (من غير قصد واضح ربما)؟ لقد عكف على تصنيف كتاب ضخم بعنوان (إميل أو التربية Émile ou De l’éducation) ونشره عام 1762م يقدّم نفسه من خلاله باعتباره منظرًّا تربويًا، وأبًا مميزًا، وخبيرًا في شؤون الأطفال، وقد واجه الكتاب هجومًا وتهديدات جعلت روسو يهرب إلى سويسرا، ومع هذا الهجوم تصاعد هذيان روسو وهوسه بوجود مؤامرة عالمية ضده، وهو يتوهم أن هذا الهجوم سببه أفكاره حول تربية الأطفال، فيبالغ في الدفاع عن هذه الأفكار، ويصطبغ خطابه في هذا السياق بطابع درامي في الانتصار للحقيقة. كان الوهم المضمر يدفعه للاعتقاد بأن الاعتراف به مربّيًا بارعًا سيمحو تهمته بكونه أبًا فظيعًا، يرمي بلا مبالاة أطفاله الخمسة ولا يعود إليهم أبدًا، «وهكذا فإن الأوهام الذهانية لروسو –المقتنع بأن العالم أجمع ينحي عليه باللائمة بسبب تخلّيه عن أطفاله- تنتهي به إلى وضع بحث تربوي يصوّر نفسه فيه كمربٍ حنون!»، وكما بالغ هنا، بالغ أيضًا في تقديم خطاياه والاعتراف بها؛ «فالإفراط في الاعتراف بذنوبه ما هو إلا وسيلة يحرم بها الآخرين من توجيه اللوم إليه».

ننتقل إلى فيلسوف معاصر بارز، وهو ميشيل فوكو (ت1984م)، والذي اشتهر بـ”حفرياته” عن الحقيقة، وفضح بنى السلطة وسياساتها وأنظمتها المعرفية، وقد قدّم عدة محاضرات مهمة في آخر حياته في جامعة بيركلي ثم في الكوليج دو فرانس بعنوان (شجاعة الحقيقة)، وفي هذه المحاضرات –في انعطافة مثيرة للتأمل- انتقل فوكو من تحليل ما يسميه (السياسة الحيويةbiopolitics ) إلى نوع من المقاربة الأخلاقية لضبط الذات ومراقبة النفس، وفحص الحالات المؤسسية التي تستوجب قول الحقيقة، كما في الإقرار القضائي والاعتراف الكنسي، مع الاهتمام بحيوات الفلاسفة وأنماط سلوكهم وعلاقته بأطروحاتهم النظرية.
وفي أثناء تفكيك مفاهيم الشجاعة الفلسفية لا سيما في نموذج سقراط، والذي يعدّ أشهر أنموذج للفلسفة الشجاعة التي تقف شامخة على أعتاب الموت، كما في حديث سقراط قبيل إعدامه، في أثناء حديث فوكو المسهب عن كل ذلك كان فوكو يخفي -بل يكبت بقوة- حقيقة ضخمة ستنهي حياته، وهي أنه كان حينها يعيش آخر أيامه، بعد تأكد إصابته بالإيدز، نتيجة ممارساته الجنسية الشاذة، الممزوجة بالسادية والمازوخية المقززة، وكما يقول دنييل ديفير زميل فوكو فإن الهاجس الذي كان يشغل فوكو حينها هو معرفة كم تبقى له من وقت في هذه الحياة، فقد كان يلقي محاضرته الأخيرة مقدِّمًا «مسرحية فلسفية يؤدي فيها دوره الخاص بطريق الوكالة، وقد كان –في الوقت الذي يشيد فيه بجسارة الحقيقة- يعمل على [إخفاء] سرّه المتعلق بإصابته بالإيدز. لقد أنتج هذا الإنكار إقرارًا مفارقًا، واعترافًا مقنعًا بالخصال المهيبة لفلاسفة العصور الغابرة»، لقد كان «يعيد تجسيد السيناريو السقراطي مناقضًا نيتشه، ولكن من دون التصريح بذلك!».

ويتتبع المؤلف فيلسوف معاصر آخر وهو جان بول سارتر (ت1980م)، من خلال فحص أطروحاته من بدايته الأدبية والروائية وحتى شهرته وتحوله لمنظر ومؤثر في أعقاب الحرب الثانية، حيث تحوّل سارتر إلى اعتناق راديكالية سياسية، بعد مواقف رخوة وأفكار تميل إلى التسوية أثناء الحرب، ليطور بعد ذلك موقفًا أخلاقيًا قويًا عن “التزام” المثقف، أي ضرورة مفارقته للحياد، واعتقاد مبادئ تغييرية للدفاع عن الإنسان وحقوقه، ويفسّر الفيلسوف الفرنسي فلاديمير يانيليفيتش (ت1985م) هذا الانقلاب الواضح بأنه «ينبع من شعور سارتر بالذنب من كونه لم يرتق إلى مستوى المقاومة الحقّة»، فالانخراط في الحراك السياسي ودعم المضطهدين بصوت عالٍ بعد الحرب كان بمثابة الاعتذار. (في اقتباس معروف ينسب لسارتر ولم أجد مصدره، يقول فيه: “كان يُحب أن يُريها لوحات جميلة، وأفلامًا جميلة؛ لأنه لم يَكُن جميلًا، وكان ذلك بمثابة الاعتذار!”).
وهذا الحماس الأخلاقي للالتزام يصل إلى درجة المزايدة أحيانًا كما كتب سارتر في افتتاح مجلته الشهيرة “الأزمنة الحديثة” عام 1948م أنه يعتبر كلًا من فلوبير وغونكور «مسؤولين عن القمع الذي أعقب كومونة باريس [عام 1871م]؛ لأنهما لم يكتبا سطرًا واحدًا يحول دون ارتكابه!». ومع ذلك لم يكن سارتر مخادعًا نفسه طوال الوقت، بل اعترف لسيمون بوفوار في عام 1974م بأنه «يكاد أن يكون منتحلًا لسمعته كمقاوم»، وفي المحصلة نجد أن سارتر –بحسب نولدمان على الأقل- الذي «قضى فترة الحرب دون بطولة تذكر؛ قد أصبح أيقونة الالتزام، مستنكرًا تواطؤ أولئك المفكرين الصامتين أمام ارتكاب المظالم والجرائم»، وهنا تكمن المفارقة، حيث تعكس الأطروحة النظرية تفاعلات نفسية متناقضة تحاول التغلّب على الإخفاقات الذاتية أو محوها أو تجاوزها.

كثيرًا ما يصحب اسم سارتر صاحبته المنظرة والأديبة سيمون دي بوفوار (ت1986م)، والتي اشتهرت بكتابتها واحدًا من أشهر النصوص النسوية في القرن العشرين المعنون (الجنس الآخر Le Deuxième Sexe) الصادر عام 1949م، والذي كان من الأدبيات الرئيسية لما يسمى “الموجة النسوية الثانية”، وفيه تناضل بوفوار ضد “الأيديولوجيا” الأبوية والاعتقاد الجندري الذكوري، وترفض الاستسلام للربط بين سمات الجسد العضوية (كالحمل والإنجاب) والوظائف المرتبطة بها، والتي تحجّم من “تحرر” النساء، و”تخضعهن” لاعتقاد مزعوم بطبيعة أنثوية حتمية، في حين أن هذا الاعتقاد ليس سوى دور اجتماعي مصنوع، فـ”المرأة لا تولد امرأة، بل تصبح كذلك” بسبب المجتمع، إلى آخر هذا النوع من الأفكار الأيديولوجية التي تحوّلت إلى كليشيهات شعبية في العقود اللاحقة. ولكن ما مدى تناسق عقيدة بوفوار الجذرية مع سلوكها الفعلي؟ أو ما تأثير حياتها الشخصية في تبلور هذه النظرية؟
بعد وفاة بوفوار بعدة سنوات تكشفت حقائق جديدة، ففي عام 1997م نشر الكاتب الأمريكي نيلسون ألغرين مراسلاته الكثيرة مع بوفوار، والتي تبلغ قرابة 300 رسالة غرامية على مدى 17 عامًا، وتضمنت تناقضًا فجًا مع كل ما تؤمن به بوفوار وما تدافع عنه، ففي أواسط الأربعينات سافرت بوفوار إلى الولايات المتحدة لإلقاء عدة محاضرات جامعية، وهناك التقت بألغرين، ونشأت بينهما صلة غرامية طويلة، نتج عنها هذا الكم من المراسلات، وفي بدايتها تقول له أنها تعبت بعد مجيئها إلى شيكاغو من كثرة النقاشات والجدل النظري، وأنها «تتوق إلى أن يُنظر إليها بوصفها امرأة لا مفكّرة»، وتواصل كتابة رسائل شديدة الحميمية عن ولهها المفرط وعشقها الجارف لهذا الرجل، تكتب له مرةً «إنني راضية بما أعانيه بسببك»، و«أنا أشعر طوال النهار أنك ساكن جسدي وقلبي وروحي. أنا ضفدعتك الصغيرة العاشقة»، ثم يتطور بها الحال فتقول: «ما زالت سعادتي هي في أن أكون بين ذراعيك… لقد قضي الأمر، وقد أسقط في يدي، وعلى أن أتقبّل هذه التبعيّة، وأنا راضية بذلك طالما أنني أحبك!»، في عبارة استسلامية لا تتناسب إطلاقًا مع النزعة الاستقلالية التحررية المعهودة في مرافعاتها النسوية، بل تتعهد لعشيقها بأن تكون «لطيفة للغاية، ومحتشمة للغاية، ومطيعة طاعة المرأة العربية!» (ولنغض الطرف هنا عن هذه اللمحة الاستشراقية)، وتقول: «سوف تراني أنظف المنزل، وأعدّ جميع أنواع الطعام».
يحاول نودلمان تفسير هذا التناقض/الكذب في أفكار وحياة بوفوار (بل إنه وفي أثناء غراميتها المشبوبة كانت تخبر عشيقها عن مشاريعها الكتابية النسوية)، ويرى بأن أطروحتها النظرية هي محاولة للتغلّب على فخّ الغرام الجامح الذي لم تستطع تفاديه، فقد كانت تجازف بفقدان حريتها في تجربة العشق التي تخوضه بضراوة مع ألغرين، ثم تستدرك الأمر بإخضاع التجربة للتحليل العقلي، والمحاكمة الأدبية، والتأويل التاريخي، وهذا ما أفضى إلى تضخّم حجم كتابها “الجنس الآخر” (في الترجمة العربية يقع في جزئين وفي قرابة 800 صفحة)، «فضخامة هذا الكتاب تقف شاهدًا على الصراع النفسي بين التجربة العاطفية، والرغبة في ضبط النفس من خلال الكتابة النظرية» كما يقول نودلمان، فالكتابة في هذه الحالة لا تقصد خداع القرّاء بالأساس، بل تهدف –ربما من غير وعي- إلى خداع الذات والكذب على النفس، لاسيما حين تصف في كتابها “قوة الأشياء” علاقتها بألغرين باعتبارها الطرف المستقل والمسيطر في العلاقة!

قد يفوت البعض إدراك التأثير الجوهري للصدق في البناء الأخلاقي للإنسان، فليس الصدق مجرد فضيلة أخلاقية، ولا الكذب حماقة هامشية يمكن غضّ النظر عنها، بل الأمر أعظم من ذلك، فالصدق لا سيما بمفهومه الواسع الذي يشمل الصدق في القول بمطابقة الكلام للواقع، والصدق في الاعتقاد بثبوته في القلب، والصدق في الأفعال بإتمامها على وجهها؛ كفيل بتغيير مجمل حالة الفرد الأخلاقية، وهو أعظم الطرق الموصلة إلى كمال الصلاح والخير والفضيلة، كما قال صلى الله عليه وسلم (إنّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ)، ومن جرّب تحرّي الصدق التام في جميع ملفوظه صَغُر أو كُبَر؛ لابد وأن تصدق أفعاله، وتستقيم له جوارحه، بل تصلح له سائر أحواله.
فإن قلت: وكيف يكون ذلك؟ فيقال قد أجاب عن ذلك الشيخ عبد الحميد بن باديس (ت 1359هـ) رحمه الله، فذكر أن آثار تحرّي الصدق في سائر العمل تتبيّن من وجوه، (وإن كان بعضها أوضح من بعض):
الوجه الأول أن الارتباط بين أقسام الصدق (صدق اللسان والقلب والجوارح) وثيق وعميق، ويعود إلى أصل واحد، بل «يكاد من التزم بعضها أن لا يفارق الآخر»، فصدق اللسان فرع عن صدق القلب، وصدق الجوارح فرع عن صدق اللسان، وإذا نظرت في دوافع الكذب والتي تتمحور –بحسب بعض الباحثين المعاصرين- حول أربعة دوافع أساسية: الأول لتحقيق المصالح، الثاني لتجنب العقاب، الثالث لتفادي الاحراج، الرابع لتقديم انطباع حسن لدى الآخرين، فسترى أنها تتولد عن تعظيم أمر الخلق، وتطلّب الجاه فيهم، وضعف لحْظ مراد الخالق، ومراعاة يوم الحساب، فعاد ضعف تصديق القلب على الجوارح بالنقص والخلل، ولو كمل صدق القلب لما عَظُم في نفس المرء كلام الناس وأنظارهم.
والوجه الثاني: «أن التزام الصدق يحمل على الوفاء بالعقود والعهود والوعود في معاملة الناس؛ فتجري أعمال المرء مع غيره على سداد واستقامة».
والوجه الثالث –وهو معنى لطيف-: «أن الملتزم للصدق يُمسك نفسه عن أعمال السوء مخافة أن يُسأل عنها فيصدق فيجرّ على نفسه سوءًا أو يكذب، وهو لا يرضى مواقعة الكذب فتجري أعماله على البر سالمة من الفجور، والملتزم للكذب الضاري عليه يرتكب العظائم، ولا يبالي أن ينفي عن نفسه كاذبًا»، وقد سبقه إلى هذا المعنى الإمام ابن العربي (ت543هـ) رحمه الله فقال: «الصدق هو الأصل الذي يهدي إلى البر كله؛ لأن الإنسان إذا تحرّاه لم يعصِ أبدًا، لأنه إذا أراد أن يسرق، أو يزني، أو يؤذي أحدًا خاف أن يقال له “زنيت أو سرقت”، فإن سكت جرّ الريبة إليه، وإن قال: لا؛ كذب، وإن قال نعم، فسق، وسقطت منزلته، وذهبت حرمته». وقد لاحظ الإمام أبوعبدالله الحليمي (ت403هـ) رحمه الله أن خصال النفاق المذكورة في حديث (علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان) «إذا تؤمّلت كان مرجعها جميعًا إلى الكذب»، فأصل النفاق بُني على الكذب، كما روي عن الحسن.
وأزيد وجهًا رابعًا حاصله أن تحرّي الصدق حسنة جليلة، والحسنة تجرّ أختها، ولأجل ذلك يقع تتابع الحسنات في عمل القلب وسائر الجوارح؛ فـ«الاعتياد بكل خصلة حسنة يجرّ إلى غيرها، كما أن الاعتياد بالقليل من شيء يجرّ إلى كثيره»، كما أشار بعض الشُرّاح.
أما الكذب فهو يفسد النفس، ويوجب اضطراب الذات، ويورث فيها العلل، ولذا يعوّل المعالج النفسي جوردن بيترسون على الصدق في تحقيق الحياة الطيبة والسواء الداخلي للفرد، ويحلل المنزلق الذي ينتظر الكاذب، فيفضي به إلى أبعد بكثير مما يظن، يقول: «أولًا، يكذب المرء كذبة صغيرة؛ ثم يتبعها بعدد من الكذبات الصغيرة التي تدعمها. وبعد ذلك، يأتي دور التفكير المشوّه الذي يهدف إلى تجنّب الشعور بالخزي الناتج عن تلك الكذبات، ثم يضيف بعض الكذبات لتغطية تبعات التفكير المشوّه. ثم يحدث أفظع ما في الأمر كله؛ وهو تحوّل تلك الكذبات -التي صارت ضرورية الآن- من خلال الممارسة؛ إلى اعتقاد وفعل تلقائيين، منهجيين، موجهين عصبيًا على مستوى “اللاوعي” لتحقيق غرض محدد. وبعد ذلك، تُخفق التجربة المقززة ذاتها كفعل عماده الزيف في تحقيق النتائج المنشودة… ثم يأتي دور الغطرسة والشعور بالفوقية اللذين يصاحبان حتمًا إنتاج كذبات ناجحة؛ وأخيرًا، تأتي هذه الفرضية: “الكينونة ذاتها عرضة لألاعيبي؛ لذا فهي غير جديرة بالاحترام”»، وهذه الآلية المتتابعة صيغة من صيغ الدوامة النفسية التي يقع فيها الكاذب، وهناك مسارات أخرى أكثر تعقيدًا، وكلها تكشف عن دور الكذب في تشويه صورة الواقع، الواقع الخارجي، ثم واقع الذات، ومن ثمّ الاصطدام الدامي مع حقائق الوجود، التي لا تتغير بالاختلاق والمخادعة، فإنكارك الشفهي لوجود الحائط لا يهدمه، وفي آخر المطاف لا يبقى للكاذب إلا المرارة الحتمية الناجمة عن فشله الدائم في تشويه وجه الحقيقة.