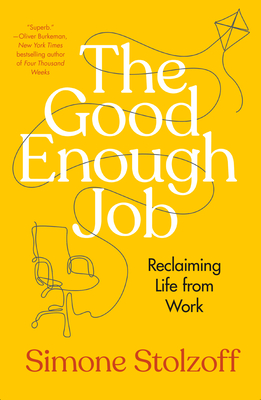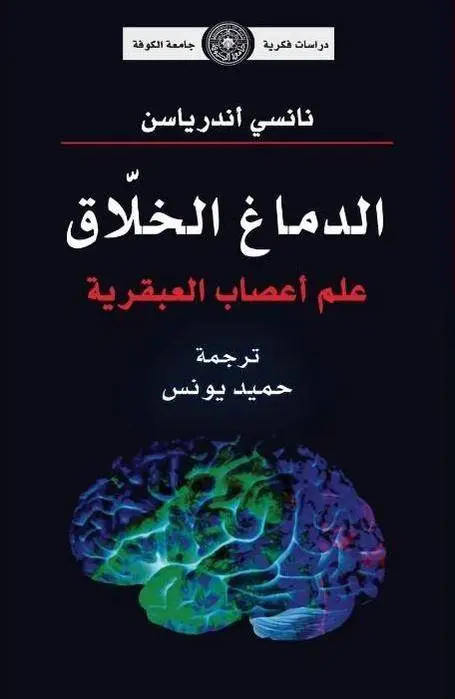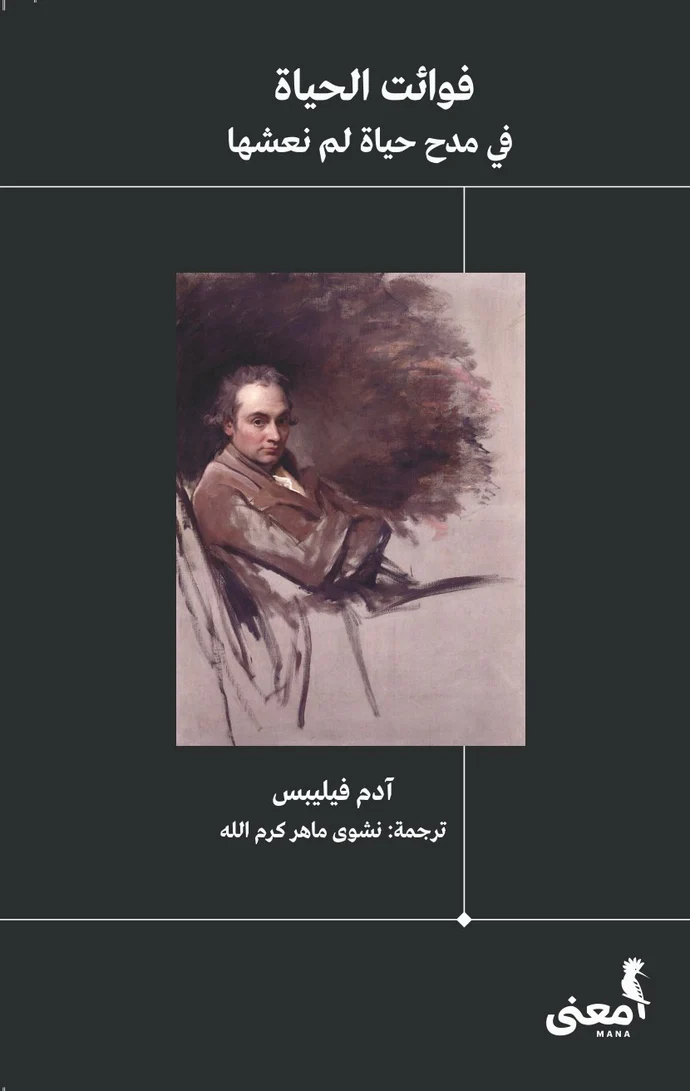يرى محمد الشيخ أن الفلسفة العربية كأنموذج، مقتصرة على عدد معين من الأشخاص لا يزيد عددهم عن الستة، فكأن هناك من قرر أولاً أن هؤلاء الستة عليهم مدار الفلسفة العربية، ثم جاء من بعدَه فصار مقلداً للأول، فاستقرت الأذهان أن الفلسفة العربية محصورة في هؤلاء، وإلا فإن التراث العربي مليء بالفلاسفة ومليء بالنصوص الفلسفية التي تتجاوز هؤلاء الستة وتفيض عنهم، وهذه قاعدة شبه ثابتة في بقية العلوم، يكاد ينحصر كل علم في أعلام معينين ونصوص معينة، تكون وظيفة الخلف النقل عن السلف فقط، والمتميز منهم من يتبحر خارج الأسماء المحددة والنصوص المقلدة، فيبصر أشياء جديدةً منعَ التقليد من ظهورها، وكان هذا هو الذي ميّز محمد الشيخ في كتابه، إذ لم يعمد إلى نقولات تكررت في الكتب حتى كأن بعضهم ينسخ من بعض، إنما توسّع إلى نصوص كأنها تقرأ لأول مرة، والفضل في ذلك يعود إلى قراءة موسعة مع الخروج من ربقة التقليد، ولذا تجد من تميز من المثقفين هم أولئك الذين خرجوا من ربقة تقليد الكتب المقروءة عند جيلهم إلى أخرى كانت قد أهملت وطمرها النسيان.
يشكو المؤلف من أن مشكلة العرب الثقافية اليوم أنهم ما استطاعوا أن يثمّروا هذا التراث العظيم الذي امتلكوه وما تملّكوه، فبالأحرى أن يجعلوا منه تراث العالمين. وهذا محل نقاش: قدَّم العرب نماذج، لكن نماذجهم خدمت من قبل غيرهم، فثوروها وطوروها كفلسفة ابن رشد، وحتى ما كان محل اهتمام منا كفكر ابن تيمية بقي محل استفادتنا منه اقتباساً وتقليداً، وليس نظراً للفكرة التي بنى عليها ابن تيمية وتطويرها بما يتناسب مع الوقت الراهن.

اهتدى المؤلف إلى موضوع الكتاب بعد أن حاول استقصاء أثر التراث العربي فيما يُكتب اليوم من كتب ذات صيت عالمي، فالاستشهاد مقصور على أعلام الغرب، وأما أعلام العرب الذين إما سبقوا إلى هذه الفكرة أو طوروها مهمل، هناك حلقة عربية مفقودة فيما يكتب من مواضيع فكرية وفلسفية في غرب اليوم.
إن قصد المؤلف من هذا العمل أن يوفّق إلى تنبيه القارئ إلى ما تضمنه التراث العربي من آفاق انفتاحية تجعله يحتل بحق مكانة متميزة في التراث العالمي، ويكون عدةً وعوناً على مواجهة العولمة الثقافية العاتية.
وقصد آخر هو أن يفلح هذا الكتاب في تشويق القارئ العربي إلى قراءة كتب التراث والمصالحة مع هذه الكتب التي كادت تصير مهجورة.

قسّم المؤلف كتابه إلى كتب، مبتدأً بكتاب الإنسان ثم الصداقة مرور بكتابي الحواس والقراءة، حتى يختمه بكتابي الشهرة والموت. وفي إفراد كل موضوع بكتاب تنويه إلى أنه يصلح أن يقرأ كل كتاب منها منفرداً برأسه، وأنك إن قرأت الكتاب من أوله أو وسطه أو آخره فكله سواء، مع كون ترتيب الكتب ترتيب موضوع ومنطقي.
مع كثرة الاقتباسات في الكتاب (وهي في الأصل عموده وأساسه) إلا أن المؤلف برع في نسجها مع كلامه، وكأنه كلام متصل، لا تكاد تميز بينه إلا بعلامات الترقيم.
أحسن المؤلف حين أورد بعض عناوين الكتب المتعلقة بكل موضوع تحدث عنه وذلك نهاية كل كتاب.
يميل المؤلف إلى ملاينة الصوفية، وترجيح أقوالهم أحياناً.
يسير المؤلف في كتابه على إيراد القولين والحجتين والنظرتين في غالب مسائل الكتاب.
من فوائد الكتاب:
يقول المؤلف: أكاد أجزم أنه ما خَص حكيم عربي (الإنسان) بكتاب قدر ما فعله الراغب الأصفهاني. قصدت بذلك كتابيه تفضيل النشأتين وتحصيل السعادتين، وكتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة. وقد نبعت من هذين الكتابين نظرية في (الإنسان) بديعة لعلها ما وجدت في التراث العربي الإسلامي نظريةً أشمل منها ولا أكمل، إن لم تكن تبزّها فعلى الأقل تشبهها.
تحدث المؤلف عن الصلة بين العزلة والسويدائية وصلتهما بالتفكير، ممن ننظر إليهم على أنهم غريبو الأطوار، ولديهم حالة خاصة، وأخاف أن يدعيها من يدعي التثاقف، كما يتقحّم بعض منهم العزلة وهو لا يستطيعها، وهذا شأن كل ضعيف نفس يحب أن يتصنّع ما يقرأه في الكتاب مما هو من سمات الأكابر والعلماء، وهم لم يتصنّعوها، إنما هي حالة غالبة عليهم ليس بيدهم دفعها، أو شيء حُبب إليهم. لما بلغ عبد الرحمن السيوطي الأربعين سنة من عمره، أخذ في التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله، والاشتغال به صرفاً والإعراض عن الدنيا وأهلها كأنه لم يعرف أحداً منهم، وشرع في تحرير مؤلفاته، وترك التدريس والافتاء، داوم على هذه الحال إحدى وعشرين سنة حتى توفي.
يقول المؤلف: ذهب هايدغر إلى من شأن التسودن أن يكون مسحة أصيلة تعتري كل فكر وإبداع، وما كانت من قبيل “المرض النفسي” العرض الطارئ، وإنما هي ناجمة عن تحمّل مشاق الفعل الإبداعي الأصيل الذي يكون على صاحبه كالعبء الثقيل.
يقول المؤلف: الحق أن فكرة المشيخة كانت أحد أهم الأبواب التي نفذ منها التقليد إلى جسم الثقافة العربية. انتهى كلامه.
فكرة المشيخة صائبة في القدوة والدلالة والتوجيه والاستشارة، لا في التحكم والسيطرة، ومنها نتج التعصب والتقليد والفكرة المكررة.
في كتاب الحيرة تعرض المؤلف لأنواع السؤالات، ومنها السؤال المُتهِم، وهو نوع من الأسئلة كان أبو حيان التوحيدي يجيد طرحه، ومنها: سؤال التعصب الديني: لمَ صار الإنسان إذا صام أو صلى زائداً عن الفرض حقّر غيره، واشتط عليه، وارتفع على مجلسه، ووجد الكبر في نفسه، وطارت النعرة في أنفه حتى كأنه صاحب الوحي، أو الواثق بالمغفرة، والمنفرد بالجنة، وهو مع ذلك يعلم أن العمل معرض للآفات. أترك الإجابة إليكم.
في كتاب الحواس يقول ناقلاً: الراغب في شيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه فشدت الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو عليه، كم قيل:
هويتك إذ عيني عليها غشاوة
فلما انجلت قطّعت نفسي ألومها
يقول المؤلف في كتاب القراءة: واستعفوا من جلائل المهام ونفائسها لا لغاية سوى التفرغ للقراءة. انتهى كلامه. وإن أحذّرك من فعل هذا فقد سبق من خُذل بهذا الفعل فلا تقربنّه.
وقال أيضاً في نفس الكتاب: كان البعض منهم يداري بعض ما قد يعتريه من سأم المطالعة بالمطالعة ذاتها، فيداوي ضجر القراءة بالقراءة.
يقول في كتاب الكتابة، حين ذكر طرفاً من أخبار من كتبوا في السجن، إذ يقول: وقس على ذلك حالة العلامة أبي بكر السَّرَخْسي، فقد ذُكر عنه أنه أملى المبسوط نحو خمس عشرة مجلداً وهو في السجن بأوزجند، كان محبوساً في الجب بسبب كلمة نصح بها الخاقان (لقب لكل ملك من ملوك الترك والتتار)، وكان يملي من خاطره من غير مطالعة كتابٍ وهو في الجب وأصحابه في أعلى الجب، وقال عند فراغه من شرح العبادات: هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات إملاء المحبوس عن الجمع والجماعات، وقال في آخر شرح الإقرار: انتهى شرح الإقرار المشتمل من المعاني على ما هو من الأسرار إملاء المحبوس في محبس الأشرار، ولما وصل إلى كتاب الشروط حصل له الفرج.
يقول المؤلف في ذات الكتاب: قد يحدث أن يفقد الكاتب موهبته وسط التأليف، ولعل من أسباب هذه الظاهرة الكتابية الفريدة ما سمّاه العرب “ضيق العطن في التأليف”، ومعناه اضطرابُ تعجّل المزاج بما لا يفي بالصبر على التأليف.
رصد التراث لنا طرقاً في طلب الشهرة وأبان عوارها، منها: طلب الشهرة بمدح الأموات:
المرء ما دام حيّاً يُستهان به
ويعظُم الرزء فيه حين يفتقد
ومنهم من اتخذ من تعلم العلم وتعاطيه وسيلة للاشتهار، ومنهم من وجد أن شهوة الكلام هي ما يتسبب للناس في الشهرة، ومنهم المتقلّب في أعطاف المذاهب والأفكار طلباً في الاشتهار، ثم تحدث عن أن الغنية بنفسه الكامل بها لا يحتاج إلى مدح أحد ولا ذمه، بل هو جارٍ في طريق عدم المبالاة ميمماً وجهه نحو قصده، لا يلوي عنقاً لمادح ولا يطرق نظراً لقادح.