لمَّا كان مطلع استحسان الحسن في هزَّة الطرب التي تسري في نفس المستقبِل عفوًا دون تكلُّفٍ واستنطاق؛ كان التذوُّق مفتاح باب الجمال –في النفس والكون– ومهمازُ حسن استيعابه واستثماره من بعد سريان الحياة فيهِ عبر وسيط اللغة. ولمَّا كانت القراءة لغةً هي الضمَّ والجمع وفك الرموز بخلق الوشائج فيما بينها حتَّى تُبين عن أسرارها؛ كان قدر الإبانة عن مقصود الكاتب بقدر اتساع الجمع بين رموزه ومعانيه؛ جمعًا يؤدِّيه لاستقرار المعاني في نفسه استقرارًا ينفذ منه إلى تصوراته وانفعالاته اللغوية والسلوكية والحسِّية، وإنما تحصل القدرة على الجمع بين المتشابهات على قدر تذوُّقها، ويكون تأثيرها على وسع فقهها؛ ولا يكون ذلك إلا بتكرار التعرُّض حتَّى تلين الأسباب وتتفتَّق الأفهام ويكون التذوّق مرتبة شمَّاء من مراتب الحسِّ والبصيرة والحذق = يدخل بها صاحبها إلى مسارب المعاني مما كان ظاهره الاستتار. يقول الدكتور الأستاذ محمد أبو موسى في كتابه خصائص التراكيب: “قدرتك على التذوُّق هي بداية الطريق في البلاغة، فإذا لم توجد هذه القدرة فليس هناك طريق ولا بلاغة” ويزيد: “حين ينظر ليتعرَّف على أسباب الحسن أو الاستهجان يكون قد بدأ العمل البلاغي، ويكون قد وضع قدمه على طريق علماء هذا العلم، وشغله حينئذ هو تفقُّد اللغة، والأحوال والصيغ والخصوصيات، والصور والرموز، وكل ما يتَّصل ببنية الشعر واللغة والأدب، ثم إنه لا يقع على هذا الذي وجب به الفضل إلا بمعونة الذوق، وهذا يعني أن هناك مرحلة سابقة للنظر البلاغيِّ يكون الدارس فيها قد هيأ نفسه وأشربها من بيان اللغة وجيِّد الكلام“.

ومثل هذا لا يختص بباب اللغة والأدب فحسب، بل يخلع معناه على ميادين المعارف والسلوكيات الإنسانية؛ فعلمك بالشيء يكون أبلغ متى أحسنت تقصِّي مظان حسنه، وهذا التقصي المستملح إنما يكون جبلَّة في أصل خلقة الإنسان الذي صوَّره خالقه في أحسن تقويم ابتداءً، وأودع فيه قصدَ الإحسان والاستحسان، وبثَّ فيه القدرة على نوال مراده، وهو على هذا قد أتاح له فسحة الاختيار فيما دون ذلك، فالمرء يسمو بحسن اختياره إن شاء حتَّى يبلغ عنان السماء، أو يهوي برداءة ذوقه سبعين خريفًا في مهاوي الفساد والازدراء، وقد عهدنا هذا المعنى الذائع في لغة العرب حين قالت: ”اختيار المرء وافد عقله“ ومثله: ”قيمة كل امرئٍ ما يحسنه“، فحسن الانتخاب في أصله منقبة تُبين عن قدر صاحبها وعقله ووجدانه؛ ولعل الجاحظ ممَّن أوثق عُرى الاتصال بمحاسن المعاني ومُلح المباني، فكان إمام عصره في هذا الباب حتى قال فيه ابن العميد: ”كُتب الجاحظ تُعلِّم العقل أولًا، والأدب ثانيًا“؛ وما أحوج الإنسان في رحلة عمره لمن تكون خلطته محراثًا لتهذيب حسّه، وجلاء فهمه، وحسن ذوقه، فبمثلهم يعلو ويأتلق في كلِّ حال.
التذوق تحت سماء المعجم اللغوي
أمَّا التذوُّق لغة: فمن ذاق الشيء، يذوقه ذوقًا، وذَوَاقًا، ومذاقًا: إذا اختبر طعمَه، والتمسَ معرفة مذاقه في الفم. و“التذوُّق” بناء على وزن “التفعُّل” من: ذاق يذوق ذوقًا؛ فهو يفيد معنى المبالغة من حيث أفاد تكرار الفعل المرة تلو المرة، “وبالنظر إلى أصل اللفظ فإن الذوق أصله: ما أُدرك بوجهٍ من وجوه الحسِّ كما علمت، ودَلالة الحسِّ هي الأصل، وهي الأقوى” كما يقول الدكتور كمال لاشين في كتابه تذوق الشعر. وقيل أن الذوق ليس حاسة مستقلة، فجعلوه من جملة حاسة اللمس، ثمَّ إنهم نقلوا الذوق والتذوق من باب المحسوسات إلى باب المعنويات على ما جرت عليه ألفاظ اللغة العربية نحو: ذاق السيف، وذاق الفرس: إذا اختبرهما، وقد ورد في شعر العرب مصداق ذلك؛ كشعر كعب بن سعد الغَنَوي لما أنشد: “وما ذاق طعم النوم غيرُ قليل“، كما وردت ألفاظ الذوق والتذوق في محكم كتابه ﷻ فجاءت في معنى العذاب: ﴿ليذوقوا العذاب﴾ [النساء: 56]، وجاءت في معنى الرحمة ﴿وليذيقكم من رحمته﴾ [الروم:46].
ولعلنا لو فصَّلنا القول في هذا الباب فأصل الذوق – ولا يخفى على شريف علمك – متعلِّقٌ بالطَّعوم، وعلى هذا فلا يبلغ سرَّ النكهة المنزوية إلا خبير، قد سبر مكنُون المكوِّنات بروحه، وجاوز حصر مجرَّد البلع إلى رحابة التلذًّذ بانسجام الأضداد وائتلاف المتباينات، ومثل هذه المنزلة إنما تكون مَلكة جبلِّية وفتح ربَّاني يناله وافر الحسِّ موفور المعاني في نفسهِ؛ فيستخرج ضياء المعنى العميق من أسداف ظاهرها، ويصطاد الفكرة الغرَّاء من خِباءها المبهم إلا عمَّن درك شعابها على قدر ارتياده لمظانها، وبذا يمايز بين جيِّدها ورديئها، وينتخب الدرَّ من بين الحلي انتخاب المدرك المتمرّس الحصيف لا الجاهل الغِر.

ثلاثية الإحسان والإنسان والتذوّق
أمَا وقد بيَّنا معنى التذوُّق فيلزم ذلك أن نعرّج على أصل المفهوم في التكوين الإنساني لينطلق الإنسانُ من جوهره لأفلاك المعنى في حياته ومعارف دنياه، فيسلك سبيلًا إلى أسرار المعاني بحسن تذوُّقه، وهل يكون ذلك إلا باستحسان الحسن طبيعةً؟ فالمرء بفطرته مجبولٌ على حب المحاسن والأطايب؛ تدفعه نفسه دفعًا للطيِّب من القول والعمل، ومن هذا حسن التعبُّد، وحسن التفاعل الإنساني، وحسن الخلق، وحسن العلم، وحسن البيان. ويكفي الإنسان أن يطالع تاريخه حتَّى يتفطَّن لمبتدأ المحاسن في لغته وإرثه المعرفي، فالعرب إنما تجلَّت لغتهم وآثارهم وآدابهم عن طريق الاستدلال أي “بدلالة الخبر الشاهد على الغائب من الأخبار، وهذا الاستدلال يقوم أوَّل ما يقوم على حسن التذوّق” كما يشير الأستاذ الدكتور كمال عبد الباقي لاشين، ويزيد في موضعٍ آخر مُبينًا عن حسن تذوق العرب في جاهليتهم وحين حسن إسلامهم نظير مخالطتهم لفحول الشعراء والخطباء، “ومن طريق ما كانوا يحسنونه من تذوُّق طبقات البيان عُرِض عليهم القرآن، ودُعُوا إلى الإيمان؛ لأن دعوتهم إلى الإسلام كانت تقتضي أن يوقنوا أن القرآن الذي يُتلى عليهم –وهو مُعجزة النبي إليهم– مباينٌ لجنس كلامهم، فائت له، وإن كان بلغتهم نزل.” وبتذوُّق بيان القرآن استيقنوا الإسلام على ما عهدوا من تذوُّق بيان فصحاء العرب وبلغائهم. أمَّا حسن التذوُّق بالمجمل فآية القلب السليم من أوضار الدنيا وآفات الزمان، وبرهان النفس العلية الشريفة، ودلالة على العقل القويم المستنير؛ فالإنسان النبيل إذن صنو الذوق الرفيع، يلازمه في كل حال، في سكناته وحركاته وفلتاته، تعرفهُ عبرها وتستدل بها عليه أينما حلَّت رحاله. يقول شيخ العربية محمود شاكر في فضل التذوق على حضارة الأمم: “كل حضارة بالغة تفقد دقة التذَّوُّق، تفقد معها أسباب بقائها، والتذّوُّق ليس قوامًا للآداب والفنون وحدها، بل هو أيضًا قوام لكل علم وصناعة، على اختلاف بابات ذلك كله وتباين أنواعه وضروبه“. فالتذّوُّق إذن ملازم لنهضة الأمم، وهي ضرورة مُلحة لرفعتها باستعذاب كل حسن، وتطلب كل مليح على وسع طاقة أربابها. يزيد الناقد الفذ والأديب الجهبذ فيقول: “فحسن التذوق يعني سلامة العقل، والنفس والقلب من الآفات، فهو لب الحضارة وقوامها، لأنه أيضا قوام الإنسان العاقل المدرك الذي تقوم به الحضارة” وهذا يتعاضد مع ما قدَّمنا في هذا المعنى، وهو مؤكَّد على جدوى تهذيب الأذواق في أبواب الدنيا إذ بها تدبُّ الحياة في جسد الأمة؛ “ولن تتمكن الأمة من إعادة بناء نفسها، وبعث حضارتها الوليدة، والبناء عليها، إلَّا بالعودة إلى حسن التذوُّق. فلن يحصل آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها“. فليس بوسع المرء منَّا أن يتذوّق معرفة وبيان على الوجه المحمود التام في معزلٍ عن علومها وفكرها وحضارتها وسياقها الاجتماعي والثقافي ونحو ذلك.
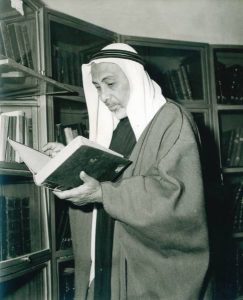
الجمال بوصفه فرع التذوق
ما ينفك التلازم المنطقي بين معنى التذوُّق ومعنى الجمال، فالعلاقة بينهما تبادلية، يتذوّق المرء الجمال ليشعر به ويستشعر ذاته وكينونته، ويتموضع الجمال حتَّى يلقى متذوقًا بصيرًا يستنطق مكامن حسنه. وللجمال موقع محجوز في فضاءات الفلسفة، فكانط ممَّن عَدَّ الجمال من أسباب المتعة وهو لا يتجزأ عنده من العملية المعرفية؛ حيث أن الخيال والفهم يتشاركان على حدٍّ سواء في إنتاج المعرفة. وفي حالة الجمال تصبح الكليات المعرفية للخيال والفهم في حالة من اللعب الحر، وفي نوعٍ من التفاعل المتناغم. وقد أوجز شيخ البلاغيين محمد أبو موسى لما قال مقولته الذائعة “أُعيذك بالله من أن تقرأ ما يُدهش ولا تندهش” فحركة الأفكار في النفس والعقل إنما هي جوهر المعرفة وينبوع الفائدة مذ كانت العناصر المرئية والمقروءة والمكتوبة فاعلة في بعضها البعض، تتناغم وتنسجم بحسب قدرة الناظر والوارد في خلق الصلات فيما بينها، وعلى وسع طاقته في ردِّ ما حقَّه الرد منها وتنظيم ما شذَّ منها، وتفريع ما لزم، وهذه سمات المتذوِّق حقًا. وللدكتور أبو موسى إشارة بديعة هَهُنا يقول فيها: “العقل الذي يستحسن الحسن، ليس أقل مقدارًا من العقل الذي صنع الحسن” وهذه مقاربة جليلة تفيد بعلو كعب الذائقة الحسنة التي حسن معها الاصطفاء كما حسن من الصانع صنعته فيما شاء. وقد ورد عن سهل بن هارون على لسان الجاحظ في البيان والتبيُّن قوله الخلَّاب: “العقلُ رائد الروح، والعلم رائد العقل، والبيان ترجمان العلم” وكلُّ عنصر كما تلحظ إنما هو عاملٌ فيما ينعقد به، وقد علَّق الدكتور كمال لاشين على هذا فقال: “البيان الإنساني حامل لكل ما يدل على الروح والعقل والعلم. ومعنى هذا أننا في تذوقنا للبيان في أي صورة كان، إنما نبحث في بيان الرجل عن مبلغ علمه، ونبحث في علمه عن مبلغ عقله، ونبحث في عقله عن روحه” وهل التذوّق بعد هذا إلا قراءة في صفحات الدنيا سعيًا للبحث عن روح الإنسان التي هي جِماع مناقصه وفضائله؟
أداة التحصيل المعرفي والذوقي
لا يخفى على سليمِ ذوقٍ فضل البيان على سائر المزايا اللغوية والفكرية، فالمعنى المعتاد الباهت يغدو نضرًا إن حسن بيانه وكمل بنيانه بجودة الديباجة، وكم من معارف خارج الأطر الأدبية استمالت العقول والألباب بما ازدانت به من صنعة بيانية. يقول الدكتور أبو موسى: “عظمة البيان العالي أن يجعل ما لا قيمة له لا قيمة فوقه“، وقد نقل محمد كرد علي عن بلونشلي الألماني ما تعريبه: “للآداب في أفكار الأفراد تأثير أعظم من تأثير العلم، إذ أن لجمال الشكل والصورة وقعًا كبيرًا في النفس أكثر من العلوم التي هي في الغالب قضايا غثّة باردة، وإن كتب شكسبير معروفة أكثر من كتب نيوتن” وهذا واقعٌ ومشاهد في مختلف الثقافات والسياقات المعرفية، وإنما يدل على الطبيعة الفطرية التي تهفو للجمال تذوقًا وحسًا. والمرء منَّا يقوِّمُ ذوقه بكثرة مخالطة البيان العالي وأهله، ويهذِّب عقله بقدر ملازمته للنبهاء النوابغ في فنونهم وعقولهم، وقياسًا فمنادمة الكتاب الذي يعلو بحسِّك لا يقل أهميَّة عن الكتاب الذي يسمو بعقلك، بل ولعله يزيد عنه بدرجة لأن الحس اليقظ دليل حياة، والمرء إنما يحتاج لحياة حسِّه خارج دفتيِّ الكتب لتستقيم دنياه وأهلها، فإن وافق حسن البيان دقَّة الفهم وجلاء العقل فقد حيَّزت النعم وظفر النديم.
تذوق النصوص موسوم بفن المتذوق ومجال اهتمامه
لعل ممَّا يُحمد في المختص انسدال ظلال صنعته ومناط مهارته على سائر علومه وسلوكياته، وهذا مشاهد في أحوال متباينة، لكنها في الشعر أظهر، فتجد علماء اللغة والرواة ينتخبون من الشعر ما يلازم صنعتهم وما هو ممتد من جذع علومهم، يقول الدكتور لاشين: “النحويون اختاروا من الشعر ما فيه صنعة إعراب، وأهل الغريب والمعاني اختاروا منه ما فيه صنعة غريبٍ محوجٍ إلى تفسير، أو معنى خفي محتاجٌ إلى استخراج، وأهل الأخبار والأنساب اختاروا ما فيه الخبر والنسب والمثل والشاهد” فلا ينفك متذوّق من مثل هذا بل وبه يحصل التفاضل، وكما قال ابن جني مرَّة في سياقٍ موافق: “من أتقن علمًا فقد أتقن علومًا” وعلى نسقه: فمن تذوَّق معنى فقد ذاق معانٍ؛ تنكشف له بالزمان، إذ من سمت الجمال ألا ينكشف دفعة واحدة، ولا يلقاك بحسنه من أول مقابلة، إنما يبوح لك بأسراره على قدر ورودك وتكرار مطالعتك، فإن انكشف منه نزر فقد أذن لما بعده بالظهور. يقول الدكتور محمد أبو موسى في هذا المعنى: “ومن عمد إلى جليل فنظر فيه نظرًا قريبًا سطحيًا فقد صغّر ما حقِّه أن لا يصغّر” وعليه فالمعاني الشريفة إنما بلغت شأوها هذا على ما يلقاه الطالب من جهدٍ حتى يبلغها، وينال منها ثمرة صبره و عاقبة جهده؛ فتلذُّ عنده، ويمتد أثرها في نفسه وعقله وبيانه وسلوكه.

في ميادين حسن الانتخاب وحسن الاستشهاد
تقول العرب ”اختيار المرء قطعة من عقله“ ويقول الجاحظ “… وبعد، فكم من بيت شعر سارَ، وأجود منه مقيم في بطون الدفاتر، لا تزيده الأيام إلا خمولًا، كما لا تزيد الذي دونه إلا شهرة ورفعة” والأمر أوسع من بيت شعر، ففي بطون الكتب من المعاني ما لم يحصه القرَّاء ويقيِّده النبهاء، وبالمقابل فلعل سطرًا من متن يكون قبلة ساعٍ نحو سفرٍ جليل، ولعل معنًى خالط عقل قارئ فطن دلَّ على منظومته الفكرية، وإنما الناس يتفاضلون بأذواقهم وحسن انتخاب معانيهم، واجتباء أوعية معارفهم، ومثل هذا يظهر بحسن إيراد الاستشهاد في جملة الكلام، فتعرف به القارئ النابه من المتلصِّص على المعارف تلصُّصًا يحمِّله أسفارًا تثقل كاهله فتتبدّى على ظاهر مبناه المتهالك وضامر عقله.
ما يحتاجه المتذوِّق
أما وقد اتضحت منزلة التذوُّق؛ فيحسن بالقارئ أن يستصحب معه في رحلته الجمالية فضل الاستعداد الفطري في التذوُّق؛ إذ أن الطبع أصل الاستحسان ومنطلقه، فإن لم توفَّق بذرة المعنى لأرضٍ خصبة تُحسن وفادتها وتعرف قدرها، فلن تثمر ثمرة يانعة تسرُّ الناظر وتبهج النائل؛ يقول ابن المقفع: ” … وأمارة صحة العقل اختيار الأمور بالبصر، وتنفيذ البصر بالعزم. والعقول سجيَّاتٌ وغرائز تقبَل الأدب“، وبوسع القارئ أن يتلمَّس آثار الطبع على لغة الكاتب بآثاره البينة الجليَّة. ولعل من المفيد في هذا الموضع أن يعي المرء حقيقة أنَّ الطبع وإن كان سجيّة فلا يعارض أهمية الدُّربة والعناية بتجويد الأصل ومرانه، بل هذا ممَّا يسمو بالذائقة ويُربيها، فإنَّك متى جمدتَ هزلتْ قواها فيك وانفصمتْ عُراها.
وكما أن الاستعداد الفطري لازم، فإدراك أن المرء إنما يتقلَّب بين إقبال وإدبار لا يقل أهمية، وكذا التذوُّق الذي هو استجابة نفسية مردُّها للنفس اللجوج التي لا تسلِّم عقالها طوعًا على الدوام، بل شأنها التقليب، وإنما يكون ارتياضها على قدر مرانها وتفهم تباين الأذواق وفق تباين السياقات الوجدانية والفكرية. يقول المرزوقي في شرح ديوان الحماسة: “… ومعلومٌ أن طبع كل امرئ – إذا ملك زمام الاختيار – يجذبه إلى ما يستلذه ويهواه، ويصرفه عما ينفر منه ولا يرضاه … بل نعتقد كثيرًا أن ما يستجيده زيدٌ، يجوز ألا يطابقه عليه عمرو … إذ كان ذلك موقوفًا على استحلاء المُستحلي، واجتواء المجتوِي.”
وممَّا لا يمكن إغفاله ، أن المتذوِّق الحق يعرف طبقة المتكلم ومنازل الكلام، فيفرِّق ما بين الطبقات والمنازل على قدرها، ويحسن الفصل بين الأنماط على منازل أهلها، فإن لم يقدر على ذلك ففي تذوقه نظر. وللباقلاني إشارة في هذا المعنى ذكرها في إعجاز القران؛ فيقول مبيِّنًا: “وبحسن التذوق يَعرف المتذوِّق درجة القائل من البيان، وطبقته بين المبينين من ذوق كلامه“.
ولعل الإنصاف – بعد كل هذا – يعدُّ من أجلِّ مقاصد التذوُّق، فلعلك تقرأ النص فتحسُّ منه بنغمةٍ تطربك لا تعرفُ لها تفسيرًا غير أنها وافقت ذوقك الجمالي، وقد يكون مناط التأثير لا يخرج عن إلفٍ واعتياد وهذا وجه من أوجه آفة العصبية التي قال عنها الجرجاني: “وما ملكت العصبية قلبًا، فتركت فيه للتثبُّت موضعًا، أو أبقت فيه للإنصاف نصيبًا“، وما زُين عقل وقلب وبيان بزينة أعزُّ وأبهى من زينة الإنصاف والتثبُّت قبل تصدير الأحكام وترسيخ التصورات.
فصاحة البيان وعُجمة السلوك
وما دمنا في ذكر حلية الإنصاف، فكماله إنما يكون في موافقة القول للعمل، والنفس للَّفظ، فبهذا يتمايز الكلام وأهله، وبهذا يُفصل بين القارئ الألمعي وحامل لواء الاستعراض البارد الذي لا يفضي لبث الروح في المعاني والإنسان. يقول إبراهيم بن أدهم: “أعربنا في كلامنا فما نلحن حرفًا، ولحنّا في أعمالنا فما نُعرب حرفًا” ونعوذ بالله من أن نكون ممَّن يحسن التذوُّق ولا يحسن الإبانة عن تلك الهزَّة الطروب في سائر انفعالاته اللغوية، والسلوكية، وما يكون فوق اللغة الملفوظة والمحكية. زيَّنا الله وإياكم بحياة الحسِّ والوجدان، ورفعة العقل وحسن البيان.
لكن لفت انتباهي من بينها عادة بعينها، وهي أنهم "يقرأون... لكن ليس من أجل




